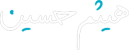هيثم حسين : خبرة الكاتب لا يمكن أن تظلّ حكراً عليه
حوار: منصورة عزالدين
فى ثلاثينيات القرن العشرين عاشت الكاتبة البريطانية أجاثا كريستى فى منطقة عامودا بشمال سوريا، بصحبة زوجها عالم الآثار ماكس مالوان، وكتبت خلال هذه الفترة كتاب يوميات بعنوان «تعال قل لى كيف تعيش»، وقبل سنوات اضطر الكاتب والناقد السورى الكردى هيثم حسين إلى اللجوء إلى بريطانيا، حيث يقيم حاليًا، وعن هذه التجربة كتب سيرة روائية يتناص فيها مع أجاثا كريستى بداية من العنوان: «قد لا يبقى أحد، أجاثا كريستى، تعالى أقول لك كيف أعيش».
وفى هذا الحوار، سنحاول معرفة: كيف عاش هيثم حسين تجربة اللجوء؟ وكيف حولها إلى كلمات فى كتابه هذا؟ لا أقصد هنا، ما يمكننا معرفته أو استنتاجه من قراءة العمل، إنما ما وراء الكواليس، وما اعتمل فى ذهنه أثناء الكتابة، وأيضًا محاولة استيضاح لماذا فضّل هذه الطريقة فى الكتابة على ما عداها.
أول ما يلفت النظر فى سيرة هيثم حسين الروائية، التى صدرت ترجمتها الإنجليزية مؤخرًا، هو الانشغال بالسؤال الأخلاقى حول هل يجوز للكاتب تعرية حيوات من تقاطعت سيرتُه مع سيرتِهم عندما يكتب تجربته الذاتية؟ الأمر الثانى يتمثل فى محاولته نزع القداسة الوهمية عن شخص اللاجئ، إذ أنه لا يظهره فى كتابه فى صورة إيجابية فقط، بل يستعرض وجوهه المختلفة، ويوضح كيف يمكن لتجربة اللجوء أن تكشف عن أفضل ما فى الإنسان وأن تبرز أسوأ ما فيه بالمثل! كيف يمكن أن تكون الضحية ظالمة لضحايا آخرين، وكيف قد يكره الغريبُ الغريبَ واللاجئُ اللاجئَ.
هناك سؤال يتبادر إلى الذهن بمجرد قراءة عنوان الكتاب، لماذا اختيار أجاثا كريستى تحديدًا وهى بعيدة ربما عن ذائقتك الأدبية، أيعود هذا إلى مجرد إقامتها فى مدينتك الأم عامودا؟ ولماذا تظهر أجاثا أحيانًا وتختفى من الكتاب فى أحيان أخرى لتعاود الظهور من جديد؟
لم يكن مجرّد إقامتها فى مدينتى فى ثلاثينيات القرن العشرين، وكتابتها فصولاً من يومياتها هناك، وحده دافعاً لاختيارى إياها كى تكون متصدّرة العنوان الفرعىّ للكتاب، ولم يكن ذلك من باب الإقحام، بل سعيت إلى التوجّه من خلالها للقرّاء؛ الإنجليز وغيرهم، باعتبارها رمزاً من رموز التاريخ الأدبى العالمى، وتقاطعت الظروف أن عشت ومررت وأقمت فى تواريخ منفصلة فى أمكنة مرّت وأقامت هى نفسها بها، منها مثلاً (بيروت – القاهرة – إسطنبول، بالإضافة إلى مناطقنا فى شمال سوريا ومدينة لندن).
حاولت استدراج القارئ عبر التوجّه لأجاثا كريستى، وتحريضه على البحث عن أسباب ودوافع توجّهى لها، وإخبارى إياها أن تأتى وترى كيف أعيش، حاولت لإثارة الفضول والأسئلة لدى القرّاء للبحث عن مرامىّ فى مناجاتها، وأحييت الذاكرة والذكريات من خلالها، ولاسيما أنّ هناك عدداً من القرّاء – حتى هنا فى بريطانيا – لم يكونوا يعرفون عن يومياتها الكثير، ولم يكونوا يعرفون أنّها عاشت وكتبت يومياتها حين كانت مع زوجها عالم الآثار الراحل ماكس مالوان فى سوريا والعراق، فكان ذلك فرصة للتحريض على إعادة اكتشاف يومياتها، ووضعها عتبة وبوّابة لإيصال حكاياتى وأفكارى وتصوّراتى عن عالمينا المشتركين، وعن اختلاف الأمكنة والأزمنة والبشر بعد عقود من الزمن.
لكن لماذا لم تكن معارضة أجاثا كريستى الإطار الحاكم للكتاب ككل والممتد لكل فصوله؟
لم أحاول أن أجعل الكتاب متمحوراً حول أجاثا كريستى، بل كنت أتعامل مع استحضارها بحرص ومن دون إكثار أو مبالغة، أردت أن أبقى مسافة معها، وأتوجّه له بالرسالة أو المناجاة حين اللزوم، وأمضى فى فصول أخرى بعيداً عنها إلى تفاصيل من حياتى وحكاياتى التى تظهر كيف عشت وأعيش أثناءها. ولم يكن الظهور والاختفاء من منطلق التصدير أو الحجب، بل مضيت وراء الحاجة الفنية والبناء الهندسى الذى وجدته مناسباً لخدمة الكتاب، فاستدرجتها حين الحاجة وسرت بعيداً عنها حين كنت أحتاج للتركيز على تفاصيل وقصص أخرى تكمل رسم المشاهد الحياتية والعوالم التى كنت أريد إيصالها.
بالمناسبة، أحببت تعاملك الساخر مع تنميطات كريستى حول الأكراد والعرب، وأرى أن هذا هو السبيل الأمثل لتفكيك الصور النمطية وإظهار ما تتسم به من سخف وتبسيط مخل، لكن الأهم من وجهة نظرى أنك لم ترفض الأمر كليًا، وإنما نقلته من خانة التعميم إلى التخصيص. حين رفضت رأيها بخصوص سهولة القتل عند الكردى بشكل عام، ثم يفاجأ القارئ بعدها مباشرةً بأنك تبوح له باللحظة التى كدت تتحول فيها إلى قاتل؛ ذهنيًا على الأقل بتفكيرك للحظة فى التخلص من الشبيح الذى كان يعكر عليك صفو حياتك. هل يمكننا قول إن حتى تعميمات أجاثا كريستى كانت مرآة عكست لك بعضًا من الجوانب المعتمة فى ذاتك؟
أحياناً السخرية خير وسيلة لنسف أفكار مغلوطة وأحكام مسبقة بعيدة عن المنطق، بحيث لا يكون التعامل معها بمنطق وموضوعية مفيداً لأنّها ضدّ العقل والمنطق، لذلك فتجريدها من جدّيتها يكون عبر إسباغ السخرية عليها، ووضعها فى إطار الهزء والتنكيت.
وفى فصل بعنوان «القاتل أنا؟!» توجّهت بالمعارضة والمواجهة لأجاثا، وكتبت لها أذكر أنّك بينما كنت تحكين بعض حكايات العمّال الذين كانوا يعملون مع زوجك، أشرت إلى خروج امرأة كرديّة من كوخها الطينىّ معنّفة زوجها على طريقة إفلاته حماراً من رسنه. وتصفين كيف تنهّد الكرديّ بحزن. وتتساءلين: «من يودّ أن يكون زوجاً كرديّاً؟». وأردفت بالقول: «هنالك مقولة شائعة مفادها إنّ العربىّ، إن سلبك فى الصحراء، يكتفى بضربك ويدعك على قيد الحياة، أمّا الكرديّ فيسلبك ثمّ يقتلك لمجرّد المتعة».
ووجدت أنّ من الضروريّ التوقّف عند هذا الحكم البائس الذى يجرّم شعباً برمّته انطلاقاً من اتّهام عنصرىّ، وتساءلت من أين استقت هذا التخمين بأنّ الكرديّ قد يقتل لمجرّد المتعة، لأنّ هذا تعميم للتجريم والتأثيم، وأعتقد أنّه لا يتوافق مع منطق كاتبة روايات الجريمة، وواقع أنّ الإجرام لا يرتبط بعرق أو هويّة، بل هو حالة إنسانيّة موجودة فى كلّ الأزمنة والأمكنة، ولدى كلّ الشعوب والأعراق بهذه النسبة أو تلك.
وهنا فى هذا الفصل تحديداً أثرت الكثير من الأفكار والأسئلة عن فكرة القتل وماهيته، وكيف يمكن أن يتحوّل الإنسان البسيط العاديّ الذى يبدو طبيعيّاً لمَن حوله إلى قاتل؟ وهل يتمّ صنع القتلة أم أنّهم متفشّون حولنا ويربضون بين ظهرانينا من دون أن نعلم بهم؟ ألا يحمل كلّ إنسان ندّاً قاتلاً فى داخله، قد يرتكب جريمة قتل لو وضع فى ظروف معيّنة، أو دفع إلى ذلك بطريقة ما؟
لا أعتقد أنّ تعميماتها كشفت خبايا نفسى، بل أردت أن أحيل الأمر إلى جانب مختلف، ذلك أنّ كلّ إنسان مرشّح أن يصبح قاتلاً من حيث لا يدرى ومن حيث لا يخطّط، وأنّ الحياة قد تكون قاسية لدرجة تجرّدك من إنسانيتك وتدفعك للانسلاخ عن ذاتك ولا يمكن الحكم على الناس وتجريمهم على الظنّ أو حصرهم فى زاوية القتل لمجرّد تكرار مقولة تبعث على السخرية من قوم بأكملهم وتشويه صورتهم بطريقة منفّرة.
لكلّ إنسان جوانب معتمة فى داخله، أحياناً كثيرة هو نفسه لا يعرف عنها، ولا يكون قد اكتشفها، وهى تبقى قارّة فى أقصى الأعماق، ولكنّها قد تتفجّر فى مواقف بعينها، وقد تودى بصاحبها أيضاً، وكم من حالات غضب كلّفت أناساً كانوا يبدون لغيرهم أمثلة فى التعقّل حيواتهم، وقضت عليهم، وكم من مواقف جنونية تسبّبت بإراقة دماء أو تضييع أموال وثروات..!
الإنسان مزيج معقّد جدّاً من النقائض والأفكار والأحلام والكوابيس، ولا يمكن تفكيك هذا التعقيد ببساطة، كما لا يمكن نزع الدوافع أو فصلها عن بعضها، لأنّ تلاقى بعض النقائض قد ينزع مسمار الأمان النفسيّ عن بعضنا بشكل عشوائى وخطير.
لاحظت حرصك على التمسك بنبرة تأملية متفلسفة فى النظر لتجربتك مع اللجوء، وقد ساعد هذا فى الخروج بها من الخاص للعام، لكن شعورى الشخصى أن هذا الخيار كان فى بعض الأجزاء بمثابة ميكانيزم دفاع للحد من الانسياق فى البوح. هل كان من الصعب عليك مشاركة الآخرين هذه الخبرة الذاتية بلا تحفظات؟ وإن كان الأمر كذلك، لماذا اخترت أن تكتب سيرة ذاتية تحديدًا؟ ألم يكن من الأسهل عليك تسجيل هذه التجربة روائيًا؟
ليس من السهولة أن يواجه المرء مخاوفه، وأن يعبّر عن هواجسه وأحاسيسه وما يعترك فى وجدانه من أفكار وتناقضات بصدق وصراحة، ولاسيّما أنّه يشرع أبواب حياته أمام الآخرين، ليكون موضوع بحث ودراسة وتأويل، لكن من الأهمية بمكان إخراج التجربة الإنسانية من سياقها الذاتىّ إلى فضاء مفتوح، ومشاركة الآخرين بها، لأنّها يمكن أن تساهم، ولو بجزء ضئيل، فى لفت الانتباه إلى القضايا التى يتناولها، ويريد تسليط الأضواء عليها. وهنا لا يمكننى القول إنّ الكتابة بلا تحفّظات كانت غايتى، إنّما كنت منشغلاً بالتعبير عما أشعر به بصدق، وإشراك القرّاء ما عشته ومررت به وشهدت عليه، وكنت أسعى لأن أكون حرّاً مسئولاً فى كتابتى.
لم أنطلق من جانب فضائحى، أو رغبة بالتعرية، بل كنت على أعتاب مواجهة تحدّيات عديدة، منها مشقّة مواجهة الذات واسترجاع لحظات أو مواقف مريرة سابقة وإعادة عيشها عبر الكتابة، وربّما حمل ذلك نوعاً من القسوة على النفس بإرجاعها إلى ما حاصرها أو أحرجها فى أوقات سابقة، والوقوف على تفاصيلها الدقيقة، بحيث يكون الإحساس بها قاهراً وقاسياً، ولم يكن وضعها فى إطار للتجربة الكتابية استلذاذاً بالألم أو الأسى، بل كان محاولة للتغلّب عليها، ووضعها فى سياقها والحدّ من تفاقمها وتراكمها فى النفس وتحوّلها إلى كوابيس ملازمة لي.
خبرة الكاتب لا يمكن أن تظلّ حكراً عليه، بل هو ملزم بحكم الدور الذى اختاره أن ينقل خبرته إلى قرّائه، ويبرز أن تجربته الإنسانية تتقاطع مع تجارب الكثيرين، وأنّ المصائر مشتركة بين البشر، ولا حرج فى تقديم حكاياتنا من دون أيّ ترقيع أو تعتيم أو تعمية.
اخترت كتابة السيرة لأنّها مباشرة، واضحة، لا تلجأ إلى أية تورية أو مواربة، وأردتها أن تنقل بعض الحكايات والمحطّات من رحلتى الحياتية إلى الآخرين من دون تحميلها لأيّة شخصية روائية. الكتابة السيرية كاشفة، وحميمة ودافئة، وجدتها تعبّر عنّى وتوصلنى إلى القرّاء بشكل أسرع، وتقرّبنى منهم بشكل أكبر، أكون متقاطعاً معهم، وكأنّى أستعير لسانهم وأنا أحكى أجزاء من معاناتى، ومن أفكارى، وأحلامى، وغير ذلك من التفاصيل الإنسانية المشتركة.
فى الحقيقة كان من الأسهل تدوين التجربة روائياً، لكنّنى لم أخض الطريق السهل، ولم أرد لتجربتى أن تتخفّى خلف أقنعة الرواية والشخصيات الروائية، على الرغم من أنّ هناك أجزاء وتفاصيل منها تتسرّب إلى رواياتى، بصيغة أو أخرى، ككلّ الروائيين الذين تتوزّع بعض التفاصيل من حياتهم أو بعض حكاياتهم وأفكارهم فى رواياتهم، وعلى شخصياتهم، تكون خميرة حياتية وروائية لهم. اخترت خوض مغامرة المكاشفة، وكنت أعى خطورة المسألة، ولاسيما أننى سبق أن كتبت عدة روايات وبعض الدراسات والكتب النقدية، وكنت أدرك خطورة التأويل والتحليل، لكنّ ذلك لم يشكّل عائقاً أمام رغبتى بنقل تجربتى فى الغربة واللجوء للآخرين. ولا أزعم أنّ الأمر كان سهلاً أو بسيطاً، لأنّنى كنت أدرك مشقّة التعبير المباشر من غير التمرير بفلترة روائية، أو من غير تحوير أدبيّ، بحيث تضع بيد الآخرين مفاتيح شخصيتك ونفسيتك. لا يخلو أيّ اعتراف من تردّد أو تحفّظ، لكن كان السؤال كيف أوظّف ما يمكن أن تكون عراقيل فى درب الكتابة السيرية كروافع لها، عبر الصدق والصراحة.. ويبقى الحكم للقرّاء فى التقييم.
تكتب بضمير المخاطب عن اللحظات المحرجة فى تجربة اللجوء ألهذا علاقة أيضًا بصعوبة الكتابة الذاتية عن هذه التجربة؟
الأنا هنا تخرج من إطارها الضيّق والمحدود، تتقمّص الآخر فى مختلف أطوارها وتحاكيه فى مساراتها، الأنا تصبح عتبة للتماهى مع الآخر، تخبره أنّه ليس بمنجى عن خوض تجربة مماثلة، وأنّه ليس محصّناً ضدّ أيّة تجربة يمكن أن تكون مذلّة أو صادمة أو قاهرة، وأنّ الأنا هى أنوات متعدّدة فى الواقع، لأنّ ما مررتُ به مرّ به كثيرون غيرى، لم تتح لهم الفرصة للتعبير عنها، فكان الشعور بأنّ استدراج الضمير المخاطب إشراك للقارئ فى التجربة، أو إحالتها إليه، وكذلك كما تفضّلتِ، ربّما نوع من التخفّف غير المباشر من القهر الذاتىّ الذى تستعيده ذكريات التجربة بقسوتها وعذاباتها.
الحرج يلازم اللاجئين فى حلّهم وترحالهم، يشعر كثيرون منهم فى أنفسهم بأنّهم ملطخون بلطخة تسم كيانهم وتصم أرواحهم، يعيشون غريبين عن أنفسهم، محاولين تلبّس شخصية أخرى، أو ارتداء أقنعة كثيرة فى الخارج، ثمّ إلقاءها حين يكونون وحدهم، ما يبقى حواجز كثيرة متشاهقة بينهم وبين واقعهم الجديد، وملجئهم الذى يفترض أنّه ملاذهم من الموت والرعب والقهر والسجن، هنا تتحوّل المفاهيم وترتدى الكوابيس حللاً أخرى غريبة وجديدة كذلك. ومن هناك كانت الكتابة عبر تحميل الآخر أجزاء من الحكاية إشعاراً بوحدة الحال، وتأكيداً على أنّ كلّ واحد منّا يتجرّع نصيبه من الأسى والوحشة والنفى على طريقته، وليس هناك من لا يكتوى بنيران الغربة واللجوء، وإن قيّض لى أن أعبّر، أو أمتلك القدرة على البوح والاعتراف، فلا يعنى أنّ الأنا انفصلت عن الآخر، بل هى جزء منه، ومتّحدة معه فى الهمّ والمصير.
فى كتابها «بعد جنازة» عن وجيه غالى كتبت ديانا أتهيل، أن من أوجه المعاناة فى المنفى، أن عليك أن تكون ممتنًا على الدوام. وفى كتابك تكتب عن توقع الآخرين منك فى بلد اللجوء أن تكون سعيدًا بالضرورة لانتقالك من مكان يعتبرونه جحيمًا إلى الجنة. هل مصير اللاجئ أن يعيش محاصرًا بسوء الفهم وبتوقعات الآخرين منه وصورهم النمطية عنه؟ وكيف يمكنه الخروج من هذه الدائرة العبثية؟
اللاجئ بالفعل محاصر بسوء الفهم، أو إساءة الفهم، فى الواقع أغلب الأحيان، ويكون مطالباً على الدوام بتأكيد استحقاقه بالتواجد فى ملجئه، وهذا لا يمكن أن يبلور أية صيغة طبيعية للتعايش المفترض، بحيث يكون هناك غيتوهات غير معلنة للاجئين ضمن المدن، تكون مرتعاً للفقر وما يخلّفه من مشاكل اجتماعية، أى يكون عليه دفع نوع من الضريبة المعنوية بحيث يمثّل السعادة، أو يبقى فى زاوية الامتنان التى لا يمكن أن يواصل عيشه من دونها.
هناك من أبناء البلد ممّن يحمّلون اللاجئين أعباء المشقّات التى يتعرّضون لها فى حياتهم، يجدونهم مزاحمين لهم على فرص العمل، وفرص التطوير، ويكون حصره وتقييده فى خانتَىْ الشكّ ووجوب الامتنان، وافتراض السعادة باعتباره ناجياً من جحيم الحرب، أو من مآسى بلاده التى لا تزايله.
يحرّر اللجوء اللاجئ، نسبياً، من مخاوف معينة تلازمه فى بلده، وبخاصة فى أجواء الحرب حيث الموت المجانى معمّم بطريقة عشوائية، لكنّه يضعه من جهة أخرى فى مواجهة مخاوف جديدة بحكم الواقع، فيقع تحت أسرها، وكأنّه يغدو رهين المخاوف مجتمعة، يعيش حرّيته التى لم يتح له عيشها والتمتّع بها فى بلده، وهنا يكون فعل تحرّر، كما يقع فريسة هواجس ووساوس جديدة، وهنا يكون بؤرة تشتّت لم تكن لتخطر له على بال فى أوقات سابقة.
كيف يمكن للاجئ أن يكون على قدر التوقعات التى يفترض أنّه يجب أن يقيّد بها، بحيث يكون استلاب الكينونة معادلاً للجدارة بالعيش فى المجتمع الجديد، وهو فى الواقع منسلخ عن عالمه وملقى فى عالم جديد مختلف، ويطالب بالتعامل وفق منظومته القيمية، ولا يكون الاندماج المزعوم سوى حيلة غير مجدية واقعياً، والأمثلة كثيرة.
الصور النمطية والأحكام المسبقة تكون مقاتل للعقل والفكر والمنطق، تسجن الآخرين فى قفص الاتّهام، ولا تفكّ قيود التأثيم عنهم بسهولة، ولعلّ الأخطر أن يكون الاستحسان فرديّاً والعقاب غير المعلن جماعياً. مثلاً حين يحقّق أحد اللاجئين إنجازاً علمياً أو أدبياً أو حياتياً ما، يعزى السبب إلى الترقية والتأهيل اللذين حصل عليهما فى ملجئه، يكون تنسيب الفضل بطريقة ما للنظام الجديد الذى أخرجه من القاع ومنحه الفرص لتأكيد ذاته والتفوّق فى ميدانه، أما حين يجرم أحدهم فإنّه يستجرّ الغضب على الشريحة الاجتماعية التى ينتمى إليها، وعلى الخلفية التى ينحدر منها بصيغة من الصيغ. ولا يمكن أبداً الخروج من دائرة العبث والضياع من غير تبديد الأوهام من قبل مختلف الأطراف، وتفهّم الأسباب والوقائع بعيداً عن أيّ تقديس أو تدنيس. وهذا بدوره يحتاج إلى عمل مؤسساتى متكامل، ويمكن أن يستغرق وقتاً ليس بالقصير. التعرّف على الآخر، والعلم به، من ممهّدات كسر العزلة وإذابة الجليد بين القواقع البشرية التى تتشكّل فى الملاجئ والمهاجر، بحيث يسعى كثيرون لعيش ماضيهم فى حاضرهم ومستقبلهم وحياة أبنائهم الذين لا يتكيّفون مع ذلك فيزداد اغترابهم عن محيطهم، فيتوارثون الغربة ومزاج المنفيين واللاجئين عن ذويهم بجانب ما.
ألا يتناقض هذا مع إشارتك إلى اللجوء كفعل تحرير، حيث ترى أن اللجوء حررك من كثير من الأوهام التى كانت تستوطن خيالك وتفكيرك؟ أفهم تمامًا ما تعنيه، لكن ألّا يشكِّل تصنيف اللاجئ نوعًا من التكبيل بالمثل؟
اللجوء ليس تعريفاً مقيّداً ومحصوراً بمفهوم وحيد، بل هو منفتح على تأويلات فكرية وحياتية وواقعية كثيرة، فتراه فعل تحرّر من جهة، أو فى بعض المواقف، كما تراه عتبة للتكبيل بأطر محددة موضوعة ثابتة راسخة وكأنها قوانين طبيعية لا يمكن تخطيها، مع أنّنى أؤمن أنّ الإنسان فى حياته يمكن أن يعيش تجارب غريبة عجيبة، ويمكن أن تكون ردود أفعاله واستجاباته مختلفة ومتباينة، حتى لو وضع فى الموقف نفسه، أو تعرّض للموقف نفسه عدّة مرّات، وهذا ما يجعل العلوم الإنسانية غير قابلة للقياس، ومفتوحة دوماً على المستجدّات التى تروم فهم النفس البشرية المعقّدة التى تبقى قارّة مجهولة تفاجئنا بالاكتشافات كلّ مرّة.
الحياة تفاجئنا كلّ مرّة بمستجدات عن أنفسنا وفى داخلنا لم نكن لنعرف عنها شيئاً، والإنسان كائن ملغز يضجّ بالغرائب.
على الصعيد الشخصى تحرّرت من أية عقد دونية أو تفوّق، أحاول العيش فى المجتمع الجديد بأريحية، أنتحى لنفسى زاويتى الحياتية، أحترم خصوصيات الآخرين ولا أبادر بإطلاق الأحكام عليهم، ولا أسعى لتغييرهم، أتقبّلهم كما هم، بعيداً عن أية وصاية أو بطريركية، ومادام أنّ المرء ملزما بدائرته وتفاصيله وعالمه فإنّه يحدّ من الاحتكاكات غير المرغوبة، والتى يمكن أن تعود عليه بالسلب، أو تضعه فى خانة الاتهام من حيث لا يريد ولا يدرى.
يبدو أن البشر يحتاجون للتصنيف فى واقعهم، كى يسهل عليهم التعاطى مع غيرهم، بحيث تكون هناك سمات عامة للأصناف المحددة، وتكون هناك صور وشخصيات مفتاحية للتواصل معها، ما يسهل عزلها أو دمجها والتفاهم معها، وهذا قد يصحّ جزئياً، لأنّ كلّ بيئة تضفى على أبنائها سمات بعينها، مع اختلافات وفروقات فردية، لكن تكون هناك سمات غالبة، أو سلّم قيم يمكن من خلاله توسيع الرقعة المشتركة وتعزيز التواصل والتفاهم. التصنيف نفسه يمكن أن يحمل بعض التفاصيل الإيجابية أحياناً، كما يمكن أن يشتمل على كثير من الأحكام المكبّلة، ولا يمكن كذلك تغيير آليات التفكير والتصنيف ببساطة، يبدو أنّ الزمن بتراكماته يشكّل مفتاحاً للتغيير المأمول.
أظن أن تجربة اللجوء كفعل تحرير وثورة تنطبق أكثر على النساء من خلال الظاهرة التى أشرت إليها فى كتابك والمتمثلة فى نيل عدد كبير من النساء لحقوقهن بانتقالهن إلى دول غربية؟
نساء كثيرات عشن فى ظلّ ظروف عصيبة وقاسية جدّاً، بالإضافة إلى القمع العام من قبل السلطة، كان هناك قمع اجتماعيّ مضاف للنساء، حيث البيئة تلعب دوراً فى اضطهادهنّ بطريقة تبدو معها وكأنّها نمط طبيعىّ من أنماط الحياة فى بلداننا، وكان يطلب منهنّ التكيّف مع القمع والاضطهاد، والانصياع لما يمارس بحقّهنّ من تعسّف وغبن، وتقبّله من غير محاولات تمرّد أو ثورة أو مجابهة، وكان نصيب من يقرّرن التمرّد والثورة من القسوة بمكان أنّ يصبحن عبرة لأخريات كى لا يفكّرن بسلك أيّ سبيل لكسر هيمنة الفحول عليهنّ.
كان هناك كثير من الزيجات التى تمّت بحكم الإكراه، أو بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولم يكن لكثير من النساء الحقّ فى اختيار شريك حياتهنّ، ولا بالاعتراض على من يتمّ اختياره لهنّ، ما زرع بذور التفتّت الأسرىّ والاجتماعىّ، حتّى قبل تشكّل الأسرة، وحين وصل بعض من هؤلاء النساء إلى أوروبا، حيث الاستقلالية الاقتصادية، وحيث القوانين تحمى المرأة من أيّ شكل من أشكال العنف، وتوفّر لها الحماية والرعاية، تبدّلت الظروف، ولم تعد الحاجة الاقتصادية أو الاجتماعية مفروضة عليها، كما أنّ كثيراً من الرجال ممّن كانوا أقوياء فى واقعهم السابق، بحكم طبيعة البلاد وثقافتها، حاولوا مواصلة أسلوب الهيمنة والتحكم القديم نفسه، من دون أن يدركوا أو يتفهّموا أنّ العالم تغيّر بالنسبة لنسائهم ولهم، ولم يعد التعاطى بذاك الأسلوب مجدياً، بل إنّه تحوّل إلى عامل تدمير إضافىّ للزواج.
للأسف أنّه فى العديد من الحالات كان نيل المرأة لحقوقها المسلوبة ضرباً من تشتيت لمّ أسرهنّ، ويكون الضحية فى هذه الحالة الأطفال، لكن من جهة أخرى يكون السؤال عن جدوى تربية الأطفال فى بيئة لا تتوافر فيها شروط الحرية الشخصية والحقوق الإنسانية الأساسية، وما إن كان ذلك لصالحهم أم أنّه يشوّه دواخلهم بطريقة فجّة ويخرّب علاقتهم مع عالمهم ومحيطهم. لكلّ فعل تمرّديّ أو ثوريّ ضريبته، وليس بمقدور الجميع التكفّل بدفع تلك الضريبة التى قد تكلفهم الكثير أحياناً على الصعيد المعنوى قبل المادّىّ، ومن هنا لا يمكن فرض خيارات بعينها على زى شخص، سواء كان رجلاً أم امرأة، لذا يما يزال قسم من الزيجات التى بنيت على أخطاء متراكمة مستمرّة، ويتحمّل كثير من النساء قسطاً من مشقّات الاستمرار من أجل حماية أسرهنّ وأطفالهنّ من التفتّت أو التشتّت، وهذا قرار خطير بدوره، لكن تعلّمنا التجارب احترام خيارات الآخرين وقراراتهم التى يجدونها أكثر ملاءمة لحياتهم.
ما تقييمك لمشهد الأدب السورى حاليًا؟ وأى تغييرات أحدثتها السنوات العشر الأخيرة فى هذا المشهد من وجهة نظرك؟ هل بإمكاننا الآن الحديث عن أدب منفى أو أدب شتات سورى أم أن الأمر لا يزال فى مرحلة البدايات؟
من الصعب على أىّ كاتب أو ناقد تقييم الأدب السوريّ فى العقد الأخير، بعد انطلاق اندلاع شرارة الاحتجاجات فى سوريا، لأنّه من الشساعة بمكان يصعب معه الإلمام به، أو رصد مختلف النتاجات التى صدرت فى هذه الفترة – المحنة، لكن ما أنا موقن به، هو أنّ هناك تفجّراً فى الإبداع الأدبيّ السورىّ بمختلف أجناسه، وهذا الكمّ لا بدّ أن يخلّف نوعاً لافتاً من شأنه أن يثرى المكتبة الأدبية العربية والعالمية.
لم ينل الأدب السورى الحديث بعد حظّه من البحث والدراسة والنقد والاحتفاء والتقدير، وكان الاحتفاء الصحافيّ فى أغلب الأحيان يغطّى بعض الفراغ، لكنه لا يكفى لتمثيل المشهد الرحب بالإصدارات المميزة، ولا لتغطيتها بالمتابعة والمراجعة والتحليل.
لا شكّ أنّ مَن غادر سوريا من الأدباء يكتب بحرّية أكبر، وهذا مفهوم بحكم الواقع، ومعروف لمن عاش فى ظلال حكم استبداديّ، حيث يسود اللجوء إلى الترميز والتلغيز، خوفاً من المساءلة والمعاقبة، حيث كلّ قول قابل للتأويل بشكل يمكن أن يودى بقائله، ويكون الإبداع الجريء المواجه المعرّى الفضّاح مكبّلاً بالخوف الذى يشلّ الطاقات الإبداعية ويقصيها إلى ركن الانزواء لتبقى مسكونة بالترويع المناقض للتحليق الحرّ الذى يستوجبه الإبداع.
أعتقد أنّه بعد عقد من تراكم النتاجات الأدبية السورية فى الخارج، بات بإمكاننا الحديث عن أدب شتات سوريّ، أدب متحرّر من أغلال الرعب والخوف، لكنّه يستعيد مناخاتهما فى مختلف تفاصيله، ويحاول تفكيك المنظومة المتراكمة منذ عقود، والتى قادت البلاد إلى هذا التفتّت والخراب الذى نشهده.
المنفى متواصل يغيّر أرديته فقط، فحين كنّا فى الداخل كان هناك منفى قاسٍ يغلّف كياننا ويحاول تجريدنا من كينونتنا نفسها، عبر تغريبنا عن واقعنا، والآن وبينما نحن فى المنافى، نعاود استرجاع ذاك المنفى لنحيا منافينا المركّبة ونسعى لتفكيكها وفهم أنفسنا فى محطّاتها المختلفة بين الأمس واليوم.
من أعذب أجزاء الكتاب بالنسبة لى ذلك الجزء الذى تتحدث فيه عن أسلافك؛ الجد والجدة وعلاقة الحب العاصفة والمتمردة التى جمعتهما، وبالأساس كون الجد من النازحين، وكيف صمم على البقاء فى عامودا كى يظل يرى أضواء مدينته الأصلية وهو الذى عاش متوهمًا أن عودته إليها قريبة. ما الذى يعنيه هذا الشتات العائلى المتكرر من جيلٍ لآخر بالنسبة لك؟ وإلى أى مدى يختلف لجوء السورى الكردى عن لجوء مواطنه السورى العربى؟
انتقل جدّى لأبى من قرى ماردين فى تركيا إلى بلدة عامودا التى كانت تعتبر امتداداً لما نسمّيه بالكردية «برّية ماردين»، أى أنّه لم يبتعد عن قريته سوى بضعة كيلومترات، وكانت الحدود حينها بصورتها الحالية المشدّدة بين كلّ من تركيا وسوريا أقلّ شراسة وإيذاء، وكان التنقّل بين الحدود ميسّراً وسهلاً لأبناء المنطقة ممّن كانت لهم امتدادات عائلية فوق الخط وتحت الخط. وهذا تعبير مترجم حرفياً عن الكردية يشير إلى المناطق الكردية التى تكون شمال الخط الحدودى فى تركيا، وإلى المناطق الجنوبية التى توجد شمال سوريا، ويقصد بالخط الحدودى هنا خط حديد بغداد – برلين الذى أصبح حدّاً فاصلاً بين سوريا وتركيا فى تلك المنطقة.
وبهذا المعنى كان جدّى نازحاً من قريته لبلدة قريبة منه، فى المنطقة نفسها، وبين الشعب نفسه، لم يتكبّد مشقّة الترحال والانخراط فى بيئة جديدة وتعلّم لغة أو ثقافة جديدة، وظلّ مسكوناً بحلم العودة لقريته بعد أن يصفّى حساباته هناك، ويمهّد لعودته من دون أيّة عداوات أو مواجهات مع السلطة أو مع خصوم من بنى جلدته.
أمّا اللجوء بمعناه الحديث فقد بدأ بين الأكراد قبل العرب فى سوريا، حيث لجأ عشرات الألوف من الأكراد إلى أوروبا فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وظلّت الأعداد تتزايد سنة بعد سنة، لأنّ الظروف كانت تزداد قسوة وفظاعة على الأكراد السوريين من قبل النظام وأجهزته الأمنية القمعية. فى حين أنّ لجوء العرب السوريين وغيرهم من المكونات السورية بدأ بعد سنة ٢٠١١وأصبح قضية عالمية متعدّدة الأبعاد.
فى الوقت الراهن يتساوى اللاجئون جميعاً فى الاغتراب وقسوة المنافى، ولا يمكن الحديث عن لاجئ مفضّل على آخر، لأنّ لكلّ منهم نصيبه من الخذلان والأسى والقهر، ولا يمكن الحديث عن مفاضلة بين الضحايا، لأنّ الهمّ أكبر من أن يسمح بترف المفاضلة أو التفضيل. الكلّ نال قسطه القاهر من النزوح واللجوء، ولا فرق بين كردىّ أو عربىّ أو أىّ سورىّ آخر فى هذه المسألة.
عن صحيفة أخبار الأدب المصرية