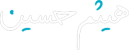هيثم حسين: نظام الأسد أنتج صورة وطن مأزوم وبَلور هويّات ضيّقة على مقاسه
حاوره: غسان ناصر
الروائيّ والناقد الكرديّ السوريّ هيثم حسين هو ضيف مركز حرمون للدراسات المعاصر، في هذه الفسحة الحوارية، وهو من مواليد الحسكة، عامودا، عام 1978، ويقيم منذ سنوات في لندن، المملكة المتّحدة. وهو عضو “جمعية المؤلفين” في بريطانيا، وعضو “نادي القلم الإسكتلندي”، ومؤسّس ومدير موقع “الرواية نت”.
ضيفنا يزاوج في أعماله الأدبيّة بين الروايات ودراسات النقد الروائيّ، وله من الروايات: «آرام سليل الأوجاع المكابرة» 2006؛ و«رهائن الخطيئة» 2009؛ و«إبرة الرعب» 2013؛ و«عشبة ضارّة في الفردوس» 2017؛ وأصدر سيرته الروائيّة «قد لا يبقى أحد» في 2018. أما دراساته في النقد الروائيّ، فهي: «الرواية بين التلغيم والتلغيز» 2011؛ و«الرواية والحياة» 2013؛ و«الروائيّ يقرع طبول الحرب»، 2014؛ و«الشخصيّة الروائيّة.. مسبار الكشف والانطلاق» 2015؛ وأعدّ وقدّم كتاب «حكاية الرواية الأولى» 2017. وكان أن ترجم عن الكرديّة، في عام 2007، مجموعة مسرحيات بعنوان «مَن يقتل ممو..؟» للكاتب الكرديّ بشير ملا. وتُرجمت روايته «رهائن الخطيئة» إلى اللغة التشيكيّة، وصدرت في مدينة براغ عام 2016، بترجمة يانا برجيسكا، وتقديم الشاعر والكاتب ييرجي ديدجيك، رئيس “نادي القلم التشيكيّ”، وقد تمّ اقتباس الرواية وتحويلها إلى مسرحية باللغة التشيكيّة، كما تمّت ترجمتها إلى اللغة الكرديّة، وصدرت في ديار بكر بتركيا عام 2018. وأخيرًا، أصدرت دار “عرب” اللندنيّة سيرته الروائيّة «قد لا يبقى أحد» باللغة الإنكليزيّة. وكانت مجلة (بانيبال) اللندنيّة، المتخصّصة في نشر الأدب العربي باللغة الإنكليزية، قد نشرت في خريف عام 2016 فصولًا مترجمة من روايته «رهائن الخطيئة»، ضمن ملفّ خاص عن الأدب السوريّ، في عددها رقم (57).
هنا نصّ حوارنا معه، ونتعرّف من خلاله إلى تفاصيل مشروعه الروائيّ والنقديّ، وإلى آرائه ومواقفه في الحياة والأدب والثورة والسياسة في الزمن السوريّ العاصف..
في مستهلّ حوارنا، ماذا تُنبئنا عن الإنسان والروائيّ والناقد هيثم حسين، المشغول بهموم وطنه النازف منذ أكثر من خمسة عقود من جراء تفرّد عائلة الأسد بحكم البلاد بقبضة من حديد؟
لن يخلو أيّ حديث عن الذات من عودة واجبة إلى الماضي الذي بلور الذات بصيغتها الراهنة، وأثراها بما اختزنه وراكمته من حكايات ومآس، ولا سيما أنّ الحياة، في ظلّ إقطاعة الأسد الكابوسيّة، كانت أشبه بمتاهة يوميّة تحاول جرّك دومًا إلى المستنقع، تجاهد لتلويثك بكلّ ما أوتيت من سطوة وقوة.
نشأتُ في بيئةٍ اعتادت القمع، وحاولت التآلف معه والالتفاف عليه بطريقةٍ لا تخلو من قسوة بدورها، وكان اعتيادي الشخصيّ ضربًا من المستحيل، كانت القراءات تحرّض لديّ روح التمرّد، تمضي بي إلى آفاق مفتوحة وأمداء لا نهائيّة، وحين أعود من عوالمها إلى الواقع، أصاب بخيبة أمل كبيرة. كان القهر سمة كارثيّة معمّمة، يمكنك مصادفته في كلّ مكان، في الوجوه، في ملامح الناس، في معالم المكان ومختلف تفاصيله وزواياه، وكان من الصعوبة بمكان التغاضي عنه، أو تمثيل عدم معرفته أو التعايش معه، لأنّه كان مستلبًا لأيّ بهجة، مهما كانت بسيطة.
أحزن كثيرًا، حين أتذكّر كثيرًا من التفاصيل التي انطبعت في ذاكرتي وتأبى أن تفارقها. أغضب حين أتذكّر كثيرًا من المواقف والأحداث التي عشتها أو كنت شاهدًا عليها. الحزن والغضب يتناوبان عليّ بين الفينة والأخرى. أذكر كم كان الإنسان رخيصًا، وما يزال، مع الأسف، لدى هذا النظام الكابوسيّ الجاثم على صدر البلاد منذ عقود.
تبلور وعيي بالظلم باكرًا، لأنّك حين تحيا في بيئة كبيئتنا الكرديّة في سورية، تدرك سريعًا معنى القهر والاضطّهاد، ومعنى أن يتمّ سلبك إنسانيّتك، وحرمانك من لغتك، ومن عيش أفراحك وأحزانك كما يمليه عليه وجدانك، وكما يبقيك متصالحًا مع تاريخك وحقيقتك. كان ذلك ضربًا من الأحلام التي لم يستطع إجرام النظام التاريخيّ تبديده، وظلّ عصيًّا عليه نسفه من جذوره.
أمام ذلك الواقع كلّه؛ كانت الكتب ملاذي، لأنّ أيّ مواجهة مباشرة مع النظام الذي كان في أوج جبروته كانت انتحارًا، فمضيت إلى المواجهة غير المباشرة عبر الكتابة، أو هكذا ظننت، لكن ذلك لم يرق لمخابرات الأسد التي كانت تُحصي علينا أنفاسنا، وبدأت بالتضييق عليّ، وحاولت تكريهي بالكتابة، وبالمجتمع الذي كانت تصفه بالجاهل، الذي لا يكترث للكتابة ولا للكتب ولا لما قد يصيبني من جرّائها، من مضايقات أمنيّة وتحقيقات واستجوابات ومحاولات تلويث الاسم أو تشويه السمعة.
الوعي بالظلم وبالقهر دفعني إلى عالم الكتابة. حاولت أن أقتصّ من الظلم بالحكايات؛ بتوثيق حكايات المضطّهدين والمهمّشين والمقهورين، وجدت فيها سلاحًا أواجه به تاريخًا من العسف، يحاول محو وجودنا والإمعان في إخضاعنا. لم يبقِ النظام أيّ معنى للوطن أو الوطنيّة، حرص على احتكارهما في شخص الدكتاتور، الأب والابن من بعده، وعمل جاهدًا على تغريبنا -السوريّين جميعًا- عن واقعنا وتاريخنا وبلدنا، تعامل بخبث ومكر وانتقام مع الناس، وعلى الرغم من ذلك، لم ينجح بشكل كامل في تعديم فكرة الوطن الحرّ المنشود في نفوسنا، لأنّ التوق إلى الحرّيّة هو حلم البشر عبر الزمن، ولا يمكن انتزاعه من أفئدة الحالمين والثوّار، بأيّ شكل من الأشكال. وسط تلك الفوضى التي كان يهندسها النظام بقذارة ويعمّمها بلؤم؛ حاولت أن أنتحي زاوية الكتابة، وأدوّن ما يمكن أن يكون شهادة على واقع من العار أنّه استمرّ كلّ تلك الفترة.



من العار ما جرى ويجري في سورية
يودّ قرّاء مركز حرمون أن يعرفوا ما الذي تكتبه الآن، أدبًا ونقدًا؟
تشغلني الرواية كثيرًا، تحتلّ الحيّز الأكبر من تفكيري، وإن لم تكن تحصل على الحيّز الأكبر من وقتي، نتيجة ظروف العمل ومشقّات الحياة اليوميّة. أكتب في رواية جديدة ولمّا أنتهِ منها بعد، وأعتقد أنّها ستحتاج إلى فترة لا أريد تحديدها بإطار زمني محدّد كي لا أقيّد نفسي بها، وكي لا أجد نفسي مضطّرًا إلى البحث عن إنهائها من دون أن تكون قد انتهت في داخلي، وفي خيالي. لا أتعامل مع الكتابة الروائيّة كتعاملي مع الكتابة الصحافيّة، لأنّ الكتابة الصحافيّة تفرض عليك الإنجاز اليوميّ مع كثير من التركيز والتدقيق أيضًا، ولا تملك معها رفاهية الانتظار وتعتيق الأفكار والتعامل مع المقاطع والمشاهد والأفكار كما تتعامل معها في الرواية، من حيث التأمّل والتمعّن والتلذّذ بجماليّاتها، والبحث الدائم عن صيغ مبتكرة لسرد حكايات وتسريب الأفكار والتصوّرات والرؤى من خلالها.
إلى جانب الرواية، أخوض تجربة كتاب يمكن أن أعتبره بشكل ما جزءًا تاليًا من سيرتي الروائيّة «قد لا يبقى أحد»، أكتب فيه بمتعة وشغف أيضًا. يتداخل فيها أسلوب كتابة اليوميّات مع سرد ذاتيّ، وبشكل مباشر يعبّر عنّي ولا يلجأ إلى التخييل أو تحميل الأفكار للشخصيّات الروائيّة، ولا الاختباء وراء أقنعة الرواية الكثيرة والمثيرة بدورها. أركّز على طرح القضايا التي تشغلني، وأجد نفسي راغبًا في تقديمها بشكل غير موارب، كما أعالج رؤى وأفكارًا ضاغطة، أحاول التعمّق في تفاصيلها وملابساتها، أسائلها وأمارس لعبة الاكتشاف الممتعة، المؤلمة أحيانًا، معها. وهذا الكتاب بدوره في مراحل متقدّمة، لكنّني لا أستعجل إتمامه أو الدفع به للنشر، حيث تداهمني كلّ فترة فكرة أقوم بترحيلها إلى وقت لاحق، بانتظار أن أتمكّن من اقتطاع بعض الوقت من نفسي لأمنحها حقّها من التعمّق والتركيز.
أمّا بالنسبة إلى الجانب النقديّ، فقد تراجع قليلًا، لأنّني أوليت أهمّيّة للرواية والسيرة واليوميّات، ولم تتبلور عندي صيغة كتاب نقديّ جديد بعد، ولا أجد نفسي ملزمًا بالتخطيط للدراسات النقديّة، لأنّي أريدها أن تنضج على مهل، ومن دون استعجال أو تسرّع. لا أقرب النقد من منطلق التحجّر والجمود، ولا مقيّدًا بالتنميطات والأحكام الجاهزة، مثلًا، في كتابي «لماذا يجب أن تكون روائيًّا؟» وهو يُعبّر عن أفكاري النقديّة في حقل الرواية الساحر، والثريّ المدهش، حاولتُ أن يكون التفكير النقديّ متّكئًا على روح الانعتاق من القيود التي يحاول بعضهم فرضها على الإبداع، أردت أن يشعر القارئ أنّه يمكن أن يقف على عتبة أبواب الرواية، ويمكن أن يطرقها، إذا وجد في نفسه الشغف، والشعلة التي تبقي ذلك الشغف متّقدًا، والصبر الذي يحتاج إلى التسلّح به. النقد فنّ إبداعيّ راسخ لا يقلّ عن إبداع أيّ من الفنون الأخرى الإبداعيّة، وليس متحجّرًا أو بعيدًا عن روح العصر.
بعد رحلة طويلة وقاسية في الشتات، هل تمكّنتَ من الاستقرار في مكان إقامتك الجديد في لندن؟ وماذا أضافت تجربة المهجر والمنافي المريرة إلى مجموعة تجاربك الإنسانيّة والإبداعيّة الأخرى؟
فكرة الاستقرار نسبيّة، وهي تختلف من شخص لآخر. بالنسبة إلي أجد أنّ الاستقرار ما يزال حلمًا عصيّ المنال، لأنّه ليس من السهولة بمكان أن تضرب بجذورك في عالم لا تنتمي إليه حقيقة، وتمثّل الانتماء إليه بحكم الظروف التي قادتك إليه، أو ألقت بك بين ظهرانيه، وحوّلتك إلى مقيم باحث عن الاستقرار فيه. أشعر بالقلق ينهش كياني دومًا، أحاول ترويض القلق وتهدئته بالقراءة والكتابة، أتحايل عليه، أقنع نفسي بأن أكتفي من الاستقرار المأمول بما تحصّلت عليه مؤقّتًا، لأنّني لا يمكن أن أعوّل على خطط طويلة الأجل في أيّ مكان، لا في لندن ولا في غيرها من المدن، حتّى الآن. عشر سنوات من التنقّل والترحال من دولة لأخرى ومن مدينة لمدينة، باتت تشعرني بأني نُذرت، ككثير من السوريّين، للترحال، ولا مكان للاستقرار في شريط حياتي الواقعيّ أو الذي يلوح في الأفق. أتمنّى حقًّا أن أجد إلى الاستقرار طريقًا، أو منفذًا، لكن لم أفلح في ذلك بعد.
ولا شكّ في أنّ تجربة الهجرة واللجوء والمنفى تضيف الكثير للمرء، ولا سيما لي ككاتب يحاول سبر الأمور والحفر عميقًا فيما وراء المواقف والأحداث والأقوال، وإضفاء طابع فلسفيّ عليها، لا لأخرجها من سياقها الطبيعيّ، بل لأدرجها في سياقها المتقاطع مع تفكيري النفسيّ وقلقي المتجدّد الذي لا يجد بدوره طريقًا للتهدئة. تمرئي لك الغربة هشاشتك، تُظهرك عاريًا أمام نفسك، تجد أنّك في مواجهة أعاصير من مشاعر قاهرة تجتاحك ولا تفسح لك المجال لتطويعها وتفهّمها والتغلّب عليها، تعلّمك أن تكون صلبًا من دون أيّ سند، لأنّك لا تملك رفاهية الانكسار، ولا سيّما حين تكون مسؤولًا عن أسرتك، ويعوّل عليك أهلك وإخوتك وأبناؤك وأصدقاؤك الكثير، ويجب أن تكون على قدر التوقّعات، ولا تسمح للانهيار أو الانكسار أن يتخلّل كيانك لئلّا يحطّمك ويحطّم معك آخرين مرتبطين بك.
أحاول التغلّب على القهر الذي تولّده مشاعر الغربة بالكتابة، أواجه مخاوفي وأضعها أمامي، لا أهرب من ملاقاتها ولا من الألم الذي يمكن أن تسبّبه لي، أهيّئ نفسي لصراع متجدّد معها، ولا أضمن الفوز في جميع الجولات، لأنّ الإنسان يقع صريع لحظات ضعف قد تضربه على غير توقّع أو تغافله من دون أن يكون مستعدًّا لها، ولكن على الرغم من ذلك، أحاول تفهّم كلّ هذا الاضطّراب ومجاهدته ومغالبته بالكتابة، وبالأمل الذي أبقيه حيًّا في داخلي، بالرغم مما أمرّ به من ظروف.
ماذا عن مشاغلك وهواجسك وهمومك اليوم، على صعيد الكتابة كمبدع يعيش في الغربة والمنفى الاضطّراريّ؟ وماذا عن الصعوبات التي تواجهها هناك؟
تعلّمك الغربة أن تشعر بغيرك أكثر، يعلّمك جرحك النازف أن تعمل على مداواة جراح الآخرين والكفّ عن أيّة لامبالاة بها، فهنا في لندن، مثلًا، كثير من الأعراق واللغات، أناس من جنسيّات مختلفة من ثقافات ولغات كثيرة، لكلّ منهم همومه ومشاغله، تتقاطع الدروب اليوميّة مع بعضهم أحيانًا، فتجد همومهم لا تقلّ عن همومك، وأنت الذي تتخيّل أنّ همّك هو الأكبر والأقسى. يعلّمك المنفى أن تتفهّم غيرك، ويفتّح عينيك على مآسي الآخرين أيضًا، من دون أن تنسى مأساتك. وإن كان يقال أحيانًا إنّ صاحب المصيبة أعمى، إلّا أنّ الغربة تجعلك تدرك أنّ صاحب المصيبة يمكن أن يبصر مصائب غيره ويتعاطف معهم، ويجد نقاط تقاطع معهم، لأنّ ما يجمع البشر في كلّ مكان أكثر بكثير ممّا يفرّقهم، لكن اعتاد كثيرون منّا توهّم أنفسهم مركز الكون، من دون إيلاء اهتمام مستحقّ لغيره. ولعلّ أيّ حديث عن الصعوبات هنا نوعٌ من الترف، بالمقارنة مع الصعوبات التي قاسيتها وواجهتها في بلدي، الذي لم يكن رؤوفًا بي ولا بغيري من أبنائه. الصعوبات هنا نفسيّة أكثر منها مادّيّة، فأنت مضطّر إلى مواجهة وحشتك وغربتك بعيدًا عن عالمك الذي تربّيت فيه، وأنت مضطّر إلى التأقلم مع عالم جديد لا تجد مفرًّا من الانغماس في تفاصيله.
من معين تجربتك الشخصيّة، هل تختلف الكتابة في المنفى بعيدًا عن رقابة السلطة الأمنيّة والضغط السياسيّ والخوف الذي يسكن (سوريا الأسد) منذ ما يزيد عن النصف قرن؟
المنفى ليس بتلك القسوة على الكتابة، فهو يحرّر الكاتب من كثير من القيود التي كان محكومًا بها في بلده. وسّعت في المنفى رقعة الحرّيّة التي أكتب بها، بالموازاة مع تشديد المسؤوليّة الأخلاقيّة والإنسانيّة. أذكر أنّني حين كنت في سورية كان للتحدّي والمواجهة طعم مختلف، خوف مشوب بالحذر والتوجّس ومحاولات الالتفاف على سلطة الرقباء والمخابرات، بالترميز تارة والتلميح تارة أخرى، وممارسة نوع من المداورة على الأفكار والتسميات المباشرة والواضحة. المنفى كان أرحم عليّ من وطني.
من العار ما جرى ويجري في سورية منذ أكثر من نصف قرن، فكيف يمكن اجتثاث غريزة الحرّيّة عند البشر، بممارسة أقسى أنواع القمع والقهر بحقّهم!! وكيف يمكن أن يتمّ تحويل الرقيب إلى سلطة، والحكم عبر الترويع من دون إيلاء أيّ اعتبار لحركة التاريخ ومقتضيات العصر.
تدرك في المنفى أنّك تخلّصت من براثن نظامٍ يشكّل خطرًا على البشريّة، وذلك حين تراجع محاولات الإخضاع المستمرّة التي مارسها عليك وعلى غيرك، وكيف جدّ لتلويثك وانتزاع إنسانيّتك منك، ومن هناك فمواجهته وفضحه باستمرار، وفي كلّ مناسبة، واجبٌ أخلاقيّ وإنسانيّ قبل أيّ شيء آخر.



سلالة الاستبداد تواصل سيرة القمع والعنف والإجرام
ككاتب ومثقّف كرديّ سوريّ، كيف تنظر الآن، بعد كلّ ما جرى ويجري، إلى مفهومَي الوطن والهويّة؟
مع الأسف، لم يكن الوطن في أيّ يوم من الأيّام لائقًا باسمه وبالعظمة التي يجب أن تكون عليها الأوطان التي تغرس عشقها في قلوب أبنائها وأرواحهم، كان الوطن مستلبًا، مغرّبًا عن تاريخه وراهنه، محتكرًا بيد عائلة تعيث فيه فسادًا وتحكمه بمنطق الانتقام، لا بمنطق الاحترام.
الوطن المفترض فكرة مثاليّة حلا لي ولغيري أن نلهج بها في أدبيّاتنا، كنّا نرسم صورة ورديّة له، صورة وطن يعزّز مشاعر الانتماء لدى أبنائه، ويزرع فيهم الولاء والحبّ، وهذا ما كان مبعث أمل في بداية الثورة، حيث اجتمعنا -السوريّين جميعًا- على شعارات موحّدة، التقينا على حبّ الوطن الذي ننشده ونرسم لمستقبله في خيالاتنا صورًا ورديّة، لكنّ المستبدّ وأدواته الإجراميّة وعصاباته الطائفيّة وحماته المحتلّين، من إيرانيّين وروس، دفنوا هذا الحلم وسحقوه بشكل فظيع، أبادوا الحالمين وأحرقوا أيّ معبر يمكن أن يمهّد لأيّ سلام أو تصالح في المستقبل. صاغوا وطنًا ممسوخًا لا ينتمي إلى روح العصر، ولا يرتقي لأحلام أبنائه ولا تضحياتهم في سبيله.
من هنا، عاد الوطن ليكون فكرة مثاليّة رومانسيّة في أحلامنا، من دون أن نعثر له على أيّ تجسيد في الواقع. وما ينطبق على فكرة الوطن يكاد ينطبق على فكرة الهويّة، فقد دأب النظام على تفتيت الهويّة الوطنيّة الجامعة، مثّل بها، جعلها صورة للخيبة والانهيار، أهانها وأهان المؤمنين بها، وبلور هويّات ضيّقة على مقاسه العدوانيّ الانتقاميّ. أغلق السبل نحو صيغة وطنيّة للهويّة، صيغة تحترم المواطن وتمنحه شعورًا بالأمان والانتماء والولاء، فأنتج هويّات بائسة، ممسوخة كذلك، كي يظلّ المتخفّون بأرديتها المرقّعة عراة مأزومين دومًا. أنتج النظام المجرم صورة وطن مأزوم، وهويّة ضبابية مأزومة، أعدم جميع الخيارات التي يمكن أن يعدمها ليقطع أيّ خيوط تواصل بيننا، السوريّين، بجميع انتماءاتنا العرقيّة والدينيّة.
برأيك، هل تغيّر دور المثقّف والكاتب السوريّ ما بعد ثورة آذار/ مارس 2011؟ وهل يمكن قراءة سورية بعد خمسين سنة، مثلًا، من خلال أدبها (رواية، قصة، شعر، نصوص)؟
دور المثقّف كان وما يزال ممثلًا ومجسدًا بالتعرية والفضح والكشف والمساءلة، يحمل المثقّف على عاتقه أعباء حراسة الذاكرة وتدوين التاريخ الذي يروي سيرة الوطن وتضحيات أبنائه، لا ذاك التاريخ الذي سيكتبه النظام، والذي سيراهن أنّه سيتحوّل إلى حقيقة بعد عقود أو قرون، إذا سارت الظروف كما يشتهيها، بحيث يرث الحفيد أباه وتعود دورة التاريخ لتعبث بمصاير السوريّين بين الجد والابن والحفيد، حيث سلالة القمع والاستبداد تواصل سيرة القمع والعنف والإجرام، وتعدم أيّ أمل بالتغيير في المستقبل، وتفرض سرديّتها للتاريخ مقدّمة نفسها على أنّها المخلص للوطن من الإرهابيّين والضامنة لأمنه ووحدته وسلامته.. وهذا من سخريات الأقدار ومفارقات التاريخ.
ومن هنا، فأيّ عمل أدبيّ إبداعيّ، مهما كانت هويّته، يُسهم في حفظ جزء من الذاكرة السوريّة التي يجب أن تبقى موثّقة ومتجدّدة، ويقدّم شهادة على تاريخ يقف على النقيض من التاريخ الرسميّ المشوّه، ويقدّم سرديّة تواجه الطاغية وأحابيله وتفضح منظومة الإجرام المتناسلة. نحن الآن نكتب تاريخ الغد، وعلينا، كأدباء ومثقّفين، أن نكون أوفياء لأنفسنا وتاريخنا وحاضرنا وزماننا وأمكنتنا، وعلينا أيضًا التسلّح بمهاراتنا وقدراتنا الإبداعيّة لحفظ ذاكرتنا والوفاء لمن قدّموا التضحيات من أبناء بلدنا، كي لا نفسح المجال لتسيّد رواية النظام وزبانيته، ولا للمرتزقة من تابعيه ممّن يقدّمون أنفسهم كتّابًا وطنيّين، ويحاولون العبث واللعب في مناطق يعتقدون أنّها ما تزال رماديّة، في حين أنّها سوداء ملوثة بوجودهم وتقاطعهم مع النظام فيها. أمثال هؤلاء هم مَن يحاولون تلميع صورة النظام بتشويه معارضيه، أو اختيار زاوية بعينها وتضخيمها، وتقديمها على أنّها كانت يمكن أن تسود البلاد في حال فشل النظام في حربه على السوريّين.
كروائيّ، ما قراءتك الحاليّة للوضع السوريّ العامّ ولما آلت إليه أوضاع السوريّين بعد عشريّة داميّة، وُصفت أنّها الأكثر كارثيّة في العصر الحديث؟
لا أودّ أن أكون متعاميًّا عن الواقع، أو لائذًا بأحلام ورديّة تحجب قباحاته ومآسيه. الواقع قاتم، مع الأسف، وما يزيده قتامة هو انسداد الأفق الذي يغلّفه ويكاد يتحوّل إلى سمة لهذه المرحلة. لم تعد سورية ذاك البلد الذي حلمنا به، بل أصبحت نسخة مشوّهة منه، مكبلة بعدّة احتلالات من شماله لجنوبه، ولا يمكن ترقيع التشوّهات الكثيرة التي أصابته وأغلقت، بعدوانيّة وحقد، الدروبَ للمضي نحو مستقبل مبشّر له ولأبنائه الحالمين. الواقع مأساوي وكارثيّ، مع الأسف، وسيبقى هكذا ما بقي هذا النظام المجرم الفاسد. لذلك لا مناصّ عن التغيير، وليس من المعقول، ولا من العدل والإنصاف، أن تذهب تضحيات السوريّين هدرًا، ويبقى المجرمون فالتين من العقاب، ناسفين الجسور للانتقال نحو المستقبل المأمول.
لم تعد سورية بلدًا موحّدًا، هناك مناطق متعادية، متحاربة، تابعة لجهات إقليميّة ودوليّة متباينة الرؤى ومتضاربة المصالح، لذلك فهي مقسّمة واقعيًّا، وإن لم يكن هذا التقسيم معلنًا بعد.
ليس بالإمكان تقديم أيّ قراءة متفائلة، في ظلّ الخراب المعمّم، ولا أقول إنّنا هُزمنا وعلينا الإقرار بالهزيمة والاستسلام للأمر الواقع، لأنّ ذلك يعدم أيّ أمل بالتغيير المستقبليّ المحتوم الذي دفعنا في سبيله أثمانًا باهظة، لكن علينا التحلّي بالجرأة لمواجهة الواقع وانتقاد مظاهر الخراب المتفشّية فيه، بغية تدارك ما يمكن تداركه، والتخطيط للمواجهة بأدوات معاصرة تتوافق مع روح العصر، وتنقل خطابنا وسرديّتنا للآخرين، وتبقينا حاضرين في جميع المحافل، كأصحاب قضيّة عادلة لا يمكن أن تموت، أو تُنسى بالتقادم.



«إبرة الرعب».. بين الأدب والسياسة
ننتقل معك للحديث عن روايتك «إبرة الرعب» التي تغوص فيها في جملة من القضايا الراهنة والحسّاسة، بدءًا من الحرب والظلم والفساد، حتّى الاتجار بالبشر، والتحوّل الجنسيّ، والتطرّف، مُحاكيًا واقعًا معقّدًا يعيشه المواطن العربيّ الغارق في صراعات الهويّات القاتلة، منذ عقود حتّى الآن. حدّثنا عن مناخات كتابة هذا النصّ ودوافعه.
في الحقيقة، انتهيت من كتابة «إبرة الرعب» سنة 2010، ولم يكن يلوح حينها أيّ أفق للتغيير، وكان الواقع مستنقعًا راكدًا تفوح منه الروائح الكريهة، من دون أن يكون لدى كثيرين الجرأة لتعريته وفضح خفاياه وقباحاته، وتأخر نشرها حوالي ثلاث سنوات، حيث اشتعلت الثورات في دول عربيّة عدّة، ومنها سورية، وكان المزاج العامّ سياسيًّا، وإخباريًّا، غير مهيّأ للنشر، كما تمّ إلغاء معارض للكتاب في أكثر من دولة، لذلك تمّ تأجيل نشرها عامًا بعد عام، إلى أن نشرت سنة 2013 في بيروت.
الواقع، كالتاريخ، يعيد نفسه بصيغ وحشيّة وقاسية كلّ مرّة، فما نشهده اليوم سبق أن شهده سابقونا أيضًا، ومع الأسف، سيشهده لاحقونا بصيغة مختلفة كذلك، وكأنّ العنف سرٌّ وجوديّ لا غنى للبشر عنه في حلّهم وترحالهم. طرحت في هذه الرواية عددًا من الأزمات والقضايا، كنتُ يائسًا لدرجة مؤلمة من الواقع، كان الإرهاب جمرًا تحت الرماد، يتمّ تحريكه بحسب الحاجة وحين الطلب من قِبل النظام، وكان موجّهًا وموظفًا، كما كان هناك طيف من النقائض التي ترسم صورة الواقع وتخلط الألوان بطريقة عبثيّة، فكان التفكّر والتمعّن فيها ومحاولة التقاطها وعرضها من الدوافع الأساسيّة عندي.
أردتُ لهذه الرواية أن تكون كاشفة بجرأةٍ، قد يصفها البعض بالوقاحة، أردتها صادمة، مستفزّة، وأحيانًا تنفّر القارئ، وهي تريه صورًا من واقعه الذي يحاول التغاضي عنه، وهي ما تزال تفاجئني بعد أكثر من عقد من كتابتها، وتتجدّد مع كلّ قراءة، ويتمّ تفعيلها على أيدي القرّاء في أمكنة مختلفة.
بعد نحو سبع سنوات على نشرها، صدرت «إبرة الرعب» بطبعة جديدة عن دار “خطوط وظلال” في الأردن، بالتزامن مع صدورها باللغة الفرنسيّة عن دار “لارماتان” في باريس، بترجمة أنجزها الباحث والمترجم التونسي منصور مهني. سؤالنا: كيف تلقّى النقّاد والقرّاء الفرنسيّون هذه الرواية؟ وهل تعتقد أنّ هذا الاهتمام بترجمة الأدب السوريّ خاصّة في هذه المرحلة مرتبطٌ بالأوضاع السياسيّة؟
تزامن نشر الترجمة الفرنسيّة مع اجتياح جائحة كورونا للعالم، وتسبّبها بما تسبّبت به حتّى الآن من مصائب، لذلك لم أتمكّن من تلقّي أيّة أصداء عن كيفيّة تلقّيها من قبل القرّاء بالفرنسيّة، سوى بعض الآراء الانطباعيّة عن جرأتها في طرح مواضيع وقضايا حسّاسة. ولم تتمكّن الدار بعد من إحياء أيّ نشاط، ولا حفل إطلاق أو توقيع للرواية، لذلك فإنّها ما تزال تخطّ طريقها ببطء وهدوء في عالم الفرنسيّة.
ويبدو أنّ الاهتمام بالأدب السوريّ لا يخلو من ارتباط بالأوضاع السياسيّة، حيث يحتاج الغرب إلى معرفة جزء من ممهدات هذا المصير الذي وصلنا إليه، والأدب، وبخاصّة الرواية، يعطي صورة واضحة عن أجزاء من الواقع، وعن تفاصيل ممّا كان يعترك فيه من مفارقات مغيبة عن الأعين.
تساؤلات كثيرة طرحتها على نفسك في سيرتك الروائيّة «قد لا يبقى أحد»، وبدورنا نطرح عليك اثنين منها لتجيبنا عنهما: هل السيرة قيدٌ بمعنى ما؟ وهل يتعرّى الكاتب وهو يدوّن أجزاء من سيرته أو حين يسرّبها في أعماله؟
أحاول أن أستدرج القارئ إلى التفاعل، والتشارك، وإبداء وجهة النظر، والبحث عن إجابة، لأنّني لا أملك الإجابة الشافية، ولا أدّعي امتلاك أيّ حقيقة. تخطر لي أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات، أو مقترحات وصيغ للإجابات المتوقّعة. قد تكون السيرة تحرّرًا، كما يمكنها أن تكون قيدًا، إن لم يتعاطَ الكاتب معها بصدق وتصالح مع ذاته وتاريخه، لأنّه سيقف أمام ذكريات ومواقف قد لا يريد تذكرها أو الخوض فيها، ويكون أمام امتحان المواجهة واختبار قدرته وجرأته على تفكيك أوجاعه الماضية واستحضارها وتأبيدها بالاسترجاع والكتابة، ما يبقيها حيّة متجدّدة، مثيرة للأسى مع كلّ استحضار أو قراءة.
العري هنا رمزيّ ونسبيّ، كما تعلمون، وقد يكون صنوًا للشجاعة عند بعضهم، أو صورة لجلد الذات والانتقام منها عند آخرين، لكن في كلّ الأحوال، لا يمكن الكتابة عن الذات، ولا يمكن الإبحار في الكتابة السيريّة من دون جرأة وصراحة وصدق، وأركّز على الصدق، لأنّني أعدّه من أمضى الأسلحة في الكتابة وأكثرها تأثيرًا وإيصالًا للرسائل المنشودة. ويمكن هنا الحديث عن الحقيقة والصدق من المنظور الفنّيّ، وعن الكذب الفنّيّ، ما يمكن أن يوصف بأنّ “أعذب الشعر أكذبه”، أو بالقياس على ذلك القول “إنّ أصدق الروايات أكذبها”. لكن بالطبع الصدق الذي أتحدّث عنه ليس بذاك المندرج في الإطار الفنّيّ، بل الحياتيّ والواقعيّ، الذي قد يوصف بأنّه مفتاح كاشف شفاف لصورة الذات في مرآتها الكتابيّة والتاريخيّة، الذات بعيون صاحبها وبقلبه المفتوح من دون تعميّة أو تلاعب.
ما قد يعدّه بعضهم تعرّيًا قد يكون تحرّرًا، أو تخفّفًا من أعباء ذكريات وحكايات قاهرة ضاغطة، كما قد يكون أشبه بالاعتراف الدينيّ الذي يفتح صاحبه بعده صفحة جديدة، ويشعر براحة أكيدة وكأنّ همومًا انزاحت عن صدره. الحكايات قد تكون همومًا وأعباء إن لم نحسن صياغتها، والاعتراف بما اعترانا أو مرّ معنا في رحلتنا الحياتيّة. الإنسان هو حكايته أوّلًا وأخيرًا، والكتابة تحرير للجنّي من قمقم العتمة وقفص الذاكرة.
تُرجمت سيرتك الروائيّة «قد لا يبقى أحد» إلى اللغة الإنكليزيّة، أخيرًا، وقبل ذلك تُرجمت لك أعمال عدّة إلى العديد من لغات العالم، ماذا يعني لك التوجّه إلى القارئ الغربيّ؟ وهل تعتقد أنّ في الأدب رسالة كونيّة تتخطّى كلّ الحواجز السياسيّة والثقافيّة…؟
لا أشكّ أنّ في الأدب أعظم وأنبل مرسال للآخر، ويمكن من خلاله تجسير كل الفجوات، أو تبديد بعض من حالات سوء الفهم التي يمكن أن تكون نابعة من الجهل بالآخر. الأدب ينير العتمات ويكشف الأفكار والأحداث وما وراءها، ويرتحل بسهولة ويسر ليمارس دوره في التقريب والتهيئة للحوار والتواصل والتعاون. لا يمكنك أن تتواصل مع من تجهله وتجهل تفكيره وأفكاره، أو قد تظلّ تنظر إليه بعين الشكّ، وهو كذلك يكون محاصرًا ومسكونًا بأحكام مسبقة وأفكار وصور نمطيّة عنك، تكبّله ويكبّلك بها، وتتشاهق حينها الحواجز والأسوار وتحجب التقاطعات وتلغي المشتركات الإنسانيّة الكثيرة التي تجمعكما.
التوجّه إلى القارئ الغربيّ ضروريّ، ومهمّ، ويلعب دورًا في تعرّفه إلينا وإلى مآسينا وحياتنا وماضينا وذكرياتنا، على أفكارنا تجاه الحياة والحب والقضايا الإنسانيّة الكثيرة التي تشغلنا معًا، ولا تكون حكرًا على شرقيّ أو غربيّ. كان يهمّني كثيرًا أن يصل كتابي إلى القارئ الغربيّ عمومًا، والبريطانيّ خصوصًا، لأنّ ما ورد فيه من حكايات اللجوء والغربة والمنفى تتقاطع مع حياته وواقعه، وهي تعكس صورًا من واقعه الذي يكون محجوبًا عنه، أو لا يريد أن يراه، ويظنّه بعيدًا عنه في جغرافيّة أخرى، أو في مكان بعيد عنه لا يمكن أن يقترب منه. نحن نحمل أمكنتنا معنا، ونسير تحت أعباء حمولتنا الماضية من الحكايات والأفكار والذكريات، ونجد أنفسنا بين ظهراني مجتمعات جديدة فرضتها حالة اللجوء علينا، وهناك من أبناء هذه المجتمعات من لا يبصر غيره، أو يظنّ وجوده حالة طارئة ستتلاشى بعد حين، في الوقت الذي يمكن أن تكون تلك الحالة الموصوفة بالطارئة مديدة أبديّة، لذلك من الواجب عليه اكتشاف من يشاركه مكانه ومدينته ويستقي من ثقافته ويشاركه مصيره ومستقبله. لسنا نحن المشكلة، نحن ندفع ضريبة سياسات وممارسات لم نخترها، ولم يكن لنا رأي أو قرار فيها، ولا يمكن أن نحاكَم غيابيًّا على ما نعانيه، من قبل الغربيّ الذي قد يشعر بأيّ مزاحمة له في مكانه، أو محاولة لتعكير صفو حياته.
للكتابة قدرة كبيرة على التشافي والمعالجة، ويمكن للقارئ الغربيّ استشفاف جزء من معاناتنا والاطّلاع على جانب من أفكارنا وترجماتنا لبعض أفكاره التي قد توصف بالسطحيّة أو الغريبة عنّا. أراهن على الكتابة لتشكيل جسور التواصل وتمتين سبل التعاون حاضرًا ومستقبلًا.
المعارضة السوريّة أثبتت فشلًا ذريعًا ومخجلًا
هناك رأيٌ لأدباء سوريّين ونقّاد، مفاده أنّ الغرب لا يُترجم من أدبنا إلّا ما يناسبه أو ما يندرج غالبًا تحت فكرة “الاستشراق”، لكننا نلاحظ أنّ هناك أعمالًا أدبيّة (رواية، قصة، شعرًا..) تناولت الثورة/ الحرب السوريّة وتُرجمت إلى العديد من لغات العالم. كيف ترى الأمر من وجهة نظرك؟ ومن ثمّ، هل استطاعت هذه الأعمال -على تنوّعها- إيصال صورة الواقع المأساويّ للسوريّين إلى الغرب؟ وكيف تفاعل الغرب -نقّادًا وقرّاء- مع هذه الأعمال عامّة، ومع أعمالك خاصّة؟
أعتقد أنّ التعاطي مع الأعمال السوريّة من قبل الغرب يأتي في سياق الحرب وما أثارته من رغبة في معرفة عالمنا الذي يبدو وحشيًّا ودمويًّا من جهة، ومن جهة ثانية أصبح هناك سوق يتعطّش لالتقاط ما هو قادم من ذاك المُحترِب، أو ما يتحدّث عنه ويصفه، بحيث يمكن أن يعطي صورة عن ذاك الواقع وتاريخه، وكيف تراه وصل إلى ما وصل إليه من جنون وكوارث.
التعاطي الغربيّ مع الأدب السوريّ، والعربيّ عمومًا، ليس بريئًا بالمطلق، هناك محاولة لفرض وتقديم وتصدير المطلوب منه، بحيث يؤكّد وجهة نظره عنه، لكنّ هذا يعني أنّ الغرب يكون طرفًا وحيدًا أو جهة بذاتها، بل هو بدوره جهات وتوجّهات، وتلعب العلاقات والشلليّات كذلك دورًا في تصدير بعض الأعمال على حساب أعمال أخرى. ربّما أثار واقع الحرب والدمار نوعًا من التعاطف، أو الشفقة، من قبل غربيّين قاربوا أعمالًا سوريّة مترجمة، تعاملوا معها من منطلق التشجيع أكثر من مقاربتها وتفكيكها نقديًّا، كانت هناك في أغلب الأوقات رافعات معيّنة تعمل على حمل روايات سوريّة مترجمة، بحيث تضعها في سياق تجاريّ تسويقيّ يمكن أن يكون بعضه مضلّلًا ومخيّبًا للآمال، وهنا أشير إلى روايات بعضها ذات مستوى فنّيّ محدود بالعربيّة، لكنّها حاولت الالتفاف، بعد الترجمة، على السويّة المحدودة والادّعاء بتحميلها دلالات ورموزًا لم تستطع النهوض بها أو التعميّة من خلالها على أعين القرّاء الغربيّين بسهولة. هناك من العرب أو المنتفعين منهم من أسهموا في ترويج أعمال من هذه السويّة، وتقديمها للغرب، وإظهارها على أنّها قمّة الأدب السوريّ المعاصر، ما يتسبّب في تشويه واقع الأدب وتاريخه أيضًا، ويُقصي كثيرًا من الأعمال الجادّة العميقة لصالح أعمال تسويقيّة لا ترتقي إلى المستوى المأمول والمفترض.
اختلفت كيفيّة تفاعل الغربيّين مع أعمالنا المترجمة، وظهرت هنا وهناك مقالات معدودة، حاولت إضاءتها وتصديرها بشكل ما، لكنّ الآليّات التي تحكم السوق الغربيّ وتنظّمه، وإن بدا متعطّشًا لقراءتنا، مختلفة عن الآليّات التي تبدو بدائيّة في عالمنا العربيّ. بالنسبة إلى أعمالي المترجمة، تمّ تحويل روايتي «رهائن الخطيئة» المترجمة إلى التشيكيّة إلى عمل مسرحيّ، وكان هناك تفاعل لافت مع العمل، بحسب ما بلغني. أما بالنسبة إلى روايتي «إبرة الرعب» المترجمة إلى الفرنسيّة، فليس هناك ما يُذكر بعد عنها سوى بعض الآراء الشخصيّة التي تصلني عن طريق قرّاء أو أصدقاء، ولسوء حظها أنّ نشرها تزامن مع تفشّي جائحة كورونا التي أصابت العالم بالشلل، ولم نستطع تنظيم أيّ نشاط متعلّق بها. بلغني خبر عن طريق أكاديميّين عرب وسوريّين في باريس أنّ هناك مخطّطًا لإدراجها ضمن مساق دراسة الأدب العربيّ المعاصر في إحدى الجامعات في فرنسا، لكن لا أعرف التفاصيل بعد. أمّا كتابي «قد لا يبقى أحد»، فقد قوبل حتّى الآن باحتفاء مميّز من قبل من قرأه هنا في بريطانيا أو في أميركا، وباعتبار أنّ الترجمة صدرت حديثًا، فإنّ من المبكر الحديث عن تفاعل إعلاميّ أو نقديّ معها، لكن هناك آراء مبشّرة، وهناك أكاديميّة كتبت عنه بحثًا أكاديميًّا مطوّلًا عنه، واقترحت على ناشر إيطاليّ ترجمته إلى اللغة الإيطاليّة أيضًا.
من منظورك، هل ما تحقّق حتى الآن من ترجمات للرواية العربيّة عمومًا، والسوريّة على وجه الخصوص، كفيلٌ بتحقيق أن ترفد الرواية السوريّة والعربيّة مكتبة السرد -إن صحّ القول- في العالم، بعيدًا عن ادّعاء أنّ الترجمة هي السبيل الكفيل بتحقيق ما يسميه البعض بعالميّة الرواية العربيّة؟
ما تُرجم حتّى الآن من الرواية العربيّة إلى الإنكليزيّة محدودٌ جدًا، بالمقارنة مع الكمّ الكبير المتراكم في العالم العربيّ، وهو يُسهم -على قلّته- في تعريف الغرب بجزءٍ من الحراك الأدبيّ العربيّ، لكنّه لا يشكّل حركة راسخة، بل يظلّ على الهامش، ولا يؤثّر كما يؤثّر أدب أميركا اللاتينيّة، مثلًا، يُنظر إلى الأدب العربيّ من باب القصور تارة والتشجيع تارة أخرى، ويبقى بمعنى ما بعيدًا عن التناول النقديّ المفترض الذي يقيّم العمل ويحاكمه ويفكّكه ويناقشه ويعالج محاوره وتفاصيله، وكأنّ الطبطبة على الأكتاف والتربيت بداعي التعاطف أو التحفيز هما كلّ ما يحتاج إليه الأدب العربيّ المترجم.
ليس هناك سوق بالمعنى الحقيقيّ للأدب العربيّ في الغرب، الغرب في قرارته ينظر إلى العالم العربيّ، والشرق عمومًا، على أنّه مصدر المشكلات ومستنقع الحروب والتناحر والاقتتال، وبالتالي السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا هو هل يمكن لمن يعيشون ذاك الواقع، أو من نجوا من براثنه بصيغةٍ ما، تقديم أدب يرتقي لمصاف آدابنا، أو هل يمكن أن يشكّل ما يكتبه ويبدعه أبناء تلك المجتمعات إضافة حقيقيّة لنا. لا أتحدّث عن عقدة التفوّق الغربيّة بإطلاق هنا، بل أشير إلى بعض الأفكار الكامنة التي يمكن أن تلعب دورًا في خلق سوق أدبيّ أو تحريك مياهه الراكدة. وعلينا أن نكون واقعيّين في تقييم التفاعل الغربيّ حتّى الآن مع الأدب العربيّ المترجم، من دون أوهام الغزو الثقافيّ المضادّ أو أيّ أوهام مضخّمة.
التقيت ببعض الدارسين والقرّاء، هنا في بريطانيا، ممن قرؤوا أعمالًا لنجيب محفوظ أو عبد الرحمن منيف، اعتبروها مملّة، ولم تستطع جذبهم، منهم من أكملها بدافع الفضول والاكتشاف، ومنهم من صرّح لي بأنّه لم يكملها، ولا يمكننا هنا أن نلقي اللوم على الترجمة، بل ربّما هو نوع من الاختلاف الثقافيّ والحضاريّ الذي يحتاج إلى كثير من الجسور الأدبيّة والفكريّة لتعزيز التواصل والانفتاح، بعيدًا عن أيّ عقد تاريخيّة من الطرفين، وهذا بدوره يحتاج إلى عمل مؤسّساتيّ حقيقيّ وتراكميّ. ولا يمكن للترجمة أن تحقق أيّ عالميّة لأيّ رواية، فهي وإن كانت توصلها إلى ضفاف جديدة لكنّها لا يمكن أن تبحر بها في فضاء العالميّة، ما لم تكن هي في بنيتها متفردّة ومميّزة.



تمّ تشكيل رابطة للكتّاب السوريّين، ثمّ خبا دورها لسنوات طويلة، وهناك إشكالات كثيرة حول هذا الأمر، ومع الأسف، ليس هناك تنظيم قادر على جمع الكتّاب والمبدعين السوريّين المعارضين -في العقد الأخير- من خلال المساهمة النقديّة والفكريّة المواكبة للثورة، فما أسباب ذلك برأيك؟ وكيف بدا دورُ المثقّفين والكتّاب السوريّين خلال سنوات الثورة الأولى؟
استمرّ قسم من المثقّفين السوريّين على نهج المواجهة والفضح والتعرية، لم يُذعنوا لمحاولات الإخضاع المستمرّة لعقود في ظلّ حكم الأسد الإجراميّ. استبشر المثقّفون بالتغيير خيرًا، لكنّ ما حصل فاق أسوأ الكوابيس، ولم يفسح أيّ مجال للمهادنة مع نظام وصل إلى هذه الدرجة من الإجرام. حرّض المثقّفون على المحافظة على منظومة القيم التي ظلّوا يؤمنون بها، وإن كانوا بدوا في ممارساتهم التنظيميّة ضمن أطر وتشكيلات معارضة مشتّتين، غير قادرين على توحيد أصواتهم المتّحدة ضدّ النظام والمتخالفة فيما بينها على كثير من التفاصيل التي كان من شأنها تبديد جهودهم وتفريق صفوفهم.
ولعلّ الفشل الذي لاحق تشكيلات المثقّفين والأدباء والصحفيّين السوريّين في جزءٍ منها صورة للفشل المعمّم على الصعيد السوريّ، وهو جزءٌ من خراب أوسع، يبدو أنّه حالة “صحّيّة” ولا بدّ منه في مرحلة انتقاليّة تروم الخروج من براثن حكم الطاغية. يمكننا القول إنّ الأمر صحّيّ في جانب، لأنّه يمرئي الاختلاف والتنوّع واختلاف الرؤى، ومن جانب آخر يمكن توصيفه بالمسيء والمدمّر، إذا كان بحثًا عن سلطة ما أو نفوذ أو تنفيعات وامتيازات صغيرة وقصيرة الأمد، ما قد يكرّس الصورة التي أرادها النظام وسعى إلى ترسيخها في الأذهان عن المثقّفين، على أنّهم فئة أنانيّة نرجسيّة لا يمكن التعويل عليها ولا توكيلها بأي شأن عامّ.
أعتقد أنّ الأسباب التي يمكن إيرادها تندرج في السياق العامّ للثورة، وليس في سياق العمل الثقافيّ المعارض فقط، لأنّ وضع المثقّفين واختلافاتهم صورة لخلافات السوريّين واختلافاتهم التي لا تنتهي، ومع الأسف، يبدو أنّنا لم نعتد أسلوب التحاور بعد، كما يجب، للوصول إلى الصيغ المثلى المأمولة، وهي ليست مستحيلة، كما يضخّم بعض المتشائمين، لكنّها تحتاج إلى التواصل والانفتاح بمحبّة ومن دون أعباء الأحكام المسبقة، والتعالي على الخلافات والحساسيّات الشخصيّة المهينة للقيم الثقافيّة والإنسانيّة. مواجهة نظام مجرم لا يمكن أن تتمّ من دون تركيز وتوحيد القوى وتقريب الرؤى والمواقف وتنويع التشكيلات المعارضة في مختلف المجالات لتقديم تصوّر محترم لمن يقدّم نفسه بديلًا مستقبليًّا.
اعتقل نظام الأسد (الأب والابن) في العقود الخمسة الماضية مئات من الكتّاب والمثقّفين والفنّانين، وما يزال عددٌ منهم يقبعون في سجون الاستبداد الأسدي منذ سنوات طويلة حتّى الآن. كيف تقرأ واقعًا يُحاكَم فيه الإبداع وتكمّم فيه الأفواه؟ وهل يُمكن أن تكون حرّيّة الكاتب مطلقة وسط ثقافة عامّة تُغذّيها المحرّمات؟
لا يمكن أن تُنتج محاكم التفتيش في ظلّ الدكتاتوريّة أدبًا حقيقيًّا، هي ضدّ الإنسان بالمطلق، تراها تبحث عن مختلف السبل لتلويثه والتنكيل به وتحويله إلى مسخ، وتوجيه أيّ عمل أدبيّ محتمل لينصبّ في خدمتها، بحيث تفرغ الأدب من مضمونه الإنسانيّ وقيمه لصالح تعظيم الدكتاتور الذي يرى في أيّ تجرّؤ على الكلام أو التفكير في ظلّه تجرّؤًا عليه وصفاقة ينبغي تأديب صاحبها. واقع كهذا من الطبيعيّ أن ينتج مسوخًا بشريّة تجعجع كثيرًا، لكنّها لا يمكن أن تبدع ما هو قيّم ومعتبر. ولا يمكن لمن لم يعش الحرّيّة في داخله أن يبدع بأيّ شكل من الأشكال. حين يتحرّر الأديب من قيود الخوف يُحلّق في عالم الإبداع من دون أيّ وساوس أو مخاوف، يرسم بخياله عوالمه المبتكرة ويبحر فيها بعيدًا عن إملاءات الطاغية ورقبائه.
حرّيّة التفكير والكتابة والخيال لا تشكّل خطرًا على الطاغية وحده، بل هي بخرقها المحظورات تُحرج من ينصّب نفسه وصيًّا اجتماعيًّا أو طوطمًا باسم الدين أو القبيلة أو أيّ شكل من أشكال الوصاية، سواء كانت اجتماعيّة أو دينيّة أو سياسيّة. الحرّيّة تربك أولئك الرازحين في عتمات الجهل والتخلّف، لأنّها تكشف عريهم الذي لا يمكنهم التستّر عليه، فتراهم يلجؤون إلى التحريم يشهرونه سلاحًا بوجه الخيال والفكر.
كيف تنظر إلى واقع الرواية الكرديّة؟ وكيف تصف العلاقة بين الأدبين الكرديّ والعربيّ؟ ما المشتركات بينهما؟ وما آليّات تطوير هذه العلاقة نحو الأفضل؟
هناك روائيّون أكراد يكتبون الرواية بالعربيّة، وهناك من يكتب بالتركيّة والفارسيّة، بالإضافة إلى الروائيّين الذين يكتبون بالصورانيّة أو الكرمانجيّة، وهناك روائيّون أكراد يكتبون رواياتهم بلغات أخرى، كالإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة وغيرها من اللغات، ما يعني أنّ الرواية الكرديّة روايات بلغات متعدّدة، تنهل من الواقع الكردي وتاريخه وجغرافيّته، وهي بقدر ما تكون كرديّة من حيث المضامين والقضايا التي تطرحها إلّا أنّها تثري آداب اللغات التي تكتب بها، وتكوّن جسورًا للتواصل والتحاور بين الشعب الكرديّ وغيره من الشعوب التي يتعايش معها.
في الحالة الكرديّة، لا يمكن تجنيس الرواية، من حيث اللغة التي تكتب بها، وسلخها عن كرديّتها أو سلب كرديّتها منها بمجرّد أنّها مكتوبة بالعربيّة أو أيّ لغة أخرى، وقد يثير هذا سجالًا عن تجنيس الأدب في إطارات أوسع من اللغة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات التاريخيّة والجغرافيّة والحوامل الثقافيّة والفكريّة واللغويّة كذلك للروائيّ الكرديّ. ربّما تكون الرواية الكرديّة المكتوبة باللغات الأخرى محاولة متجدّدة من الروائيّين الأكراد، لتبديد ما يصطلح عليه “المنفى اللسانيّ”، بحسب تعبير الصديق الناقد الأدبيّ السوريّ الدكتور خالد حسين، حيث إنّ المنفى اللسانيّ يكون وسيلة لمواجهة الذات والآخر، السعي لكسر الجدران العازلة وتعزيز التواصل والتعارف. يلوذ الروائيّ الكرديّ بمنافيه اللسانيّة ليروّض منفاه الواقعيّ، ويتغلّب على الغربة والقهر والمنفى الذي يعيشه في واقعه وتاريخه. لغة الآخر هنا تكون خارجة من حيّز منغلق على ذاته لتّتسع لغيره، وإن بدا أنّه يكتب سرديّات قد يعتبرها البعض على أنّها نقيض سرديّاته، أو يصفها بأنّها تهديد من داخل لغته بتمكّن يضارعه أو ينافسه أو يتفوّق عليه. معظم الروائيّين الكرد الذين يكتبون بالعربيّة يظلّون مسكونين بقضاياهم العادلة، ويكتبون بلغة عالية لا تقلّ عن لغة أمهر الأدباء العرب وأكثرهم إبداعًا وبراعة.
في الحالة السوريّة، أطلق النقّاد عددًا من التسميات على النتاج الأدبيّ منذ العام 2012 مثل: “أدب ما بعد الثورة”، “أدب الحرب”، “أدب الفاجعة”، “أدب المأساة”، … إلخ، كيف يمكن أن يصوغ الكتّاب والنقّاد السوريّون عناوين موحّدة لهذا التيّار الأدبيّ الجديد؟
لا أعتقد أنّ توحيد المصطلح أو التوصيف هو المهمّ في هذه المرحلة، لأنّ التراكم يفرز المصطلحات بالتقادم ويفرضها ببساطة وتلقائيّة من دون أيّ محاولة للتسلّط. ليست هناك صفة محدّدة يمكنها تقييد الأدب السوريّ الحديث بها، وهذه الصفات كلّها تنطبق عليه. لا يمكن الحكم على الأدباء من حيث كتابتهم عن الحرب أو تداعياتها أو آثارها، على الرغم من أهمّيّة القضيّة وضغطها المتجدّد طوال عقد وأكثر من الزمن، لأنّ هذا يتنافى مع مبدأ الحرّيّة الذي يجب أن يتحلّى به الأديب.
هناك أدباء ما يزالون في صفّ القاتل، يختلقون لأنفسهم ذرائع وحججًا لتبرير موقفهم، وأهمّ تلك الحجج هي محاربة الإرهاب والمحافظة على وحدة البلد، وغيرهما من الحجج البائسة التي لم تعد تنطلي على أحد، ولا يمكننا نزع صفة الأدب عمّا يكتبون ويبدعون، لكن يمكننا وصمهم بالانتهازيّين والجبناء، ويمكن لتاريخ الأدب محاسبتهم على مواقفهم، وهنا يكون السؤال الأكبر عن الأدب والأخلاق، عن المسؤوليّة التاريخيّة والقيميّة والأخلاقيّة وعن أدوار من يعتبرون أنفسهم روّادًا للتنوير.
التصنيف بات واضحًا ولا يقبل مناطق رماديّة، إمّا أنّك مع القاتل وإما أنك مع الطريق إلى الحرّيّة. وأن تكون ضدّ القاتل لا يعني أن تكون تابعًا لهذا الفصيل المعارض أو ذاك، لأنّ المعارضة السوريّة، مع الأسف، أثبتت فشلًا ذريعًا ومخجلًا طوال سنوات، وأصبحت وبالًا على السوريّين، وأكّدت أنّها قاصرة، ولا تستحقّ أن تقود شعبًا قدّم تضحيات عظيمة. الأديب الحرّ يعارض المجرمين، سواء أكانوا في ضفّة النظام أم في ضفّة المعارضة، ويكتب انتقاداته من دون محاباة أو خوف.
في الختام، كيف تتمنى أن تكون سورية الجديدة؛ بعد سقوط نظام بشار الأسد؟
يبدو أنّ هناك منظومة عالميّة متشبّثة بهذا النظام الفاسد، وهذا يُبقينا -السوريّين- في حلقة مفرغة من اليأس، وتوهّم النظام أنّه انتصر، وأنّه صاغ سورية جديدة على مقاس إجرامه، بحيث يُبقي السوريّين الباقين تحت سيطرته، كوقود ورهائن ودروع بشريّة في الوقت نفسه.
الأمنيات لا تخلو من رومانسيّات وشاعريّات وإنشائيّات، وقد تبدو أنّها تغمض عينًا عن الواقع وتتعامى بحثًا عن واقع آخر بعيد قد لا يأتي، لكن لا يمكننا نزع الرغبة في الأحلام والتمنيّات من أنفسنا، كي لا نصبح مجرّدين من إنسانيّتنا، لأنّ الإنسان من دون أحلام يتحوّل إلى آلةٍ، تؤدّي مهمّات يوميّة ولا تسعى إلى التغيير أو المثال المنشود.
أحلم ببلدٍ يحترم أبناءَه ويليق باسمه، أتمنّى أن تكون هناك ذات يوم سورية تكبر بجميع أبنائها وتتّسع لجميعهم، أحلم ببلد يمكن أن أسمّيه وطنًا حقيقيًّا، وليس منفى أو سجنًا أو مزرعة لأحد. أدرك مشقّة الحلم في واقع الحرب الكارثيّ، لكني أوقن أنّ الحلم والأمل هما آخرُ ما يموت في داخل الإنسان.