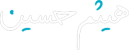رحلة الضياع في كتاب «قد لا يبقى أحد» للسوري هيثم حسين
د. نازك بدير
■ ما معنى أن تعيش باحثًا عن وطن؟ كيف يمكن أن تكون بين ظهرانيه منفيا؟ أي مستقبل يبقى عندما يتحول الوطن لمقبرة، وعندما تتيه ناشدًا أمانًا مفقودًا وهوية ممزقة، وتصبح كائنًا مسكونًا بالقلق، متشظيا بين ماضٍ لا يفارقك، وحاضر مترع بالتناقضات؟
درب الآلام، من عامودا إلى أدنبره يخطه هيثم حسين في كتابه «قد لا يبقى أحد أغاثا كريستي… تعالي أقل لكِ كيف أعيش» (دار ممدوح عدوان دمشق ـ 2018) يحاول أن يفرغ أحماله التي تراكمت عبر السنين في سوريا أولًا، ومن ثم في طريق الهجرة، من خلال البوح بها والكتابة عنها، للشفاء منها. لعل ثيمة الضياع هي الثيمة الأساسية في هذه السيرة الذاتية، والضياع هنا لا يتعلق بصاحبها وحده، إنما هو سمة شعب كُتِب عليه أن يصارع بحثًا عن حقه في الحياة وفي الوجود وفي العيش وفي التعبير. ضياع في الداخل، حيث لا يعرف معنى الاستقرار أو الطمأنينة، وفي الخارج، يمضي العمر في رحلة انتظار.
يرافق هاجسُ البحث عن الوطن المفقود الكاتبَ على مدار النص، وكأنه البؤرة التي تنبت منها الصراعات. يسترجع ما عاناه من إبعاد قسري عن مدينته عامودا إلى قرية» بائسة»، ومن ثم انتقاله إلى شبعا في ضواحي دمشق، واحتراق منزله بعد شهر ونصف الشهر من إقامته فيه. المنزل «ركننا في العالم، كوننا الأول» كما يرى غاستون باشلار، فقده هيثم حسين. يصور تلك اللحظات وكأنها حية أمامه الآن… كيف وقف عند الباب يلتقط الصور وهو يعرف في قرارة نفسه أنه لن يعود إليه مرة ثانية. هذا الشعور الدائم بالخسارة كان يلازمه، وكأنه محكوم عليه بالانسلاخ عن كل ما يربطه بالمكان.
يحاول ابتداع صورة واهمة عن تاريخ لم يعرفه، ويتنكر لحاضر هو فيه، فيبقى متشظيا بين عالمين بحثًا عن ذاته، وهويته.
في المرحلة الثانية عندما غادر البلاد، بات يبحث عن ذاته: في الداخل كان منفيا، في الخارج يسأل: يُسمي اللاجئ نفسه: مهاجرًا، منفيا، مغتربًا؟ شعور بالضياع واللانتماء، لا يستطيع العودة إلى الوراء ـ الوطن، يرى منذ الآن وكأنه يعبر مقبرة، وضبابية الحاضر والمستقبل. لعل سؤال الهوية هو سؤال رئيس كون الكتاب بحد ذاته يختصر أزمة هوية اللاجئ، سواء أكان لاجئًا في بلده، أم في أي بلد آخر، عربيا كان أم أجنبيا. الهوية، كما يعبر عنها «تعيش في داخلنا، ترتحل معنا تهاجر معنا الهويات وتتغير بتغير المكان والزمان».
أتاحت له الغربة معاينة اللاجئين عن قرب، ثمة نماذج تأبى إلا أن تحتفظ بنعرة الاستعلاء. ومنهم من يضمر الحقد للبلد المضيف. يعري الكاتب هذه الشخصيات، يغوص في عاهاتها النفسية، ومركبات النقص التي تتملكها يصنعون أمجادًا خرافية لهم ويطلبون من الآخر التعامل معهم على أساسها. أفرز تشرذم اللاجئ بين ماضيه وحاضره مشكلات متعددة. وكأن اللجوء لم يكن هو الحل، إذ لم يتمكن أن يتعايش مع ثقافة البلد الذي لجأ إليه، وفي الوقت نفسه، أخفق في التحرر من ماضٍ بكل ما فيه من تجارب مزقت دواخله، لذلك تراه يحاول ابتداع صورة واهمة عن تاريخ لم يعرفه، ويتنكر لحاضر هو فيه، فيبقى متشظيا بين عالمين بحثًا عن ذاته، وهويته. هذا التشظي يجعله عدائيا مع نفسه أولًا، ومع من نزح من أسرته ثانيًا، ومع المحيط الذي لجأ إليه ثالثًا، فإذا به يتحول إلى كائن مسكون بالقلق. ونتيجة شعوره أنه منبوذ، تراه دائم الحذر، يسكنه الخوف من الفقر، من الجوع، من الخوف نفسه ما «يمنع اللاجئ من التصالح مع ذاته»، فكيف يستطيع التصالح مع الآخر والانسجام مع المجتمع؟ يحاول الكاتب البحث في العمق عن جذور مشكلة اللاجئين واقتراح حل لها. ما يحتاج إليه اللاجئ لا يكمن في تعلم اللغة، وإنما الحل في «أن تكون سفيرًا حقيقيا لبلدك الأصلي وثقافته».
«أغاثا كريستي … تعالي أقل لكِ كيف أعيش» يعاتبها على الأحكام التي أطلقتها عندما حلت زائرة مع زوجها، فالكراهية في كل مكان، وليس كما صورتها كريستي في البلاد العربية فقط. من البريطانيين من يكره اللاجئ لأنه غريب. مقياس التعاطي مع اللاجئ هو «متهم حتى يُثبت براءته». وغالبًا ما تغيب العدالة فتكون المكافأة فردية والمعاقبة جماعية، فإذا ما حقق اللاجئ تميزًا ما «يُعزى إلى الظروف التي هيأها له البلد المضيف، أما أن يُقدم أحدهم على فعلة منكرة فإنه يشار إلى بيئته الحاضنة السابقة التي رعته وأطلقته ليكون خطرًا على الجميع».
في خضم هذه التناقضات جميعها، وتجرع الخسارات المستمرة، يصر الكاتب الذي «يعيش بعقله هناك وبجسده هنا» على العبور إلى الحياة، وعلى اصطناع السعادة مع معرفته أنها «حلم الإنسان المستحيل».
في الفصل الأخير من الكتاب، نقرأ العبارة التالية: «لا أريد للكتابة أن تكون تصفية حساب مع أحد»، ولكن، يظهر أن النزوع إليها بدا محاولة تصفية حساب مع الذات، ومع الذاكرة، ومع البلاد، أو نوع من إعادة التوازن إلى النفس التي تهشمت بفعل الحرب. وبذلك، يبقى أحد… ويروي لنا كيف يعيش.
٭ كاتبة لبنانية
عن صحيفة القدس العربي