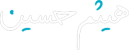الروائي يتماهى مع الراوي ويناجي أغاثا كريستي
أحمد رجب
“قد لا يبقى أحد” مانيفستو لأوديسا اللجوء الجماعي عبر يوميات الكاتب السوري هيثم حسين.
السيرة الروائية فن سردي هجين يجمع بين السيرة والرواية، يتماهى فيه الروائي مع الراوي، ويكون مصدرا لتخيلاته مانحا إياه حرية كبيرة في الاستفادة من تجربة الروائي الشخصية، وفي نفس الوقت يصادر حقا يمنحه القارئ لنفسه حين يطابق بين الشخصية الواقعية وسيرتها الشخصية، ربما تلك المصادرة كانت دافعا للروائي والناقد السوري هيثم حسين ليصف كتابه “قد لا يبقى أحد” بأنه سيرة روائية.
في كتابه الجديد ”قد لا يبقى أحد” لا يخفي الروائي السوري هيثم حسين قلقه من المطابقة بين شخصه الحقيقي والشخصية الروائية في أكثر من موضع من كتابه السارد لسيرة اللجوء.
ويبدو أن الكاتب كان قلقا بشأن تجنيس كتابه، فوصفه في ثناياه بأنه “يوميات بريطانية”، كما يستعيد تعريف الأرجنتيني لويس جروس لكتابة اليوميات بأنها استحضار للأرواح من منطلق إحساس ما بالذنب، كما يثير أسئلة عن علاقة الروائي بذاته وبكتابته، وعن التداخل بين الحقيقة والخيال في ما يسرده الروائي حينما يكتب جانبا من سيرته الذاتية، كما يتساءل عن السيرة، وهل هي قيد بمعنى ما؟ وهل يتعرى الكاتب وهو يدوّن أجزاء من سيرته أو حين يسربها في أعماله؟
الأمكنة الجديدة
حاول هيثم حسين أن يمنح يومياته شكلا روائيا بمناجياته لأغاثا كريستي، فكان العنوان الفرعي للكتاب “أغاثا كريستي.. تعالي أقل لك كيف أعيش”، الذي يشير إلى مذكرات الروائية الشهيرة في سوريا والعراق حينما رافقت زوجها المستكشف الأثري.
كتاب أغاثا كريستي عنوانه “تعال قل لي كيف تعيش”، وفيه تقول عن عامودا، موطن الكاتب، “كم هو بسيط هذا الجزء من العالم وكم هو بالتالي سعيد، الغذاء هو الهم الوحيد، فإن كان الحصاد وفيرا فأنت ثري حتما وتستطيع أن تقضي بقية العام بكسل ووفرة حتى يحين موعد حراثة الأرض وبذرها من جديد”.
اللاجئون لا يتحملون مسؤولية كونهم كذلك، وقد كانوا في أوطانهم آمنين قبل أن تدفعهم الحروب إلى التشرد
وعن افتراضها بأن الشرقيين سعداء يقول إنّ السّعادة نسبيّة، تتمثّل في لحظات ومواقف نتيجة أخبار سعيدة، لا ترسم خطا تصاعديّا أو شكلا كاملا لصورة السّعادة المتخيّلة في الأذهان؛ فلحظات السّعادة هي فواصل الحياة اللغويّة، يشبّهها بعلامات الترقيم التي تهندس سيل الكلمات وفوضاها المتناسلة.
وتستمر المناجيات خلال عدد من الفصول تبدأ بتوجيه الخطاب لها، وكأنها إحدى شخصيات الإطار الروائي المغلف ليومياته.
يستعير هيثم حسين ما جاء في “الأزمنة السائلة” لزيغمونت باومان “اللاجئون في المكان وليسوا منه، فهم مُعلقون في فراغ مكاني توقف فيه الزمن، فلا هم مستقرون ولا هم متنقلون، ولا هم أهل التعود، ولا هم أهل الترحال”، ليصف حاله، موضحا “أجد نفسي في المكان ولستُ منه، فيه ولستُ فيه كأني مُعلق في فراغ يؤرجحني بينما الزمن ينسل ويتبدد، لأتلاشى معه وأرتحل في الذاكرة والذكريات، أحفر في ذاتي عساي أستدل إلى مصالحة مفترضة مع نفسي”، فلعله يستعيد التوازن بعدما وجد نفسه عاجزا عن إقامة أي علاقة حقيقيّة بالمكان، أو عاجزا عن تحقيق التّوازن النفسي المطلوب مع ما حوله، فكان مضطرا إلى العودة للحلم وللذكريات ولأيّ ماض يعيد إليه بعض التّوازن.
وتستمر عملية التذكر في محاولة من الكاتب للتصالح مع ذاته المشردة، عبر مواجهة الذات، وهي المواجهة التي ظل يهرب منها لسبعة عشر عاما، وقد وجد سبيل المصالحة بين ذاكرته والآلام المتراكمة حينما اغترب عن وطنه، وعن ذلك يقول ”تُرينا الغربة الانتماء في عدسة الذات والآخر، يكون البعد سبيلا إلى الاقتراب والتماهي أكثر، قد يصبح الوطن في بعض الأحيان حجابا، قد تغدو الغربة مرآة وسبيلا إلى الوطن”.
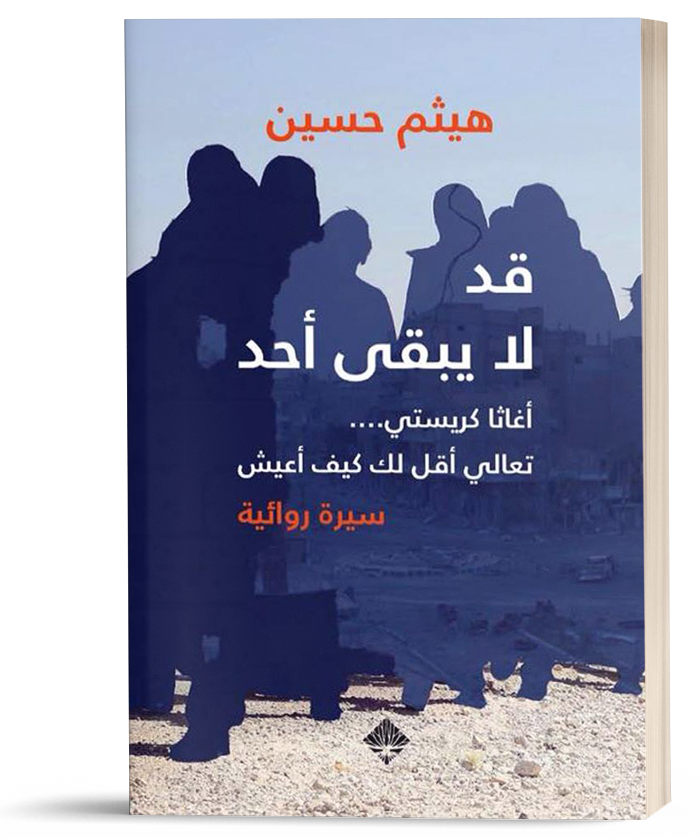
ويضيف في موضع آخر “دفعتني الأمكنة الجديدة إلى الغوص في داخلي، ومراجعة ذاتي وأيامي الماضية، وذكريات الأسى والقهر والهدر التي أحملها معي كأعباء تثقل كاهلي، أقنعت نفسي أن الزمن القادم لا يحتمل المضي تحت أعباء تلك الأحقاد والأحزان، وأنه يحتاج للتخفيف من حمولتها لأتمكن من العبور إلى غدي بأقل الخسائر الممكنة”.
اللاجئ منبوذا
تحت عنوان “أن تصبح منبوذا” يكتب هيثم حسين “أن تصبح لاجئا يعني أن تصبح مذعورا، أن تصبح منبوذا رهين ذاكرتك وذكرياتك وحنينك ولن تتحرر من سطوة ذعرك الداخلي”.
ويتذكر “كنت أنبذ نفسي دون أن يتراءى لي أي نبذ في نظرات الآخرين إلي، أصبحت حساسا لدرجة كبيرة إزاء كل تفصيل يصادفني أقوم بتأويل نظرات الناس العفوية بأنها نظرات ازدراء وتشكيك وأود لو أستطيع أن أبرر لهم أسباب وجودي بينهم. والمشكلة أنه حين يقترف أحد اللاجئين جريمة ما فإنه يتسبب بالحرج للجماعة التي ينتمي إليها ويكون التصنيف وسيلة للتعريف وإطلاق الأحكام تاليا أو تطبيق القيود والحدود بطريقة ما”.
ويشير الكاتب في فصل آخر إلى وقوع اللاجئ في إشكالية تعريف نفسه، فإن كان مهاجرا فالمهجر لن يصبح وطنا، وإن ظل لاجئا فإنه يبقى على الحواجز بينه وبين عالمه الجديد، وتبقى الغربة ملتصقة بالروح، إذ ينظر اللاجئ بمنظار الغريب في العالم الذي لا يريد الاندماج فيه، وتتقاطع رغبات كل اللاجئين في الحصول على ملاذ آمن.
لذا لا تختلف حكايات لاجئ عن آخر، وإن كانت هناك بعض تباينات، فالهارب من الحرب ليس كالهارب من الفقر. وفي مراكز التجمع، يدفع الحذر والتوجس والارتياب اللاجئين إلى الكذب وإخفاء بعض التفاصيل عن بعضهم البعض، ويبدو المخيم بروتينه اليومي كسجن كبير.
ويفسر الكاتب هذه الظاهرة والتشكيك المنتشر بين اللاجئين من أبناء البلد الواحد بالازدواجية والتناقض اللذين يسمان حياة اللاجئ في واقعه الجديد.
يرفض الكاتب اعتبار اللاجئين ذئابا منفردة، ويتساءل هل هناك توجه عالمي جديد بهندسة وطن متخيل للاجئين عبر العالم، وهل يشكل اشتراك اللاجئين بحالة اللجوء عاملا حاسما لبلورة تصور عن وطن ما، عابر للأوطان والحدود، ويدين تصوير اللاجئين وكأنهم جلادون لغيرهم ومهددون لسلامتهم في أوطانهم الآمنة، فاللاجئون لا يتحملون مسؤولية كونهم كذلك، وقد كانوا في أوطانهم آمنين قبل أن تدفعهم الحروب إلى التشرد، لذا فالأجدى البحث عن حلول لمنع الحروب والجرائم التي تدفع إلى اللجوء. فاستمرار مسببات اللجوء يؤدي إلى تفاقمها واليأس من الرجوع لأوطان قد لا يبقى فيها أحد.