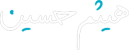مستقرات السرد في الرواية – رومانس المكان-: هيثم حسين في روايته :آرام: سليل الأوجاع المكابرة
إبراهيم محمود
في موضوعة العلاقة بين الرواية والتاريخ، يربط غراهام هو الرواية بالواقع المحدّد، لتكون لها خصوصيتها، وكذلك نثرها السردي التخييلي، في كتابه ( مقالة في النقد)، بينما يتحدث نورثروب فراي، في كتابه ( تشريح النقد)، ومن خلال ربط السرد بتعددية الفصول: فصول السنة، في مماثلاته المشهورة، ليكون الرومانس حبكة الصيف، يبرز الرومانس ( أقرب الأشكال الأدبية إلى حلم تحقيق الرغبة)، وكيف أن المغامرة هي ( العنصر الأساسي للعقدة في الرومانس) ، اعتماداً على مفهوم النزاع agon، وتكون الكارثة pathos محركة الرومانس لمواجهة الشرالممثل في اللوياثان: النموذج الميثولوجي للشر متخيلاًفي التاريخ، وفي مجالات مختلفة، بينما يظهرالناقد روجرهينكل ، في كتابه ( قراءة الرواية” مدخل إلى تقنيات التفسير)، موقع الشخصية في ؤالرواية و( إيحاءاتها الموظفة) وكيف أن واقعاً ( ينشأ من حولها). وفي هذا الثالوث النقدي الموسوم، تتجلى الرواية الأرضيةَ المتعددة التضاريس، إن من جهة مناخاتها الاجتماعية والطبيعية المتداخلة معها، أو من ناحية الرؤية التي تقيم عليها أودها الرمزي. وفي الحالات الثلاث يحضر التاريخ، لأن لا رواية خارج التاريخ، مهما تجلت فانتازتيكية، مثلما لا تاريخ خارج الزمكان، ويستحضَر الرومانس المراهن على حبكة معينة، حبكة يقررها الصيف كمعقّب فصلي، ومؤثر وقتي في مصائر الكائنات، لأن في الوقت متسعاً من التحركات ذات المستقرات النسبية، لتعيين ما من أجله كانت ولادة العمل الأدبي: الرواية هنا، بينما يكون العمل الأدبي مقرَّراً باعتبارذاتي إبداعي ، من لحم ودم كائنين ، بلغة آيلة رحالة إلى مكان آهل بالقيم، وزمان يحدد نوعية القيم هذه، وصراعاً يُتوخى منه، ما من أجله سمت الرواية نفسها رواية، وتقدمت بشهادة ميلاد، وشهود: الكاتب نموذجاً، ومن يقبل على قراءتها، لمكاشفة المولود الأرضي: الدنيوي أو الخلائقي.
إنه السرد، في فعله الحدثي، في تتالي أحداثه، أو تنوع مساراته، مثلما هو الفعل الزمكاني الذي يتشعب ، بما يتناسب وكيفية تجلي رحالها.
في رواية ( آرام ” سليل الأوجاع المكابرة ” )، للكاتب هيثم حسين: سليل عامودا، والصادرة حديثاً عن دار الينابيع 2006، يبدو أن الكاتب في باكورأعماله يريد انتساباً مكانياً دون التخلي عن الزمان المهموز دخلها، رواية بحجم عامودا التي كانت والتي تكون والتي تريد أن تكون ، وعامودا الواقع والحلم، عامودا الرغبة بدورها ، عامودا الشتاء العاصف، والربيع الوارف والصيف النازف والخريف المهدّىء للروع، وفي الصميم السردي يحاول الكاتب أن يكون طلَّاع ثنايا حركية السرد واللائذ به قيمةً ، من منظور تسميتي لها بـ( رومانس المكان)، فالمكان رغم الحركة الطافحة في الرواية هو الذي يسمي كائناته ، لا بل يعرّف بما جعلها مأخوذة بجملة من الإسقاطات لا تكون للرواية قائمة إلا بها !
بدءاً من العنوان والعلامة الفارقة لـه، مع الأخذ بالصورة بعين الاعتبارهنا، وانتهاء بالمسطور على الجانب الآخر من الغلاف الخارجي، يشهد رومانس المكان، على القلق المعاش، مثلما هو ذاته يكون دالة قلق، وحصاده معاً !
( آرام) الاسم المكتوب بالعربية هنا، محليٌ بامتياز، مألوف بتردداته الأرمنية، كردياً يكون قيمة اعتبارية نفسية، إذ يعني : الصبر، وفي بعض الأحايين يكون بمعنى خافت ، وهذا تحديد مجازي كما أرى، ولا أظن الكاتب اختار عنواناً مشهودأ بسعة الصدر، دون معرفة معناه، ولعل في التنويه، في التحديد التعريفي، وربما التوصيفي ما يبرز ذلك ( سليل الأوجاع المكابرة)، فليس من يكون آراماً، وهو اسم العلم هنا في الرواية، لا بل بؤرة التوتر، ومتروبولها الدلالي، أويعيش آراماً: اسم العلم إلى جانب الصفة، إلا ويظهر مركَّب المعاناة، أي يتميز بالرومانس القصي، ورومانس المكان بالذات، لا بل ربما جاز لي استحضار المعنى التليد للاسم، في ساميته، فيما هو آرامي، كما هو معروف عند أهل العلم أو الاختصاص، حيث تكون المفردة هكذا بالهمزة المفتوحة لا الممدودة ( أرام)، أي يكون المعنى ( الأرض المرتفعة)، وما تعنيه من مشاق، حالة صعودها، وربما ذهبت ُ في القول بعيداً( إذا كان للتمادي في تعقب سيرة الكلمة الذاتية بعض ٌ من مشروعيته، أو لمباغتة المكبوت المكاني البعيد من تيمة رمزية)، ليكون في ظل التنائي وجهه الآخر: التداني، فأربط منذ البداية الاسم بـ( إرم: إرم ذات العماد)، وما عرِفت من خسف مكاني، لأنها عصت على التغيير، فكان انتقام العصيان المعكوس وجهاً لازماً لتناهيها الوجودي بأهلها، وأن يكون آرام ، سليل الأوجاع المكابرة، وأيَّاً تكون نسبة العلاقة المكانية ، فإن التوصيف تعريف بالعلامة الفارقة، من جهة التنسيب ( سليل، سلالة)، لتكون المكابرة الصفة الضاجة بالمردود الذاتي، من جهة المعانة وعدم التصريح بها، ربما هو أيوب آخر: كردي مقام اسم ٍ، في قائمة المميَّزين بالأوجاع، وليس بالوجع الواحد، كما هو المعنى الطائف: التاريخي البيولوجي النّسبي : سليل، أي ثمة توارث وورثة وإرث لجملة الأوجاع، لتكون حركية الصور: اللوحة المرسومة للفنان الكردي خضر عبدالكريم، موضوعة في حيّز المشار إليه رمزياً، وفي الجانب الآخر، في الطرف الآخرالمناظر، ثمة تحديد، كما لو أنه شاهدة محفورة على قبر، الرواية هي القبرالمفتوح، ونزيله ليس إلا آرام، وهذه الكلمات المألوفة باختصارها الودائعي:
( لا عدل إلا هنا..
أو.. هنا يرقد العدل منذ بدء الخليقة…).
ندخل هنا عالم الميثولوجيا، واليقينيات الكونية المدوَّنة والرائجة، إنما عبر بوابة الأدب وحرفة البلاغة القولية، عندما يكون العدل راقداً، ومنذ بدء الخليقة، إذاً لم يكن من وجود للعدل إلا بصفته ميتاً أو مضحى به، وكأن بين العدل وآرام بعضاً جلياً من أثريات التشخيص الوصفية، فيكون العدل عائداً إليه، ليتحجم ( يأخذ حجماً) من خلاله، ويكون هو داخل المفردة العصية على النظر مشخصاً، في لعبة الدال والمدلول، أي لعبة الرومانس الشجية في المكان.
هي لعبة تأخذ حيّزاً واسعاً في التعريف بخفة التقديم والتأخير، أعني النقلة داخل السرد، كما في القسم الأول المعنون بعلامة مكسورة ( آرام: هنا..ك، بعد..) هو كسر مكاني، تحديد إصابة، بدء بفاجعة، بحداد وشيك، أو حادث، ( هنا) ضمناً، لأن ( هنا.. ك) بنائيتها، محاولة إفحام للغة من اللغة بالذات، ونظر في البعيد لمكاشفة القريب، وليس في الـ( بَعدُ..) بخاصيات التنقيط المتتابعة، رمز الفراغ المبلّغ ببليغه الدلالي، سوى انتظار ما لم يُسمَّ، وفي الـ( بعد) ماهو ( بُعدُ) كذلك، ما يحتاج تحركاً في المكان، ليكون القسم هذا، وكان عليه أن يكون الآخر، لأني القسم الثاني، والذي يحتل أقل من ثلثه ( 73 من أصل 240 صفحة من القطع الوسط، تشكل كينونة الرواية مقاماً كمياً لخطاب الروائي( مقول قوله الأدبي)، والقسم الثاني هو( آرام: هنا، قبل.) كما لو إن ( هناك) تستحضر في ملفها اللغوي ( بعد)، و( هنا) تستوجب( قبل)، كما لو أن صيغة هناك تتوجه إلى الآتي، المستقبل، ولهذا كانت ( بعد)، أي ما لم ينته، ما لم ينفذ بعد، خلاف ( قبل) عبر( هنا) المحيطية الجلية النظر، في رواية تتجاوز متنَها الملفوظ، من جهة النشاط السردي ودبيبه الإيحائي وتداعياته خلل عنوانين فقط، رواية تلزمنا بالتمعن محيطياً، أو في ( الوراء)، حيث أن القسم الأول، يهيَّأ أن يكون بداية، ولكن ثمة فانتازيا آثرت لنفسها أن تغلّب رومانس المكان على أمره خلاف معهوده المتداول ( من – إلى)، فهو هنا، وليس هناك ( إلى – من)، وأن توجه حركية السرد وجهة معاكسة، برغبة مقصوداً إمعاناً، ربما أيضاً، في ( تعذيب) القارىء مدنف النمطية تحديداً ، بلانمطية المقروء غالباً على الأقل، كما هو حال المنغمس في موبوء ، موجوع الواقع وتصدعاته المتنامية، دون متابعة آلمه ومؤلمه، إنها لعبة التماثل الضدية إذاً، حتى عندما يكتب على الوجه الآخر من بداية القسم الثاني( الأمراء الذين لا يلوثون رؤوسهم بالتيجان. ص 174)، مدخلاً أدبياً توقيرياً مضاداً للمعاش، ونزعاً للواقع دون أبَّهة، إذ كيف يكون أمير دون تاج؟ فيكون أمير بالمتوَّج بعلامة رفضه لما هو موسوم ومسمى، وليكون آرام اسماً على مسمى، كما تتطلب وجاهة الرومانس قيمياً.
أردت التحرك في أكثر من اتجاه، قبل التعرض للرواية، رغم أن حركتي الاستكشافية لا تقفز على الرواية، إنما تجلت من خلال قراءتها طبعاً، لأن ثمة ما يمكن أن يشوش على القارىء غيرالضليع في استدراك خطاطات، أو مدونات نصية تسبق النص الفعلي ( مقروء الأدب) كما هو معلوم، والذي يكون على بيّنة ِمفارقة ٍ، وهي أن المهم في الرواية، هو الرواية، أما المسطور أوالمحفور على الغلاف الخارجي، وحتى في الاستهلال، وكذلك المثارفي الإهداء( والإهداء في آرام، يعمق آراميته، رومانسه المكاني كثيراً في إلى: آته الست المنطلقة من مكان يعلِم بوجود المتحدث : الكاتب، إلى حيث يكون من يعنيهم بمعنى ما، وهم مصدرفرحه وترحه معاً)، فأشبه برتوش أو الهوامل التي تستحق أن تكون في عداد الشوامل، وهذا خطأ وأي خطأ، في الدراسات الأدبية النقدية الحديثة خصوصاً.
رومانس المكان: البحث عن العنوان
ليس هيثم هو الأول في الكتابة عن المكان، المكان المعلوم بالاسم وليس بحرفيات الاسم ومقوماته وتداعياته أو حتى ذاكراته وتصنيفاتها المعتقدية والأدبية كذلك، وإن كان يختلف بطريقته السردية وأسلوبية الخطاب الأدبي: الروائي( ولهذا كان تناولي لروايته هذه، مثلما تناولت أعمالاً أخرى في المنحى المكاني ذاته)، ثمة خلفيات أو نقاط استناد وجاهية وتنويرية ورائدية وتعزيزية، وربما تحريضية لروايته هذه، إذ إن ما كتبه ( أحمد نامي، حسن دريعي) عن عامودا بحريقها المكاني، وأعني حريق سينما عامودا، ريادياً ( نامي) منذ أكثر من أربعة عقود زمنية بالكردية، ودريعي بتوسع، ليكون للحريق أكثر من معنى ودلالة استقصائية في ( عامودا تحترق) قبل سنة بالعربية، وأدبياً: روائياً ( سليم بركات) في سيرتيه خصوصاً بالعربية، وقصصياً ( فواز حسين) بالكردية، ليكون الحضور العربي في الكتابة عن عامودا المكان سيرةً وتنوع أبعاد روائية وقصصية وكشكولية، ومن قبل كتاب كرد ميزة لافتة، كما في حال ( حليم يوسف) المزدوج اللغة( سوبارتو بالعربية والكردية، وخوف بلا أسنان بالكردية حديثاً)، وطائفة من آل الحسيني ، وبالتسلسل الاعتباري للكتابة(محمد عفيف ، الشيخ عفيف، عبدالطيف، توفيق..).
إثر هذه الأسماء والعناوين، يبرز هيثم حسين برواية، ربما أرادها مكانية، ليكون داخل كوكبة من كتبوا عن عاموداً، وربما لأن الوفاء للمكان يفرض طقوسيته في أهلية الكتابة واستتباعاتها الاجتماعية، وربما لأنه تلمس في ذاته ما عليه واجب القيام به، حين استجد أمرٌ ما، وهو في الحالات جميعاً، لا يكون كاتباً : روائياً إلا في المنحى الاعتباري المشروط: المعاناة المستوجبة والإبداع المتجاوب ! وهنا يمكننا البدء !
رومانس المكان: المكان المتشظي كأهليه
لا علاقة شخصية لهيثم بما يكتب، باعتباره المكان الذي يدرجه في إطار( لزوم ما يلزم)، إنها علاقة الكاتب بالمكان كذات أدبية كثيرة الأطياف والأصوات والارتباطات، لكن ذلك لا يمنع من تتبُّع هيثم الكاتب في أبَّهاء المكان، في رونق الملحوظ فيه، مثلما في مفترق طرقه الاعتبارية، وكيف أنه يكون هو ، وليس هو! فالسارد يظل أثراً من آثاره الأدبية، وهو أثرُ حمَّال لأسرار مكان، هو أمكنة: فعلية، ولكنها تتزيا أدبياً، وهنا يكون اختلاف الكتاب، في المعمعان الأدبي: الروائي والقصصي، رومانس هيثم المكان: مثُلُه الممثَّل فيها، وهي عتبة الرومانس الكبرى، مثلما هو أنه متوارياً خلف الشخوص والشاخصات والمشخصات في أوابد عامودا ومنافذها.
ثمة أهلون، معارف، أحبة، أصدقاء، خصوم، كائنات ظاهرة وأخرى دقيقة، هواميات، أشباح رؤى، تقاطعات، قصف أحياء بأوصاف وتوصيفات، تلبيس عناصربما تعيشه داخلاً، إخراج الاسم من هيئة المضمر إلى حالة العلن، تدبيرأحياء أموات، وبالمقابل تقريرأموات أحياء، مواجهات، حروب صغيرة في السر، تكتمات، استطرادات لغة من باب التشفي، من باب التمكن من اللغة، ومن باب قلب موازين قوى، للتغلب على ذات هي فرصتها الوحيدة لتقول ما يبقيها في التاريخ، منافحات، صادرات وواردات قيم، أكداس من سلبيات المعاش والمتداول من القيم، تلك التي تفرق بين أشخاص وأشخاص لهم حضورهم الأسمائي، بتعددية تهجئاتها وكاريكاتيرية الصنعة والتعمد في تشكيلها، كما هم نخبة من أهل عامودا في خفة الاسم وطراوة المتوارث باسمهم، الاسم المكسوروالجاري التصرف به، في تعددية مراميه، وأهل عامودا أدرى بذوي عاهاتهم ومجاني سلوك ولُكعيّيهم وظرفائهم وجاحظيهم ونواسييهم ومغامراتييهم وفسَّاقهم الخفيفي الظل وثقيله الذين ذاع صيتهم، خارج حدود عامودا التي باتت أكثر من عامودا( أينما ذهبت بوسعك أن تجد عامودياً، أن تلتقي به)، طرائد فعل وقول، استلهامات، مراوغات على اللغة تهسهس بمكنونها، تأميم محظورات بتسميتها… أول رومانس ( آرام) ! أوليس أرنستو ساباتو الأرجنتيني من يقول في كتابه ( الكاتب وكوابيسه) بأن ( عالم الرواية هو منطقة الرغائب، والأحلام والأوهام، عالم الواقع الذي لم يكن، أو غير المحقق، كما لوأنه خرائبه العادية، وعلى استعداد دائم للنشاط الهادف تحدي كل ما يحيطنا)؟ أو ليس الكاتب حصيلة غير متناغمة بين ما يريد وما لايريد، لهذا يستمر الصراع الداخلي والخارجي، ولا بد أن يكون الوضع كذلك مضاعفاً في البنية النفسية والذهنية للكاتب ، وإلا لما كانت الكتابة المؤثرة، الكتابة التي تعنيه ذاته، وليس من لدن سواه: تطفلاً أو شعوذة، كما هو المعهود كثيراً هنا وهناك بالاسم أو بدونه، وهذا جزء مؤثر بدوره في تفعيل سردية الرواية عبر مستقراته المتحركة !
كيف يعرّف رومانس هيثم هذا، بمكانه الروائي؟ كيف يلتقي التاريخ بالرومانس بذات الكاتب ثالوثاً مركَّباً معاً، إلى أين يريد اتجاهاً ؟
يحدّد البداية بالعودة إلى الماضي، ليبدأ بسرد حكايته، أو بصورة أكثر دقة، ليحيل حكايته إلى سردية رواية، ليكون خرّيج الحكواتي الذي من صقاته سرد أخبارتخص واقعة تاريخية، يكون فيها أكثر من شخص محوراً لها، يجمع هؤلاء بين الحقيقة التاريخية، كونهم في الأصل أناساً حقيقيين، إلا أنهم في المنحى الحكائي يتعرضون للتحريف والتوليف قليلاً أو كثيراً ( مم آلان، مثالاً)، أما في الرواية، فثمة واقعة متخيلة قبل كل شيء، ولكن ثمة ما يمكن البحث عن صور لها، والكاتب هنا، هو( أب الحكاية المستحدثة: منجبها)، متعهد النص الأدبي المبتدع من قبله، ويكون هو المرجع وليس التاريخ، كما في الحكاية، عدا عن كونه حراً طليقاً في التحرك والتوقف وإيجاد الأسماء، وتحديد أسماء أمكنة قد تكون متخيَّلة كلياً، والزمن يكون مفتوحاً، خلاف الحالة السابقة، فهي تتقدم من – إلى ( بداية ونهاية)، والرواية قد تختلف، إذ البداية قد تستحث على تحديد بداية ما لها من ناحية القراءة التأويلية، وهكذا بالنسبة للنهاية التي هي افتراضية وبحسب طاقة القارىء في استشراف حركية السرد.
وفي ( آرام) عودة إلى الوراء، أو هو وراء ما في التعريف بما يخصه، ليس كالحكواتي، وإن حاول تلبس دوره، إنما ليصيغ حكاية خاصة من عنده، وليس لقصها وهي مدونة غالباً، وبداية الرواية ليست بداية الأحداث، لأن ( هنا..ك، بعد..) تأخني بعيداً، وتبقينا رهن حالة البعدية، بينما في القسم الثاني يكون الحضور( هنا)، ثم الارتداد إلى الوراء في حالة ( قبل)، وهذا انفصال عن كينونة الحكاية، وشبهة الاختيار قائمة منطلقاً ( لا بأس أن أعود إلى القهقرى لأعتمد أسلوب المراسلة، بإرسال رسائلي، رسائل عشقي، عبر مراسيل يطمئنون، ويسجلون في دفتر الحساب ثواباً يتضاعف كل لقاء، كل إيصال، كل ذكر. ص9).
لا صلة لي بنوايا الروائي في ( لابأسـ:ه) بداية، وهي عصية على الكشف الحصري تحديداً، أوماذا كان يقصد، ما يهم هو المثار والمستثار، هو احتمال أكثر من بداية في ذهنه، لأن هذه تستوجب إمكانية أكثر من طريقة، أسلوب للانطلاق، ولكن ذلك، قد يكون باباً من أبواب استثارة الآخر، ليستكنه ماوراء هذه المفردة، وتواضعها ( لا بأس)، وربما هو تردد جرى حسمه هكذا، وفي المجمل، فإنه يشكل حالة عدم رضى كلية عن النقطة الاقتراضية في تحويل أول كلمة متخيَّلة إلى ( كنـ:ية) إيجاد أدبية ( كن هكذا، يكون)، وهوإذ يفعل ذلك، إنما يرتد إلى نفسه، إلى ما في حوذته مما يشكل المادة الرئيسة للرواية، ومن خلال اللعب اللفظي بالمفردة الواحدة وإيقاع المتكرر فيها ( المراسلة، إرسال، رسائلي، رسائل، مراسيل)، إنها في الوقت الذي تعطي انطباعاً أولياً على عدم قدرة الكاتب في تجاوز فتنة المفردة الواحدة ومدى استهوائه بها، لأنها تحصر مساحة المتخيَّل، حتى من جهة المعنى، وفي الآن عينه، تستوقفنا مقردات الحقل المعجمي بجذرها الواحد، لمكاشفة الحراك النفسي لها، قد تكون حافزاً على تلمس ماوراء هذا اللعب الأدبي، التنويع داخل الموحَّد، لأن المشتق يكون خلاف المشتق عنه صدى ً دلالياً ورنين قيمة، فنستحضر الفصدية أو التعمد، وما يعنيه التكرار أحياناً من استهداف ما لمعنى لا يتبدى إلا هكذا، وهذا لا يخفى على كل متبصر.
كل هذا العناء ينحصر في عشقه، ولعله عشق مجازي، لأن الرواية تأبى أن تُنتَسب إلى خانة روايات الغرام أو العشق بسهولة، ربما هي إيروسية، بالصورة التي اعتبرها فرويد: طاقة حياة، وليس حسباً شهوياً فقط.
يحدد براءته مما هو راهن، وهذه بداية الصدمة، بداية الأزمة الخاصة بالعاشق، الذي لا يطيق انتظاراً، وهو يكتم مكنوناً يؤلمه، إنما سريعاً يفرغ حمولته لعبئها الثقيل، إن الماضي داخل في ملكيته الاعتبارية، ولكنه حامل حبات المسبحة، ليس كل حبة تشكل صورة ملتقطة تعنيه، إنما الجوار وما هو أبعد منه، إنه يريد ما يبقيه قريباً من الذات، حيث إن العاشق يتكلم لا لأنه يحب الكلام، وإنما لأن اعتباره عاشقاً يعني تماثله للكلام الذي يعرّف به، فكأنه خلاف الذي يجسده: الشخص الذي يعشق، وكيف عاش عشقه، فيظهر هنا شخصان: الشخص المتحدث، والعاشق الذي يقيم داخله، ويبقى هنا ثالث، وهو السارد وكيف يجمع بينهما، يحدد صلته بهما، وهذه بؤرة توتر تعرّف بأهم خصيصة للرومانس كما تقدم ( لن أستغيث بالحضارة كي تنوب عن تخلفي في المراسلة، وسألعن الإيميل لأنه لن يوصل ارتعاشات قلمي…)، هذا هو كائن آخر، ليس الكاتب نفسه، لأنه لا يستغني عن الإيميل، إنما يهيب به لكي يوصل صوته عبر نصه، ولكنه اختيار ينسجم مع تجربة العاشق المأزوم ( لابأس مما أنوي عليه، فالتخلف في أساليب الحب هو الحضارة عينها، والقديم فيها أكثر تألقاً من كل جديد. ص 9).
تلك هي، وكما أظن، تجربة المصدوم، حالة العاشق الخاصة، ذاك الذي يريد لمعشوقه أن يكون أمامه، أن يستشعر حضوره في كل ما استطاع إليه سبيلاً، ولأن وجهاً رئيساً من وجوه الفشل يعود إلى الموسوم هنا، وربما لأن القديم المعلَن إيعاز إلى اشتهاء الرومانسي لما كانه، أن يعيش عذابات المعشوق، بنوع من الحب العذري، لأمر ما، ما بقي هو ودهره، و…معشوقه طبعاً، وليس تعيين القديم، إلا رجوعاً إلى البداية، إلى صعقة العشق،وليس الحب، حنيناً إلى فردوس من لم يُسمّ موضوع عشق كاملاً، طوال صفحات الرواية، وهذه خيانة ما، لوصايا العاشق( مم)، وقبله( عنترة، قيس، كثر)، فهي تدخل في خطابه، تحضر وتغيب، وهذا التكتم، يشكل منظوراً عيادياً يدفع بنا لاستجلاء مبرر التكتم على الاسم. ألأن الموضوع مختلف في أصله، أم لأنه لا يريد البوح به، ليحتفظ به سراً من أسراره الخاصة، ويكفي أن يستعين، أو يستغيث بأساليب البلاغة: الكناية والتورية والمجاز في اللغة، ليقدمها كما يريد، أما أن يسمي، أن يطلق الاسم، فخروج من حالة المجهول الذي هو معلومه، ليكون معلوماً خارج سيطرته ( لا تسألوني ما اسمه حبيبي..)، أهكذا يريد؟
أرى أن عدم تذكيرالاسم شأن من شؤون الكاتب، أو السارد الرئيس في الرواية، وتفعيل لموضوعة الرومانس.
ثمة بياض مفتوح أمامه، هو أكثر من دلالة وقيمة ( على البياض تشعر بسطوة القلم، تشعر بهيبة القلم..ص 10)، تكرار من نوع آخر، يخص القلم، ولكنه يواكب جملة التكرارات السابقة، مثلما يمهد لما سيلي.
البياض وجود عدمي، وفي الكتابة فعل إثر كمون، ولكنه عدم مستخرَج في بعض منه، لأن ثمة ما لا يُذكَر.
في النهاية يجمع ما بين نيتشه وجبران، والأخير لم يبخل في قراءة الأول وإبراز حالة التأثر به في طريقته في الكتابة، وحتى في اسظهار ما هو نيتشوي، إنما مخفف، فنيتشه صاخب وحاد، وصاعقي، بينما جبران، فأميَل إلى الهدوء، إنه ناسكي مطل على بحر عالي الموج، خلاف الأول الذي يركب أمواجه، ولعل الكاتب في متابعة عاشقه المأزوم، كان نيتشوياً كثيراً، وسرعان ما مال به خط الأفق، ليكون جبران دليله، وربما اكثر من ذلك، ربما هوتقرير ما هكذا ( تلك صورتها وهذا انتحار العاشق) ،على طريقة محمودج درويش، فهو لم يستطع فعل ماكان يروم، إذ الذهاب الروحي إلى الماضي ليقدم مقطتفات مما عاش، ليري صدماته، إنما ركوبه للموج واقتحامه للبحر الصاخب، وليكون وجوده في المقبرة، وحوله أصحابه ( مريدوه)، وإن لم يتبدوا هكذا تماماً، كما هو ذاته، لانغمار يتجربة آلمته، ورغبة أعاقته عن التقدم، وهو إذ يوجه الأنظار إلى المستقبل بقوله الجبراني الملحوظ ( أحبائي، غيروا الحاضر تستملكوا المستقبل)، ليلقي نظرة وداع على المدينة، عامودا، وينتهي باستشهاد مقلق دلالةً من جبران، ومدى اشتياقه للموت ( يا بني أمي.. نحن أبناء الكآبة..ص 240).
هنا يحدث فراق بين استحثاث الخطى على التقدم في الحياة، والاستنكاف ومن ثم الانكفاء، والخروج من الحياة، ليترك ( أحباءه) في حالة حيص بيص، إنما ليعيشوا حالتهم، حياتهم، خارج حدود المتداول، وهذا يتطلب الكثير من المواجهة الذاتية والواقعية، وإلا فإن الرواية تفقد كل معنى لها، من جهة المثار في ثناياها.
كما قلت آنفاً، هو حب من نوع مختلف، حب أهليٌّ، مكاني، زماني، ورغم كامل المحاولة للخروج من دائرة أسره، يرتد إليه، حب لا يًستنسَخ، لأنه يهني تجربة معاشة، كما تقول أوراقه، ولكنه يكاد عدم التعيين يفقده حقيقة وجوده، يشكك في أمره، بنوع من الخلط بين حب اللامسمى، وحب المكان الذي رجع إليه كعامودي، بعد غياب، ليموت، إنما بهزيمة معتبرة، وإن بدا منتصراً على ذاته، وعلى إرغراءات كثيرة خارجاً، وحتى على حبه، أو عشقه ذي المغزى، لأنه لم يطلق سراحه، بقدر ما أبقاه ( عندما رأستك سُلبت ما كنت أظنه راحةً، تلك التي كانت مخادعة مموهة . ص 10).
يبحث العاشق عن محبوبه، عن أثر من آثاره، ليحيا من خلاله، يسمي كل شيء فيه إلى درجة لافتة، ليوجه أنظارنا نحو الجسد الأنثوي الموصوف وبلاغة الجمال المتجمع أو المبثوث فيه، ليكون عبرنا، أو حيث نهتف معجبين بها، يكون مؤكداً لما يشعر، أن يبقى المحبوب بعد زواله، إنما هنا، فالوضع مختلف، إنه رومانس مشتت، يستجيب لعبث المكان الموجَّه، فما كان أظهر خداعاً، وهذا منفر، وهو إذ يودع الدنيا، ينتهي كل شيء، ولا يُسمى شيء إلا من خلاله، خلاف من تحدثنا عنهم ، إذ يحضرون بكامل طاقمهم العشقي.
الحب الموسوم، خلاف المعاش عنده، ألهذا لم يسمَّ، لأنها لا تستحق التسمية، كما هو المكان الذي تلوَّث، وكما هم الآخرون الذين الذين ظلالاً قاتمة في المكان، وعبئاً عليه؟
عن الحب يقول، كما لو أنه منظّر وليس بصاحب تجربة ( هوشهاب في الروح يسلب الأرواح راحتها، ويقلقها، يعمّدها بالأسى، يطهرها من خداع..ص11).
حديث عن الحب وفي الحب، وكأن ليس صله به، وهو صاحب التجربة، المعني بالموضوع، لا يشرك نفسه في التجربة المعلنة، يتحدث عن ( خداع) وليس عن ( الخداع)، بنوع لافت من التخصيص، وما في التخصيص من تبعيض لا يخطِىء معرَفته أحدٌ، ليس من أشخاص يمكن الاستئناس بأسمائهم، اسمه ومجازيته الجلية، لا اسم للمحبوب إلا إشارةً، من جهة التحديد، كأنه انتقام من كل هؤلاء، انتقام من المكان نفسه، ذهاب بالحب المعكوس إلى أبعد مدى قصي له ؟
لا أظن أن الحب المتحدَّث عنه، يستحق عناء المتابعة، ولا التمني بأن ثمة ما يمكن الانتظار كرمى لـه، لأن موعداً ما، سيتم، انتصاراً لقلبين، لعاشقين، خروجاً ، ولو جزئياً من أزمة العاشق، أزمة الرومانس، ولكن ذلك صعب، إلا بتفحص ما وراء الكلمات، هل الروائي يريد أن يقول: لقد توقف كل شيء عن الحياة التي تستحق تقدير تسمية؟
لا يتوقف الرومانسي عند كلماته، بقدر ما يقول ما هو فيه، والرومانسي، هو الذي تحدَّد آنفاً، إنه حمال الأسية، شخص عصي على البرء،لأنه يواجه ما لا يواجَه، يتنطع للصعاب، يختصر الكون في ذاته، يعيش أزمات، وليس أزمة واحدة، من جهة التراشق بالكلمات، وحتى التراشق بصور المكان الواحد، كونه يتشظى ويتلظى هنا،إنه مكان المنذورين للصعاب، وآخر للناطقين به، والسقوط يكون مدوياً، ولكنه سقوط في الأعلى، إن جاز التعبير، لأن ( مواطن) الرومانس ليس سلبياً، هارباً إلى الطبيعة، إنما إلى الحياة، ليعيشها ويتمعن فيه، إنه يستحضر الطبيعة بكائناتها المختلفة، ليحدد لوعته بما هو هارب منه، كما هو الرومانسي المعروف، يبكي ويستبكي، إنه محدّد لهدفه، فهو كائن تاريخي، إنما بالصور الملتقطة، لديه كم كبير ومتدفق ، من الديون المستحقة عليها، والتي يرى ضرورة واجبة في دفعها، حين يسميها، ديون الرومانس، بتسمية رمزية لهؤلاء الذين كانوا سبب وجوده، ومن داخل المكان. أوليست المثٌلٌ مؤثرة فيه، مستقطبة لكل قواه، شاغلة لها، كما في حديث السارد الرئيس عن الحب، كما في توصيفه لمن يحب، تلك التي لا يعلم أي منا كيف تكون، وأين تكون ( أنت أعظم المدن على الإطلاق. أنت كوني. أنت المدينة الأعظم رسوخاً وصموداً في هذا العالم. ص 13).
إنها إحدى اليوتوبيات الكبرى للمأخوذ بالرومانس، الموؤود حياً بها، ولكنه المفصح بها عنها.
أن تكون هي مدينة، وليس أي مدينة، وأن تكون المدينة راسخة البنيان، فهذا ضرب كبير جداً من ضروب ماوراء اليوتوبيا أحياناً، لأن لا شيء في متناول أيدينا( يدي) ليكون معبراً لاستكشاف، معرفة من تكون هذه، سوى أنها تتحرك كصورة، كهيئة، كاسم إيمائي، في مكان محصور، هو عامودا، ولكن أي عامودا،؟ أهي عامودا التي اعتبرها أعظم المدن، أم عامودا التي رسمها في ذهنه، وسخر لها كل قواه المعرفية والإبداعية، وكان ضنيناً به على غير أهله، وهويقدم مجموعة موتيفات لا تعين المستغيث في مقاربة المقصود، وحساب المردود؟
ليس إلا عامودا، فأنى اتجهت ثمة همس بها، أو تشخيص لها، وإحالة ما إليها، والكل عاموديون ، الذين يريدونها مدينة تنحو نحو الخراب ( إرم عامودا ذات العماد) راهناً، وهم غير مدركين للخراب الناخر فيها، وهي ظاهرة ملموسة عند كل هؤلاء الكتاب الذين ينتمون إليها ممن ذكرناهم، وكل يختار عامودا:ه الخاصة به، يستأصلها الصورةَ المكانية، ليركّبها الصورة الثقافية، أو الأدبية: الشعرية، القصصية ، الروائية….الخ، وكأن التداخل الموجود بين من يحب وعامودا، مقصود من أساسه، فمثلما أنه يحبها ويضن باسمها، ومثلما أنه مواطن عامودي بجدارة( ألم يرجع ليموت فيها؟)، فثمة صفحات تترى ، تضج بذاكرة مكانية تخصه، بحنين صوفي إليها، وكذلك برغبات متعود على مكان مميَّز، وثمة ما لا يسمى ( رجع ليلبي نداء خفياً يلح عليه بالرجوع.. رجع لأنه مقتنع بأن تراب عامودا- وإن كانت محاولات تلويثه مستمرة- أحن وأرفق على ابنها من حنان أوروبا. ص 29)، ورغم كل ما يحدث، وهو العائد من حيث يهرب الكثيرون إلى هناك، أو يلوذون بـ( هناك)، خلاف ( موسم الهجرة إلى الشمال)، وقبلها( عصفور من الشرق)، فالشمال موجود هنا، ولكنه الشمال الآخر، في رنته وبحته الكرديتين، كما أظن واقع حال، رغم أن الكاتب لم يجرب تجربة الرحيل ، ليستدرك ما يقول، ولكنه يقدم نموذجاً، لا يمكن زحزحته، أو رفضه، إلا بمكاشفة طريقة تكوينه، وما لديه من ثبوتيات لطلب إقامة تالية على الرحيل، وهوسؤال مفتوح ، لا يُبتُّ فيه قطعياً
( ثم يعود آرام بجمل شاعرية:
لماذا أرفض أن أرحل من عامودا..؟
لماذا تمسكني عامودا عن الرحيل عنها..؟
لماذا تقاومني روحي إذا ما فكرت بهجرها..؟ ص 99).
في الحالات كافة، يكون الصراع من جنس الموسوم رومانساً، كما هو الصراع من جنس المكان المتبدى مختلفاً عن سواه، إذ إن عامودا المكان الجغرافي المحلي التاريخي الثقافي الاجتماعي الأُني، غير قامشلو أو ديريك أو سري كانيه، رغم أنهن أخواتها في جغرافيا واحدة، ولكن لكل منها علامة مميّزة لها، كما تقول الكتابات عنها.
السارد اللافت باسمه، وهو لقب ضمناً أيضاً، يبتكر أدواته، عاموداه، الرحيل والوجوه وممانعة الرحيل، لأن الصراع يولّد قيامات مختلفة، نهايات مفترضة، في قلب الأزمة، حيث السرد لا يهدأ في أي اتجاه، لأنه في مساراته لا يلزم اتجاها، أو خطاطة، إنه يستطيع أن يبدأ من أي نقطة، ولا تنتزع الرواية، كونها سلسلة الذاكرة، والشخص السارد ( حامل المسبحة) يمكنه أن يحرك المسبحة كما يريد، كون الأحداث المسماة، تكاد تتشابه، وتتداخل، وبوسع حدث أن يخلِي الطريق لسواه، لأن لا موقع محدداً يلتزمه السرد المرسوم في الرواية.
ولعل هذا الإجراء المتَّبع لا يصلح إلا لرواية تقول أفكاراً من خلال أشخاص، بوسعهم أن يقدموها أو يؤخروها تلفظاً بها، وبوسع القارىء المعني أن يستقرىء ما وراء هذه السياسة في الكتابة، كما هي قائمة نشرة الأخبار، وكيف تتنوع وتختلف من قناة لأخرى، فهي أخبار في جملتها، ولكن تقديم خبر على آخر، يكون لـه تعليله من خلال طبيعة القناة وتقديرها للأحداث ومجريات الواقع الجاري تصويره أو تناوله.
حركية السرد في الرواية طليقة، كونها تنطلق من الذاكرة، ولأن المروي يقدم مكاناً مفتوحاً، فإن كل ما هو مسمى بطريقة ما، يناظرماهو قبله وما هو بعده، فكأن السرد لا مسار إلزامياً لـه، إن الملتزَم الوحيد به، هو عرضه لصوره المكانية، للذين يلفتون النظر بأنشطتهم، وهم متقاربون، ولأن الشكوى تطال مجملهم، فلا فرق أنَّى كان السرد
ثمة من يتخفى وراء آرام، من يقوّله، من يتحكم به، وإن بدا طليقاً، وليس في ذلك ضير، فالشخصية الأدبية محكومة بوجهة نظر مبتدعها، وهذه الشخصية ، وسواها، تقول وتفعل، أي تعيش مصيرها السردي أقوالاً وأفعالاً، كما تقدَّم، لبلورة بطاقة تعريف خاصة بها. إن ما يتحرك على الورق لا يفارق الواقع، والواقع هذا ليس هو المرئي أو المحسوس فقط، إنما هو ما هو أبعد منه، ما هو متخيَّل ومتصوَّر، أو حتى ما يُعتبَر تجريداً، لأن أقصى حدود التجريد هو أول الواقع وربما الواقع الذي لا يطَّلع عليه إلا أهلوه، وإلا لما كان مماحكة ومشادات كلام ومواجهات واستفزازات ومشاحنات وردود أفعال إزاء المدوَّن بحسب الرقعة المحسوسة والمحسوبة والجاري تطبيعها مجالاً رحباً لتفعيل السرد وحتى تأصيله، خلاف النظرة الميكانيكية المصطنعة وهي تقيم جداراً عازلاً بين المعتبر واقعاً وما ليس بواقع، حيث المثار أكثر من المداربصرياً.
إن قائمة التضمينات البلاغية التوصيفية للمعاش تتجاوز خطة السارد ورؤيته، محيلة القارىء إلى الأبعد من المسمى ، كما ( لا زلنا نُساد ونقاد بالحسد)، و( لا زال يتباهي من يقبل ايادي اللئام) أو ( لازالت الشعارات البراقة والكلمات الحماسية تلهبنا)، أو ( لا زلنا نتقازف التحيات، كما نتقاذف الشتائم القنابل ….ص 14)، حيث أول المقبوس عتبة البقية أو التالي على ما سبقه، وأي مقبوس يستحضر بقية المقبوسات وما هو كائن قائم على شاكلتها.
ولعله في سردية الاستعراضات يسعى إلى تعميق الأثر، إلى محاولة إلعاء المكان العياني، بدعوى عدم مشروعيته لأنه آيل بأهليه ممن يمارسون فيه فساداً متنوعاً ، إلى الانخساف أو التلاشي.
ثمة ذاكرة مكانية تسرد ما يوترها، ما يشرّع لكل قول لها، وهي في الهيئة تلك.
كثير من مقبوساته لا تخفي مصارحتها المباشرت، وإن كانت تتميز بخفة التلفظ المحلية، تندرج في خانة مسودَّات الواقع، الذي دفع بآرام إلى التبلبل الذاتي، والسير في كل اتجاه لاستشراء الفساد أو استفحاله، ثمة من يتعقبه، وثمة من يوقفه ليحل محله أو يتوارى فيه، فالشخصيات تلتقي في نقطة واحدة، هي نطفة الرواية حقيقة، هي التي يشتغل عليها الروائي ذاته، أي عندما يقول ( يكرر لنفسه بشيء من التأني، ثم يتلو مآسيه المتراكمة. ص 16)، فهو هنا يقوم بوظيفتين على الأقل:
مدى ارتباط الراوي الذي يختفي وراء كل سرد، وفي أي اتجاه كان.
ومدى تجلي آرام : الاسم الحامل للرواية والمستولد لبقية أحداثها، مثلما هو اللقب، واللااسم ربما، كما ذكرت سابقاً، لأنه في صميم حركية الاسم، يكون المرمَّز والمبتغى: آرام الاسم العادي، وآرام الذي حدده الروائي وما يتضمنه من دلالة تحف به، وفي المسارين المتداخلين ثمة روائي مسكون بهاجس زمكان الرواية.
إنه إذ يوقف الراوي آرام، فلكي يحاول ممارسة تنويع، تغيير بنية إيقاع السرد، الموسيقا المرافقة للنص، من خلال تتالي جملة بمفرداتها كافة، ما يومض معنىً داخل الجمل أو العبارة، وفاعلية السياق، بمكوناته من وصف وإنشاء قولي، وإشارات استفهام وتعجب، وتناول وقائع، وما أكثرها.
فعل السرد مفتوح كما هي المدينة، بأزقتها وزواريبها وشوارعها ، كما هو الداخل إليها والخارج منها، كما هي أرصفتها ومحلاتها وبيوتها، ومقبرتها ذات القيمة التاريخية المنغّصة…الخ ( لازال كرتيلو وجلَّكو وأمثالهما يزاودون علينا بانتهازيتهم. ص 17)، حيث المفردتان كرديتان ومحليتان، تشير الأولى إلى المرتزق والطفيلي، والثانية إلى دنيء النفس، المتهافت، وهو تحديد يطال من هم معروفون في الوسط العامودي، وخارجه كذلك، وطابع المباشرة الصارخة فيهما بتعاضدهما، رغم أن الروائي وضَّح ما ليس يوضَّح، طالما أنه حدد معنى كل منهما، ولكن يبدو أن التحديد جاء في سياق تداهي الذاكرة وتآلمها، كون التذكير بالاثنين يوسع فضاء الرؤية لما هو سلبي، لما يشي بمدى تخلخل المجتمع، أما ( الانتهازية) المذكورة فتأطيرللمسميين، ولعله سيقَ هكذا، لوبائية الصفة تلك.
لكن كيف نحدد علاقتنا بآرام، وهو مصدوم بعامودييه، ممن سماهم، وممن تركيهم تسميةً لفطنة القارىء، حين يذم العالم الذي قدم منه: العالم الأوربي، وهو يقول ما يصدم أيضاً ( روث عامودا أفضل من ذهبهم. ص 30)؟
مفردة الروث تحدد كل ما هو سفلي ، ما هو قميء وسقط المتاع، ولا يستحق التوقف عنده، خلاف الذهب الذي لا يحتاج من يعرّف به. هل عدنا مجدداً إلى عقدة الرومانس، إلى فاعلية المفاضلة، وإشكالية التقابل بين ما لا يمكنهما التعادل، بين عالمين بينهما أشد التناقض؟
في الحالة هذه، نسأل ، ونتساءل: ماالذي يواسي آرام، ماالذي يغريه بالمضي في سرد ما يبقيه متمسكاً بعامودا، وهو يقدمها مكاناً يوشك كلياً على التداعي؟
لكن يظهر أن كل هذا التفضيل كان في غمرة ذهابه بالمثالية بعيداً، قبل أن يصطدم، وكما قلت، فإن ثمة من يصغون إليه، من يتبعونه أيضاً، والروائي صوت من صوت عدة، قد يكون فرعاً من فروعه، ولكنه هنا ينفصل، ويؤدي دوراً مختلفاً ( يتكلم بصراحة وصدق وجرأة، يسرد لنا بعضاً من مآسيه ليزيد من جراحنا وليبكينا دهراً.. ص 33)، حيث ينوع وتيرة الحديث فيما كان متوفراً له هناك، ليبرز طابع المفارقة فيما أقبل عليه، وصدمه.
( أنا أجدك ميتاً في وطن لا يتبناك . ص 41). من الصعب الإمساك بعصا الرواية من وسطها، أو من نقطة معينة، لأن صفة الدوامة أحياناً تنطبق عليها، كون السارد الرئيس آرام، لا يهدأ ، بسبب ثقل الرهان على ما كان يجري، وليس من أمل لديه ليهدأ، أو ليأمل ( كل شيء في الكون قد يعوَّض إلا من نحب فلا ند لـه. ص 54). تلك هي موعظة حسنة، وفي سياق جمهرة الخيبات والنكبات، وهي لا تتوقف.
قطع آرام علاقته بعالمه الذي جاء منه، ولكن اختل توازنه ، صار في ( التيه والجنون. ص 56)، إذ لا يعود المرء قادراً على تأكيد استمراريته في الحياةوالعالم ، وهو في الوضعية هذه، أي يجب على المء أن يبحث بالمقفابل عن نقاط استناد الكاتب فيما قاله، وفيما أراد بثه ومزياً في الصميم، حيث النيه والجنون يتداخلان، إذ ينعطف التيه على وضعيه التعتيم في المكان، وصعوبة القدرة في تحديد الجهات، فيكون التيه نبجة لما لا يمكن الاهتداء به، بينما الجنون ينغطف على العقل الذي عُتِم عليه بدوره، وليكون الاثنان وجهين لعملةواحدة لاحقاً.
عبدو وجه من وجوه آرام، ولنقل وجه يقيني يبتغيه آرام، ويتجاوب معه، لأنه بدوره مستميل إليه، بينما هجار يكون من التجليات الكبرى للمصدوم فيه ومن خلاله، وهو بعض من رهانه القيمي، لما عرضه لاختلال التوازن : تيهاً وجنوناً، هجار اختباره الإرادي والاعتقادي إثر عودته، في أن جملة مثله المحمولة بين جتبيه ستنمو وستؤكد حيوية مبتغاه، وما كان يردده عن المكان الذي صمم على البقاء فيه، وذمه للمكان الذي قدم منه، فهجار، وهو الاسم الذي يستحضر معناه الممثَّل فيه، إذ يعني من جملة ما يعني، عدا ما بدا فيه ( البائس)، وآرام هو بائس فيما انتهى إليه، وهو الفطين والمبدع والمتوحد بالمكان جيداً، إذ يبرز ( متوحداً معه في أحلامه حيناً وراوياً مآسيه وكوابيسه حيناً آخر: ص 58).
يكون أبو كيشو، كما هي سلسلة الأسماء التي تحتفظ بها ذاكرة عامودا جيداً، من قبل عامتها وخاصتها، وخاصة خاصتها ممن يدخلونها في عالم الكتابة، أبو كيشو وجه من وجوه كثيرة، عامودي بامتياز أيضاً،وهو المتباهي بشخصيته ( أنا الكذاب الكذوب.. أنا المنافق الثرثار.. أنا المحتال المهذار.. أنا الموشوم بالدهاء الكذبي المفتضح. أنا بافي كيشو.. أنا المشهور بأكاذيبي .. فالكذب قلادتي والتلفيق وسامي . ص 80).
يتلخص فحوى المقبوس في جملة واحدة هي بدايته، وما تبقى استئناف البدء، أو تكرار البداية وتفسير وتوصيف لما تقدم، ولكنه مقبوس مهذاري، قد يقيم دعوى أدبية، في ذات النص على المتحدث هكذا، وكيف هو مستواه في النطق بما يعنيه، وليس فيه ما يبقيه شخصية هي محل تقدير، سوى أنها مقدرة من خلال التعريف بها، على الصعيد الفني، ليكون لآرام دور في التصعيد به مقاماً منن مقامات المدينة، ونقلة السرد في المكان، وتعميق طبيعة المفارقات بصورة فالقية، أي الوقوف من خلال كيشو على حافة من حافة السقوط في هاوية السلب.
كيشو، يقربنا من دون كيشوت الذي يستقطب من هم مثله وأكثر من ذلك : الأطفال، ولا أظن الاسم هنا واقعي ، إنما مجازي، من جهة القيمة، إذ هو قدوتهم ( يظل الدون كيشوت المعاصر قدوتهم حتى يكتشفوا زيفه وتلفيقه. يغضبون قليلاً ويشتمونه، ثم لا يلبثوان أن يهدؤوا ليجعلوه موضوع ضحكهم المفضل في مجالسهم. ص 85).
كم همو الدونيكشوتيون غير الجديرين بحمل اللقب هذا، إلا من باب السخرية، إذ كان الـ( دون كيشوت) الآخر قبل خمسة قرون ولادة بطل مغامراتي جر تاريخاً من المفارقات وراءه، وعرض ، حتى أنظمة كاملة، حتى وقتنا الراهن لقاطرة تهكماته سلوكاً وأقوالاً، وافتتح تاريخاً في الرواية بصفتها تاريخاً مائزاً على طريقتها، وفناً جديراً بالتصفيق القلبي لها، من خلال شهادتها الدامغة، أما دون كيشوت الكاتب، فمفاير إن إنه أجوف، يحمل الاسم اللقب، أبعد مما يكون عن طواحين الهواء، ولعل كيشو: اللقب،من باب التندر فاجعة من فواجع الرومانس، إذ إنه يحل محلياً، عندما يُستبعد التقدير ( الدون: السيد)، ويبقى ( كيشوت)، أو كيشو، مجرداً من أبهة المقام المستهجنة.
بافي كيشو، ربما هو بافي كشو Kuşşo، أي من يكذب ويدعي الصدق فيما قاله، من يدعي بطولة وهو خلافها، وليس بافي كيشو، سوى التأكيد على استنماء فعل الأباطيل والتخرصات والأوهام والمزاعم المزيفة جملةً ( إن رضي عنك سيحلم لك بحلم تسعد به وإلا فالويل لك لأنه سيهديك الكوابيس . ص 93).
طريقة توصيفه لا تكون ترويعية هنا، إنما مثيرة للضحك، لأن بافي كيشو معروف، وأهل عامودا وحدهم بداية من يعرفونه، وربما هو اسم مبتدَع هنا، ليحيل القارىء المعني إلى من يمكنه حمل صفاته واقعاً، وقد لا يكون بالصفات هذه، ولكن يبقى ثمة أثرفي الذاكرة، إن لم يكن موجوداً، يكون له حضور بمعنى ما.
كل ُّ من يتحدث عنه الراوي، ينتهي دوره، أو يترتب أمره في صف من التصورات المكانية، ويستمد مغزى وجوده، ويتوضح أمرع كلما أوغل الراوي، أو تحرك السرد بالمزيد من التقدم في تقديم المشهديات اللافتة.
كما في الحديث عن ظاهرة اللاتؤاخذنية، أي من يرتكب إثماً أو خطأ بقصد ما ويقول للآخر ( لا تؤاخذني)، حيث جاء من خلال تركيب مبتدع ( أثناء استفحال وتفشي الظاهرة اللاتؤاخذنية،…ص 110)، وهي ظاهرة تستدعي كل من تم ذكرهم سلباً وإيجاباً ، فهم الكورس المتعدد الأوجه، وتبرز مفردتان بالمعنى ذاته تقريباً، ( استفحال وتفشي)، كمال لو أن الروائي أ{اد التعبير عما يريد، بالمزيد من التكرار لتعزيز ميكانيزم المعنى المثار.
هكذا الوضع من آرام في دخوله السجن وأجوائه المنفرة، فكأن عامودا الداخل والخارج سواء بسواء ( حتى في السجن إن يدخل الغني فهو المدعوم . ص 118)، وهكذا أيضاً يكون الأحدب مؤثراً في آرام، بضعاً من مآسي المكان وأهليه ( يغرق آرام في سرده أوهام الأحدب ولا يدري أين يمضي به هذيانه أو أين تقوده قدماه. ص 140).
داخل هذا المنحى الفجائعي تضيق به دائرة الحياة، فاجعته بموت مؤذن الجامع، بصوته الشجي المألوف تالياً ( ص 142)، وظهور ذوي الأصوات ( المعلبة . ص 143).
هذا المضي قدماً في سرد تاريخ عامودا، هو المكان الذي اجتذبه، مثلما هو المكان الذي استثاره، حيث ليس من خاف متبقٍّ في عامودا، ورغم ذلك، فإن رومانس المكان يبقيه إلى جانب المكان المطهَّر في دخيلته، لأنه لا يمكنه التخلي عنها، وإلا لانتهى أمره ، وصفّي تاريخياً، وربما لا يقبل ذلك على نفسه ( ينظر إلى المدينة فيراها كما كانت ، يراها كما ستكون، يراها عامودا . عامودا التي كانت، عامودا التي تبقى. عامودا..ص171). ما المثار هنا؟ وكيف يكون آرام هو هو، وكأن كل شيء على حاله؟. هل تقبل ذهنية التحكيم في الرواية هذ المخرج فنياً؟
لا أظن شخص الرومانس بمفارق للمكان ، بالسهولة التي يمكن تصورها، رغم أن كل ما يحدث له من صدامات، يعود إليه، كون المكان علامة وجوده الكبرى، وفي الحالة هذه، يعز عليه فراقه، مثلما يصعب عليه البقاء فيه كأي كان، طالما أنه يسلبه كل ما يبقيه ما هو عليه، ويعرضه لما لا يرغب، وقد حدث هذا ( التيه والجنون مثلاً)، وها هو من جديد يصر على البقاء داخل المكان: المدينة : الرحم، وإلا فإن من شأن الجاري أن يغصف بكل أسس المفكَّر فيه، وما هو متخيَّل وجرى تسطيره، ورغم ذلك، فإن ثمة إقلاقاً في فعل التلقي.
لا يبقي الروائي في باكورة أعماله ما يواسي آرامه الذي يتداخل معه، وأحياناً يبرز الراوي الذي يكون أكثر قرباً منه، وهو يتكلم بضمير المتكلم المفرد، وهو يشير إليه لسان حاله، بطريقة أخرى. هذا التعلق الرحمي يشدد على عجز فيه بالذات، وهو عجز، أجدني مدفوعاً إلى تسميته بـ( عقدة الرومانس)، وهي العقدة التي يكون أسها وأساسها بذرة الرومانس التي تكبر في أرض غير صالحة لها، ولكنها رحم البذرة، وبالتالي لا تعود البذرة ، وقد استحالت نبتاً على الأقل، وهي تظهر كينونتها الحية إلا من خلالها، أن تكون في حالة الدفاع عن وجودها، وهي متمايزة، مثلما تحاول تأكيد ارتباطها بأرض ليست هي التي أوجدتها، إنما وجِدت فيها، وإلا لانتفت مثاليتها الموجِدة بها.
كائن الرومانس، كما يظهر، وكما تقول وقائع التاريخ، بدءاً من النصوص المعتبرَة ميثولوجية ، إلى النصوص التي تجلت أدبية متنوعة ، تقبل بالشر، ليس لرغبتها فيه، وإنما لأنها موجودة به، وليس – أيضاً- كونها تتعشقه، بقدر ما إنه لا ينفصل عن كينونة الكائن، باعتباره أكثر من الوجه الآخر: الداخلي ، الخارجي، الفعلي له، من خلال تعدد أنشطته، ولهذا لا فصل بين الأدب والشر، وكيف يمارس الشرحضوره الكبير في الأدب، كما لو أنه موهوبه، البعد العميق لما هو إيروتيكي، أقول ذلك وأنا أتذكر هنا كتاب جورج باتاي ( الأدب والشر)، وعلائق كل منهما بالآخر، لتكون عامودا أرض الكائن الموسوم عنواناً، ليس باعتبارها أرض الآثام، إنما أرض المحفزات على مقاومة الشرن من خلال الخير بالذات، ولو عبر الشعور بهزيمة ما.
وصولاً إلى البداية
في بداية القسم الأول، وهو المعتبر الثاني، كما يقول سياق الرواية، يكون آرام المتكلم، الراوي الذي أراده الكاتب، ليقرر في النهاية ما يقرره كل مدنف قيم مثلى، بينما في بداية القسم الثاني، المعتبرالأول، يكون آرام داخلاً في خطاب الروائي، يكون الحديث عنه، وليس هو المتحدث، يتكرر ما قيل سابقاً، إنما بصيغة خطابية أخرى، وذلك عبر الكتابة، وبصفة أخرى تخص الكائن المراهَن عليه : آرام، ولكن بالإشارة إليه وهو مقيم بعيداً عنا ( سيجلس آرام، نزيل الأوجاع المصابرة، بمفرده، وسيحاول أن يكتب ما كان يراه ويعيشه من وجهة نظر المراقب لما كان يحدث، وسيلزم نفسه قدر جهده الحياد. ص 175).
يتنوع آرام هنا، مثلما يتنوع السارد الذي يتحرك على عتبة الروائي مباشرة، فهو الذي يكون، وهو الذي سيكون، وهو الذي سينفصل عن آرام المعاني والمفجوع بمثله، كما لو أن شيئاً لم يحدث، كما لو أن الذي جرى كان مع سواه، وأرى أن ثمة مأزقاً فنياً، يصعب التغلب عليه، بسبب الهيئة التي لُبّس بها آرام، أي ناحية الحياد، على الأقل، لأن ليس مطلوباً منه أن يصرح بذلك، ولا هو مطالب ذاته، في أن بقدم آرامـ:ه بالطريقة هذه، فهوليس موضوع اختبار لـه كما يتصور، وإنما داخل في صميم الواقع، ويكفيه جمالياً أو فنياً، أنه أخرجه من دائرة من دوائر الملمات أو المفارقات التي أقضت مضجعه، ليترك موضوع التقويم ، أو تحديد الموقع للقارىء، لتحديد الحيادية المذكورة.
المكابرة تغدو هنا مصابرة، وبدقة أكثر : المكابرة، وهي الخصلة المعانقة لآرام، تلك التي تكون بداية، ولا تكون مصابرة إلا لأن ثمة ما لا يمكن مقاومته، وفي الحالتين نجد أو نتلمس أو نتحسس تلفاً تدريجياً للذات المبتدعة روائياً.1- من جهة المكابرة، حيث إنها لا تتشكل هكذا، إلا لأن الذات الفعلية دون هذه الخصلة! إن شخص المكابر حمال أوجاع، كبريائي، داعم ذاته بذاته، موسّع ذات رغم ضيق الواسع وتفاهة المعاش، ولكن المثل المحتضنة تكون علامته وقيامته معاً، وهنا بؤرة من بؤر الصراع الكبرى في حركية السرد، سرد الرومانس.
2- وليست المصابرة إلا تيمناً بالمكابرة، قيمة مترتبة على وعي بالمعاش، مفجوع به، وهي بدورها تتحدد في صميم مأزق المعيش الذاتي، والإشكالية المعقدة للشخصية التي تريد المضي إلى النهاية ولو بإعلان نهايتها.
يغدو الكاتب طرفاً في الرواية، وربما يظهر متماهياً معه المرة هذه، وهو يستظهر الحقيقة التي يكون عليها آرام، كما لو أنه موضوع تجربة عملية فعلاً، ليقلل من مأثوره الأدبي، وخصوصاً حين يحدد ما يجب على القارىء ذاته التصرف بموجبه لمعرفة من يكون آرام، وبحذر ( يحاول أولاً ، إقناعك بأنه يتحتم عليك ألآ تستبسط قراءته. ثم يقولون لك ما يجب أن تقوله عند قراءتك لأي كتاب: أيعقل أن تقرأ المكتوب أو تمر عليه سريعاً وقد أهلك كاتبه نفسه وأعصر فكره في سبيل انتاج نتاجه ..؟! . ص 179).
هي مشكلة أخرى من مشكلات التعامل مع النص الأدبي، وكيفية تقويمه من جهة الكتابة أو القراءة. هيثم يمارس تخريجاً لطريقة كتابة روايته، من خلال صوت الرواي الذي يومىء إليه، ظناً منه أن يحقق بغيته الأدبية أكثر، محذراً قارئه، كما ذكرت، ما عليه القيام به، وهو في الحالة هذه، يدفع به إلى قرب باب المحظور، وربما تحطيمه، أن يكون خلاف ما هو موجَّه إليه، أو مخاطَب به. هل هذا ما يريد، وليس ما يسمي ظاهرياً؟
أتذكر هنا غوته في ( آلام فرتر)، وما شكله فرتر لغوته، أشدد على حيوية العلاقة بين كل من الكاتب ونموذجه المبتدع، وأتلمس في مفردة ( النتاج) مثلاً تجاوباً مع الشخصية الميكانيكية أكثر، كون النتاج، رغم ذيوعه مفهوماً، أقرب إلى ما هو صنعي، ما هو قوالبي، وثمة مصمم وثمة منفّذ وثمة عامل منتج، والكاتب خلاف هؤلاء تحديداً، ولو الأمر كذلك، لحتَّم علينا النظر في حركية روايته من منظور السوق : سلعياً، وهي ليست كذلك طبعاً، كما أنه يدفع إلى البحث عن وجوه مماثلة لكائناته التي لا تعود ورقية، كائنات متخيله، والوضع خلاف هذا التبسيط الذي لا يريده الروائي، لأن ما كتبه يعود إليه ولا يستنسخ، أي ينتَج ويعاد انتاجه، فالمبتدَع ما ليس بمنتَج.
هل انحاز الكاتب إلى المفاهيم المتداولة أو السائدة، معتمداً عليها في كتابة نصه الروائي، كما في مفردة ( الانتاج)، ومن باب المجاز، وكأن الكاتب هو ذاته منتج أفكار مثلما هو منتج أعمال أدبية وخلافها؟
كيفما كان التخريج، فإنني أعتبر في الحالة هذه، مفردة ( الانتاج)، تؤطرما هو إبداعي لدى الكاتب .
ما يحاول آرام الانهمام به، وكما يتصرف الراوي، هو عودة أخرى إلى ما كان، وبدءاً من الصفحة ( 184)، في تحديد سلبيات كثيرة، ولهذا شددت على أن مستقرات السرد في الرواية في الجهات كافة، وأن السرد هذا لا وجهة محددة لـه، إنه يتقدم ويتأخر ويتراجع ويتحرك ميمنة وميسرة، وتكون قائمة الكائنات التي تدخل مجال النص الروائي قابلة للتوسع، وربما أمكن إضافة المزيد! وعندما أقول : المزيد، فإن أفق الرواية يبدو مفتوحاً، وهي رواية أفكار وتصورات معاً، والحركة حرة من لدن الروائي، فلا مسقط محدداً لما يمكن التوقف عنده.
يسعى الروائي إلى مجاراة ممن سبقوه ، وهو يحاول تضمين روايته فصولاً تخص عامودا، وهو يمتح من ذاكرتها المفتوحة تلك، ونحن بصدد رومانس المكان، وهو يتحدث عن طقوسية كرة القدم مثلاً، وكيف يجتمع فريقان، وتبدأ المفارقات ( انظر صفحة 216، وما بعد)، ليقلق قارئه هنا، إذ إن الطرافة الموجودة، في اوقت الذي تهدىء من روع القارىء هذا، فإنها تمارس خرقاً، ولو طفيفاً، لأدبية الرومانس،، لا بل لما هو معهود في آرامـ:ه، أم إن الملعب بذاته مجال مفتوح للنظر، وبعد رئيس من أبعاد رومانس المكان نفسه، وما يعنيه الملعب من استعراضيات قوة، وتجلي قامات ومقامات وبنى شخصية تجلو للعيان في إثرها!؟
هؤلاء الذين يحتدون، يتواجهون، يتنازعون، هم أنفسهم من يبدون بمثل هذه البساطة، وحتى هشاشة الشخصية من الداخل أحياناً، كما في تقديم مشهد يخص المتفرجين على اللاعبين، وكيف يعلقون على من لا يستطيع تسديد الكرة لتسجيل هدف، وبصيغة لا يدرك معناها ومغزاها إ عامودي أو من هو قريب منه:
(ها هو.. هاهو هواري غشيمووو… لو
هاهو هواري غشيمووولوولو. ص 219).
ماهو مذكور لا يترجم من جهة العنصر الفونيتيكي أو نكهة المحلية التي تجمع بين العربية المكرَّدة والكردية التي استحالت عربية أو ما يرادف ذلك، لأن ثمة زخم الدال في ثراء المدلول على أرض الواقع، وثمة من يذم اللاعب بشكل ملطف، وثمة من يريد استغاثته والتدخل لأن الوضع لا يطاق، تعبيراً عن خصوصية ذات جمعية هنا.
آرام يبقي عامودا في داخله، ويعلم أنصاره، أتباعه بما هو مصمم عليه، وهؤلاء يلتحقون به، على المقبرة وهم في هيئة الموتى لا بسي أكفان، مأخوذين بفاجعته، بقدوتهم الذي لم يتزوج، لأنه لم يجد مبرراً للزواج، كما لو أن طقس كربلائياً حياً هنا، إن النساء الباخوسيات، يتحولن هنا أيضاً إلى رجال عاموديين، وبدلاً من ( التهام) أو ( تمزيق) رمزهم ، ليبقوه داخلهم، يكون العويل ( بدأ أنصاره ومشيعوه يعولون، وينتحبون، ويشقون الجيوب، ويعفرون بالتراب أجسامهم ورؤوسهم التي يهيلون عليها كل ذلك التراب . ص 229).
ثمة مفاجأة في تصوير مشهد كهذا، إذ إن المدى الواسع لحدود الرواية، والتقليل من ذكر الحوارات والمشاهد المجالسية( بخصوص ” حوارييه” المجهولين)، يبقي القارىء على مسافة معلومة من هذه النهاية الصدامية بالطريقة هذه، حيث انكسار ما هو أكثر من الأحلام، إنما ما يبعد المرء عما يجرده من مروءته، فآرام يخاطبهم، كما هو الكاريزمي العتيد ( أنا راحل إلى الأبدية بشموخ عالم ضائع وانكسار مكابر وروح محتضرة، تشمموا رائحة المجهول ، تحسسوا عبق الرحيل ولا ترحلوا . ص 232).
يبدو آرام وكأنه يهذي حقيقةً، في تقديمه وتأخيره ، وهو يودع أصحابه، كما يودع الدنيا( إن آمالنا الآثمة تسمم دماءنا، فطهروا دماءكم وأرواحكم. ص 235)، وهو في كل ذلك يعِد بما صار مستحيلاً ( سأبني سور عامودا العظيم الذي تمناه أحد أهرامات عامودا. وكل منهم في مقامه هرم . ص 236).
تنتهي الرواية بالنصيحة الجبرانية، وآرام يشمل مدينته عامودا متألماً لها، وغير مدركة لما هي فيه، ليبدأ القارىء بقراءة الكاتب من الداخل، مما سطره وترك الباب مشرعاً، لتبدأ الرواية من جهة قرائه القريبين من المكان ومن هم بعيدون عنه، وكيف سعى إلى بناء روايته، وأي مسار قيمي التزمه بداية ونهاية.
ثمة حالات تشكٍّ كثيرة في الرواية، حيث أضرم الكاتب النار في آرامـ:ه كثيراً، تفريغاً لشحنات، أو تطهيراً لـه من أدران المكان والذين لوثوه، ليكون ضحية بمعنى، وهو لم يُقتَل أو يختفي تحديداً، بقدر ما بقي داخل المقبرة، في محيطها، وكأنه يفضل عالم الأموات على عالم الأحياء، وهو كذلك، وكأنه ينذر عامودييه بأن قيامة طوفان وشيكة، وأن الذي لم يسمه أكثر مما سماه في مجمل صفحات روايته، وهو أيضاً كذلك، كما أرى .
لا تخلو الرواية من سادية مشددة على محرك الرواية الرئيس، سادية مبعثها الوقائع، محتوى العمل الفني كونه رومانساً، كما تحدث عن ذلك نورثروب فراي، وهي رواية تدخل التاريخ، وإن لم تكن تاريخاً، إنها تاريخ وقائع يمكن التوقف عندها، كما رأينا مع غراهام هو، مثلما هي تاريخ صلات شخصية لمن وبما حولها ، كما رأينا مع روجر هينكل، لتكون السادية، بما فيها من عنف متحوَّل وموجه إلى الآخر، وما يكونه الاخر حين يتقبل ذلك، ويتحمل الأذى، ليكون سادي ذات، مازوشيَّها، ممتصاً عذابات الآخرين، ولعله القارىء نفسه من يتعرض لهذه الموجة من المعاناة حين يتوقف عند الرواية هذه، رواية رومانس المكان، والتي مهما كان الموقف منها، كما أرى، تندرج في سلسلة روايات المكان، ولا تغادره ، خصوصاً وأن الذين كتبوا عن عامودا قبل هيثم حسين، لم يبخلوا بدورهم في إظهار حدة المفارقات، ونشيد الموت المتعدد الدلالات، مثلما هو نشيد الحياة في صميم عامودا.
لا سعادة فعلية لمن يتبصر حقيقة المكان، لعامودا النموذج! أليست ارواية ( آرام) تراهن على هذه المقولة من ألفها إلى يائها؟