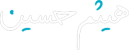هيثم حسين: استحضار القارئ لحظة الكتابة يعني استحضار الرقيب
خلود الفلاح
طرابلس- في أعماله الروائية يغوص هيثم حسين في مجتمعات تعاني من القهر حيث المهمشون كجزء من هذا البناء، يشغله التجريب في العمل بوصفه باعثا على منح متعة الاكتشاف. يكتب هيثم حسين الرواية ويهتم بالكتابة عنها، ذلك ان الرواية تمنحه السكينة والقلق في ذات الوقت وهنا يكمن عشقه، وبمناسبة صدور روايته الجديدة “إبرة الرعب” كان لنا هذا الحوار.
في روايته “إبرة الرعب” عدة محاور للسرد، من القمع السياسي والاجتماعي والتطرف وغير ذلك من المحاور.. هذه المستويات المتعددة للسرد هل تسمح بقراءتها من خلال أكثر من رؤية، يقول حسين في هذا الشأن: “القمع يلقي بظلاله الكثيرة وتداعياته المتشعّبة المؤثّرة على مختلف جوانب الحياة، والرواية بحكم مقاربتها للحياة والتقاطها لمشهديات مختلفة ووقائع وأحداث كثيرة بدورها، تقدّم معالجاتها بعد التقاط الأفكار وتسريبها في سياقات متماشية مع الاشتغال الروائيّ، ذلك أنّ إقحام محور ما لسبب أو آخر، يثقل كاهل العمل، كأن يكون من باب المتاجرة بالغرابة أو الجنس أو قضايا تلفت الانتباه وتجذب الأنظار.مازحني بعض الأصدقاء معلّقين على روايتي “إبرة الرعب” بأنّه كان عليّ أن أشير إلى أنّها موجهة لمن تتجاوز أعمارهم الـ25 سنة، وبالغ آخرون قائلين: بل 35 سنة، في إشارة منهم إلى جرأة معالجة بعض الموضوعات التي تصنّف في خانة الخطوط الحمراء. حقيقة لم يكن هاجسي المبالغة في توصيف حالات جنسيّة أو تحريض القارئ من باب الغرابة والجرأة؛ التي يمكن الاختلاف على فحواها ومعناها واصطلاحاتها”.
ويضيف هيثم حسين قائلا: “حاولت أن يكون الجنس موظّفا في سياقه، واقتضى الحدث الروائيّ تفصيلا في بعض اللقطات، وهي على كلّ حال تعكس حالة الانهيار المعمّمة والخراب المجتاح في حقبة معيّنة وفي ظروف محدّدة.ومن هنا تختلف الرؤى في التعاطي مع الرواية ومحاورها، فقد يراها أحدهم بطريقة سطحيّة تسطيحيّة ومن باب التبسيط بأنّها تخدش “حساسيّة” القرّاء، وكأنّ القرّاء كائنات لا حول لها ولا قوّة، تحتاج دوما رعاية خاصّة ومسايرة ومداهنة ومداراة، في حين يرى آخرون أنّ روايتي برغم أنّها قد تتبدّى استفزازيّة إلّا أنّها تشتمل على كثير ممّا يمكن الخوض فيه وكشف النقاب عنه ووضعه تحت سلطة القارئ بغية التشخيص والمعالجة والاكتشاف.
الحياة هي المختبر الواقعي الذي تستلهَم منه الروايات وتعود إليه بنوع من المحاكاة الأدبية حسب وجهة نظر الروائي
كلّ رواية جمر دائم الالتهاب والاستعار بين دفّتي كتاب مغلق، ما إن تباشر قراءتها حتّى تتأجّج النيران وتظلّ في تأجّجها مرتحلة عبر الزمن، قد يخفت تأثيرها بالتقادم، وقد يزداد أيضا. لا أحد يمكن أن يخمّن خطّ النهاية لسباق الرواية مع الزمن”.
الحنين إلى سوريا
في زمن تعيش فيه سوريا لحظات عصيبة، جراء الحرب الدائرة هناك، وبعد خروجه منها، يشعر هيثم حسين إلى بحنين يشدّه إلى تلك الأرض الشامخة، يقول: “أشعر بالحنين إلى سوريا المستقبل، سوريا التي أحلم بها، سوريا التي استشهد في سبيلها مئات الآلاف من السوريين، سوريا التي غنّى لها إبراهيم القاشوش وضحّى في سبيلها حمزة الخطيب وغيره من أطفالها الذين هم أيقونات مقدّسة. أحنّ إلى سوريا أنعم فيها مع السوريين بهناء وسلام، لا سوريا التي عانيت فيها القهر والتعسف والظلم والإجرام على أيدي النظام الذي يواظب على تدميرها منذ قرابة ثلاث سنوات، وما يزال يستكمل تدميرها برعاية وتواطؤ دوليين. أحنّ إلى سوريا لجميع أبنائها وبجميع أبنائها، لا سوريا المزرعة الموقوفة لفئة بعينها، المرهونة لرغباتها المرَضيّة”.
متعة الخلق
في كتابه “الرواية والحياة” حاول هيثم حسين تفكيك العلاقة بين الرواية كفنّ إبداعي وعدد من القضايا الحياتية.. وتبدو الرواية من وجهة نظره قادرة على التغلغل في تفاصيل الحياة وأحيانا نجد صورنا منعكسة في تلك الأحداث الروائية، يقول حسين في هذا الصدد: “الواقع يغتني بتفاصيل يعجز أيّ إنسان عن التقاطها أو تدوينها، والروائيّ ينتقي منها ما يخدم فكرته ويتوافق مع تصوّره لعوالمه وتخطيطه لسير الأحداث في تلك العوالم، فكلّ رواية هي غابة من المفارقات، والتغلغل فيها انكباب على بهجة التفاصيل المكمّلة للمشهد الحياتيّ، الصانعة حياة روائيّة تتّكئ على الواقع وتبحر في الخيال”.
ويضيف قائلا: “أمّا إن كانت التفاصيل تصنع رواية ناجحة أم لا؟، فهذا يعود إلى كيفيّة اشتغال الروائيّ وتوظيفها في الرواية وفق ما تفترضه التطوّرات وما توجبه السياقات ومسارات الأحداث، بعيدا عن أن تكون هدفا لذاتها وبذاتها.
هناك مَن يدعو إلى تخفّف الرواية من حمولة التفاصيل، وترك المجال للقارئ بنوع من الإشراك في اللعبة الروائيّة، وتقديم شرارات له تكفل بإثارة التشويق لديه، ثمّ تتراجع لتركه يكمل التفاصيل مالئا بها ما بين السطور، مرتحلا بخياله مع الروائيّ، متخيّلا حبكات ربّما لم ترد في ذهن الروائيّ أساسا. ربّما تعتمد الرواية الجديدة على لغة مكثّفة، تقتصد في الكلام وتنفتح على الدلالات والصور، تقدّم مشاهد متناثرة من لوحات متسلسلة، وتترك حرّيّة التركيب للقارئ المتمثّل روح النصّ وأصالته”.
هيثم حسين يكتب الرواية ويهتم بالكتابة عن الرواية، ولديه كتابان في هذا المجال هما “الرواية والحياة” و”الرواية بين التلغيم والتلغيز”، فماذا تمنحه الرواية؟ عن هذا السؤال يجيب حسين بقوله: “تمنحني الرواية السكينة بقدر ما تثير قلقي. علاقتي معها مشوبة بالعشق والتوجّس. هي عالم بذاته، الغرق فيها ممتع لكنّها تظلّ تربطني بخيوط لا مرئيّة إلى كلّ التفاصيل. أعيش فيها ومعها، ولا أستطيع تجاوز تأثّري بها. كلّ قراءة لرواية ما فيها من الاكتشاف والتجديد والإثارة.
الرواية تأخذ بيدي في مقارباتي النقديّة وقراءاتي، كما أنّ النقد ينير لي سبل الرواية ودهاليزها الخفيّة ويجعلني أكتشف متعة الخلق وبهجة الخرافة والأسطورة والجنون. في روايته “آرام” قدم هيثم حسين شخصيات مركبة ومنها شخصية “آرام”، وهذا ربما يعطي الدليل على أنه من هموم الروائي البحث في الحياة بمجرياتها اليومية لإنجاز عمل ما، في هذا الشأن يقول حسين: “الحياة هي المختبر الواقعيّ الذي تستلهَم منه الروايات وتعود إليه بنوع من المحاكاة الأدبيّة من وجهة نظر الروائيّ.
أحاول الابتعاد عن الجوانب التسجيليّة والتقريريّة في الرواية، وأسعى للنبش في ما وراء الفعل والصورة والكلمة. ما في الصدور يهمّني أكثر من الضجيج الذي يفتعَل، أي ما يقال هو محور القول في كثير من الأحيان. اليوميّ المتراكم يخلق بحراً من التفاصيل، وما على الروائيّ إلّا التنقيب في ذاك البحر والغوص فيه لاستخراج درره وتقديمها بحلل وصياغات إبداعيّة”.
القارئ والكتابة
هناك من يذهب إلى أن المشاكل التي تمرّ بها منطقتنا العربية أسلوب جديد في الكتابة الروائية، عن هذه المسألة يقول هيثم حسين: “لاشكّ أنّ الأحداث الكبرى في تاريخ الشعوب تزلزل بناها المختلفة، تخلق لديها نوعا جديدا من التفكير، تثور على النمط السائد، تزعزع اليقينيّات والثوابت التي حرص المستبدّون على تكريسها وتجذيرها في نفوس الناس. المتغيّرات تخلق أمواجا واندفاعات كبيرة وحكايات أكثر من أن تُحصى، البراعة لا/ لن تكمن في التقاط الحكاية، بل تكمن في كيفيّة حكايتها. أي «كيف تحكي؟» بالتوازي مع «ماذا تحكي»..؟ هو سؤال الكيفيّة والماهيّة المتجدّد الذي ينتزع الاعتراف والإعجاب تاليا ويبحث عن الأسلوب الجديد ويمهّد له”.
وعن علاقة هيثم حسين بالقارئ، يقول: “في قرارة كلّ كاتب قارئ قابع في ظلّ الكلمة، وربّما يحصيها على طريقته الخاصّة. أيّ قارئ هو ذاك..؟ كيف أتصوّره..؟ كيف أتعاطى معه..؟ هل هو أناي الممرآة..؟ تجلّيات كثيرة تتلاشى/ تتخفّى في لحظة انبثاق الكلمة والمباشرة بالكتابة. لحظة الكتابة لا تشغلني إلّا الكتابة، لأنّني لا أستطيع التفكير بالقارئ وأنا أكتب. استحضار القارئ في حالة الكتابة يعني من جانب ما استحضار الرقيب، وإن كان القارئ يشير إلى الآخر المتلقّي في تلك اللحظة، إلّا أنّ تخيّل ردود أفعاله واستجاباته ومراعاته أو مسايرته أو استدراجه لا يندرج في مسعاي وعملي أثناء الكتابة، ذلك أنّ الانشغال عن الكتابة بأيّ شيء يضعفها ويبديها للقارئ منشغلة بهموم بعيدة عن جوهر الكتابة”.
عن صحيفة العرب اللندنية