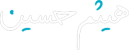فلنكتب المسلسلات بدلا من الروايات
أبو بكر العيادي
يعتمد كثير من الروائيين اليوم على الحبكة الدرامية وأساليب السرد المتعددة في أعمالهم، ويولون الأسلوب والبناء اهتماما بالغا فيما يغفلون الاهتمام باللغة التي لا يرون فيها أكثر من وسيلة، بينما جوهر الأدب في نهاية المطاف هو اللغة.
كثيرة هي الأعمال الروائية التي لا تعير اللغة اهتماما مخصوصا، وتكتفي منها بما يسرد حدثا أو يصف موضعا أو يصور وضعية أو ينبئ عن حال نفسية أو اجتماعية بأيسر زاد، حتى غدت الأساليب النثرية الفنية متشابهة حد التماثل، تكاد لا تختلف عن الأساليب النثرية المعتادة التي تقوم أساسا على التبليغ، والحال أن الخطاب الأدبي يختلف اختلافا بيّنا عن الخطابين العلمي والصحافي.
فالخطاب العلمي يقدم للقارئ حلا علميا أو نظريا لمشكلة علمية بالأساس، فيصف ويفسر أو يتكهن بظاهرة، معتمدًا الموضوعية التامة، وعادة ما يتوجه إلى طالب علم أو عالم. وهو إذ يلتزم بقواعد اللغة، فإنه يتوخى البساطة والوضوح، ويجعل الدقة والتناسق والصرامة مقدمة على جمالية الأسلوب، إذ يتجنب المرادفات والاستعارات والمجازات والبلاغة، ولا يتنكب عن التكرار إذا دعت الحاجة لتأكيد مصطلح أو نظرية أو عملية تطبيقية.
أما الخطاب الصحافي فإنه يقوم على إخبار القارئ بما يجد، وحثه على التفكير في ما يُطرح عليه، وغالبا ما يقدم أحداثا ووقائع وقضايا مجتمعية أو سياسية، فيحللها لوضعها في إطارها، وينقدها إن اقتضى الأمر، لأن من شروطه التوسلَ بالموضوعية في نقل الخبر ونقدَه أيضا. هو أيضا يلتزم بقواعد اللغة، ويستعمل أسلوبا بسيطا مباشرا، ويفضل الوضوح والإيجاز على أناقة اللغة وجمالية الأسلوب. قد يستعمل الاستعارات لتجميل النص ولكن دون أن يغفل عن أولوية وضوح الفكرة، ووضعها فوق كل اعتبار. وقد يلجأ، علاوة على القاموس المعتاد، إلى استخدام ألفاظ تقنية إذا كان الموضوع المطروق يستدعي ذلك.
والخطابان يستندان إلى الواقع، إلى ما يتبدى لهما أنه حقيقة، قد تقبل الجدل من منظور هذا الجنس أو ذاك، بخطاب نقدي من جنسهما، بينما الخطاب الأدبي خيالٌ كله، حتى وإن انطلق من الواقع، وغايته شد الانتباه، والإمتاع، والتحفيز على التفكير والتأمل، والتأثير في القارئ بشكل غير مباشر، والسمو بذوقه وأفكاره وتغيير نظرته إلى العالم. خطاب يصف واقعا ما من خلال انطباعاتِ ساردٍ أو شخصيةٍ أو بطلٍ وحالاته النفسية، في فترة ما وثقافة ما، ويحاول تقديم وجهة نظر تتسم بالجدة والطرافة.
النص الأدبي يلتزم بقواعد اللغة بوصفه مرجعًا لغويا لكنه يخرج عن المألوف في سعيه إلى الخلق والابتكار
ولئن كان يلتزم بقواعد اللغة التزاما لا غنى عنه بوصفه مرجعًا لغويا في حد ذاته، فإنه في سعيه إلى الخلق والابتكار، يميل إلى الجمل والتراكيب الخارجة عن المألوف، والأساليب الجافة الخالية من التقريرية والمباشرة، فيتخير زادا لغويا ثريا، وتعابير مبتكرة، لأن مطمحه جمالي بالدرجة الأولى، وغايته جعل النص أكثر جمالية، وأكثر قابلية للقراءة.
ولا يعني ذلك أن لغة الرواية ينبغي أن تكون قاموسية مرصعة بحوشي الكلام والألفاظ الجزْلة والتعابير المهجورة، وإنما أن تحافظ على ما يجعل الرواية نصا أدبيا، ينأى بنفسه عما يسميه الفرنسيون phébus أي الزخرف، وزَخْرَفَ الكلام لغةً معناه حَسنَهُ بِأَلْفاظٍ ظاهِرُها جَميلٌ وَباطِنُها كُلهُ تَمْويهٌ وَكَذِب؛ وكذلك galimatias أي الكلام الملتبس الغامض الذي لا يُفهم معناه، ويبدو التكلف واضحا في طريقة رصف ألفاظه وصوغ معانيها.
ومن ثَم فإن نعت النصوص التي تحافظ على أدبية النص الروائي بكونها زخرفًا لفظيا وتكلسًا بلاغيا إنما هو من قبيل كلمة حق يراد بها باطل. فلئن كان التقعر والتصنع واستظهار المقدرة اللغوية من المسائل الممجوجة في الرواية، فإن استعمال اللغة المتداولة في درجتها الصفر، أي تلك التي تقنع بأبسط بنية وأقرب لفظ، مستقبَحٌ مستهجَن هو الآخر.

يتبدى الزخرف الذي لا يقدم ولا يؤخر في رواية “روائح المدينة” لحسين الواد على سبيل المثال، حيث يبدو الراوي مولعا بالتنقيب في المعاجم والقواميس، فيقوده انبهاره باللغة إلى استعمال ألفاظ بالغة القدم، ويغرف من حوشي الألفاظ مفردات لا تناسب العصر مثل الثلط (الغائط) والإرقال (سرعة سير الإبل) والتجميش (المغازلة).
بل إن وقوعه في إغرائها عادة ما يجره إلى المبالغة في رصف النعوت رصفًا يثقل الخطاب ولا يغنيه، فتأتي في شكل سبائك قد تبلغ أحيانا ثمانية عشر نعتا (بصرف النظر عن وظيفتها النحوية وهي هنا خبر لناسخ) كقوله “لكن روائح الحبس كانت حادةً قاسيةً ضاغطة متعسفة قاهرة ظالمة ثقيلة خانقة زفرة دفرة نتنة وسخة ندية لزجة دامعة باكية حارقة كاوية”. وحتى عشرين (وهي هنا في موضع حال) كقوله “روائحُ تنبعث… مرحةً أسيانة غضوبا قطوبا لعوبا طروبا مندفعة محتدمة متأودة مكسالا عبوسا مغناجا ضحوكا متمردة ثائرة جذلى متعجرفة معربدة مزغردة نشوى”.
أما الكلام الملتبس فنجده في أغلب الروايات العربية التي تدعي التجريب، وهي من الكثرة ما يفيض عن هذه المقالة، ولو اكتفينا ببعضها لأغضبنا خلقًا غير قليل. وغني عن القول إن كلا المصطلحين آنفي الذكر يستعمل لوصف لغة تسعى إلى التكلف والتعقيد دون أدنى فائدة.
ولكن، هل يبلغ النص الروائي أدبيته إذا ما نفض عنه الزخرف والبديع والتعقيد المصطنع؟
ذلك ما تسعى إليه الرواية التي تكتب اليوم بنجاحات متفاوتة، بيد أنها، في عمومها، تغرف من القاموس المتداول في وسائل الإعلام، وفي المعيش اليومي، وتقنع بما يعن من الألفاظ والتعابير لأول وهلة، دون جهد يذكر، مَثلُها كمَثَلِ بائسٍ يأكل ما حضر ويلبس ما ستر. وأصحاب هذا الرأي يقدمون مسوغات كثيرة، منها مخاطبة القارئ بما يفهم، أي أن نتبسط مع القارئ ونراعي مستواه بدل السمو به؛ ومنها الاستعاضة عن اللغة بالحبكة الدرامية المشوقة، ولمَ لا نكتب مسلسلات عندئذ بدل الروايات؛ ومنها أيضا التعبير عن العصر بلغة العصر، ما يعني أن انحدار لغة العصر وتهجينها بالدخيل العامي أو الأجنبي سيؤديان بالضرورة إلى تدهور لغة الرواية، ولم لا الاستعاضة عنها بالعامية.
وينسى أصحاب هذا الرأي أن اللغة مقوم أساس من مقومات العمل السردي، يفوق من حيث الأهمية كل العناصر الفنية الأخرى التي تنبني عليها الرواية، لأن اللغة هي التي تنهض بها، كما ينهض الأساس بمعمار فني، فالأَسَاسُ لغةً هو أَصلُ كل شيءٍ ومَبدَأُه.
عن صحيفة العرب اللندنية