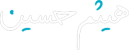عشبة الرواية وفردوس الكتابة «قراءة أولية في رواية: عشبة ضارّة في الفردوس» لهيثم حسين
إبراهيم محمود
من مثالب المنفى بأشكاله المختلفة، أنه قد يستهلك المرء أو ينهيه تدريجياً، ومن مناقبه بالمقابل، أنه قد يمنح أويهِبُ المنفي قدرات تمكّنه من بناء عالم يستجيب لإرادته في وسط يقيم فيه مع آخرين. أحسب أن كاتبنا وروائينا الكردي السوري هيثم حسين من الصنف الثاني، والشاهد هو أنه مذ حل في منفاه الاختياري لندن، منذ عدة سنوات، وهو يفعّل في منفاه هذا ما يجعله أهلاً للإقامة في الحياة، وأن يوسّع حدود صلاته بالعالم الخارجي، ودون أن تغفل روحه عن البيت الذي ولد فيه وترعرع وتعلَّم وتكلم وعُمّد كاتباً في “عامودا “، وروايته الأخيرة ” عشبة ضارة في الفردوس، دار ميارة، القيروان، تونس2017 “، ليست رواية منفى حرفياً، لكنها تستمد منه مقومات وجودها. إذ إن استعادة المكان الأول وتأهيله تخيُّلاً ليكون على مقاس شخوصه، وكيف يلقمهم حركات، مشاعر، أحاسيس، مخاوف، متناقضات وتصورات: عامودا، بصورة رئيسة، خميرة روحه في الكتابة وتحدي الغربة، لا تعدو أن تكون ترويضاً لقسوة المنفى، ومصادقة معها، وإلزام المنفى هذا لأن يعترف به أبعد من كونه هامشياً، أبعد من كونه موسوماً بصفة المنفي.
متابع كتابات هيثم حسين في الصحافة والمجلات ومن خلال الكتب، رغم أن تجربته محدودة في عمرها الزمني” قرابة خمسة عشر عاماً، لكنها تفصح عن حيويتها وحضور ذات تسابق عمرها “، يدرك أن هناك قابلية نفسية لإدارة دفة السرد في الكتابة الروائية، كما هي إدارة الفكرة في مقال نقدي التوجه، أو ذي طابع صحفي. اللغة تشهد بهذه الكفاءة التعبيرية.
ولعله في روايته الأخيرة ينطلق من خراب العالم، إنما العالم الذي يشملنا وهو ضمناً، في ضوء الأحداث الفظيعة التي شهدتها المنطقة وسوريا بالذات، في وضع قياماتي كارثي يأتي على الحرث والنسل في جهات شتى. هذا الخراب/ اليباب على مستوى الفن له تصريف آخر جهة الدلالة والمخفي داخله: خراب مرئي، وأرهب منه: باطني.
خطوط للقراءة
تتحرك الرواية على خطين ملحوظين يمكن الربط بينهما، خط الجسد النسائي وكيفية صعوده مستدرجاً الآخرين إليه، والانغماس في الشهوات، كما لو أن وراء هذا الانغماس الشهوي ميتات تترى، وساعة إعلان نهاية المجتمع بأكثر من معنىً، وكون السرد يأتي بلسان امرأة إجمالاً، وتلك مغامرة كبرى، وخطيرة، تحتاج إلى تحرّ بنيوي ومن جهات شتى أيضاً، بغية مساءلة ذات الكاتب عينها، ومغزى هذا الإسناد في الدور السردي إلى امرأة مطعونة في جسدها بالكامل، أليست البداية والنهاية تعرَفان بها؟، ومن خلال عناوين ذات دلالة وسريعة أحياناً، وتعيش سخونة، هي سخونة المعيش اليومي والمتخيل والمدوَّن ( لا أريد أن ينتشلني أحد من غرقي! )، ثم ( هذه هي لحظة الانعتاق المطلقة التي ظللتُ أرنو إليها، أستمتع بهذا الغرق، بهذه العتمة الجديدة، أحظى بحرية ما فتئت أحلم بها..)، وليأتي دور الوصف( أتخيل الأسماء تنهش جسدي…ص 7)، وما يجعل الغرق معبراً، أو برزخاً مؤدياً إلى نهاية ربما تكون تجسيداً للبداية وحتى معطوفة عليها، طالما أنها بمثل هذه الوضعية المقرَّرة (أنا منجونة التي لم يعرف لها عمر محدد، الغارقة في عتماتها، الهاربة من حكاية إلى أخرى… أقف على عتبة متاهة أخرى. ص 217 ).
تنتهي الرواية ولا تنتهي الدراية، بقدر ما تتابع مغامرة الدال المعرفي، كما أن ابتداء البداية يشد محرّك البحث المعرفي نقدياً إلى هذا الندب والجلٍد الذاتيين بداية، وعلامتهما الاعتبارية، لنكون إزاء محرك مساءلة مرتبط بالأخير.ربما ثمة كلام كثير يقال هنا، حول هذا التوصيف ومدى تداخله مع معايشة مازوشية، وما فيها من لفت الأنظار، وما في بنية الوصف من ذاكرة معممة بالمكابدات، وما يترتب عليها من إشهار دقيق لحيثياتها أو مشاهداتها، كما في صلات القربى الدلالية بين ” الغرق ” و” العتمة ” حيث العتمة ذاتها غرق ما، والسعي إلى التخلص من الجسد” ولا أدري ما إذا كان الجسد أم الجسم هو الأكثر إيفاء بالمعنى في هذا المقام أم لا “، وفي النهاية ” المتاهة ” فهي ذاتها موصولة بغرق من نوع أفق غير محدد، لتكون ” العشبة الضارة ” تجسيداً حرفياً ” لهذا المنحدر الحياتي الشديد الوعورة.الخط الآخر والذي يبدو للوهلة الأولى هو الآخر ماسكاً بزمام أشد الأمور خطورة في حياة المرء والحياة، خط الذكور الذين يتحركون في مساحات جغرافية متعددة الحدود، لا أبالك، تصدم الوعي المحلي أو المؤطر، وتستدعي قوى نفسية أخرى لتكون قادرة على التقاط علاماته، وسيمياء الخراب من نوع آخر، لعل الضابط الأمني ” المساعد الأول “، تلك الرتبة الفاصلة بين أعلى الكتف، وأسفلها لما دون ” الضباط ” جدير بأن يفصح عن عقدته، عن حسده ولؤمه، وبطشه من باب التأكيد على أنه لا يقل نفوذ أثر، وتفعيل رعب وبلبلة عمن هم أعلى منه مقاماً، أو عمّن سبقوه ” محمد طلب هلال ” السيء الصيت، وتحويل البلدة إلى مسرح لمغامراته المروعة وهو يجعل عالي كل شيء سافله، وفي جغرافيا كردية بجلاء، وتلك لعبة روائية لافتة، لكنها للمتتبع لا تخفي نقاط تحركاتها التي يختزن الروائي دقائقها: بلدته.
الأحمر الهالك
وربما ما بين السفور الجنسي والسفور الأمني تداخل بليغ، حيث إن الإيروس” حبا الحياة ” جرّاء ابتذاله، أو الاستغراق فيه أو الفشل في قراءة لغته، يمضي بصاحبه إلى التدميري ” الثاناتوس “، كعقاب طبيعي محتَّم أو انتقام من ذات الجسد، أي حيث لم يعد الجنس محكوماً باسمه وإنما باسم خارجي مؤثّر فيه، وأن الأمن باعتباره مطلباً حياتياً وضرورة يومية، إن حرّف عن مداره لم يعد إلا نقيض محتواه، كما هو مبتغى هذا المعلق بين رتبة الضابط وصف ضابط. ولا بد أن ما خطط له هذا العنصر الأمني المخابراتي خرّيج ذهنية تخريبية وهو مسكون بهوس الانتقام (حرص المساعد الأول على الانتقام من الماضي وشخصياته، لأنه لا يستطيع نسيان الإهانة التي لحقته. ص19).
ولأنه حاول إدارة المحرك الجنسي في مجونه أو طابعه العهري إلى جانب صلات أخرى تنخر في خارطة البلد عموماً والبلدة نموذجاً، وهي كردية إجمالاً، نجد أنه من المخرج الأمني نفسي يتشكل مدخل انتقامي فيه، جهة أولاده الفاشلين، إنما ما هو أكثر رعباً( اغتصاب دبّوزك لابن المساعد الأول وابنته .ص 65 )، عدا عمّا هو مشاع لاأخلاقي حول رئيس الفرع نفسه، وما في ذلك من إحكام لطوق الموت البطيء والمرعب.وفي كل خط ثمة تفرعات، وهي تخترق حدوداً، وتستدعي أشخاصاً جدداً، سوى أن مسار الرواية يتحرك نحو الهاوية، وهو في الأساس ينطلق من الهاوية: هاوية جغرافية: برّية، بحرية، هاوية نفسية بركامها التاريخي الثقيل الوطء، وهاوية ثقافية ملغومة جرّاء انعدام التكيف بين المعنيين بمجتمع الرواية، وهاوية سياسية بأبعادها الاجتماعية والتربوية…الخ. سوى أن المقروء في أوراق المساعد الأول وبعيني الساردة، وما تكونه كذلك: إضاءة لذهنية الكرد وتصارعاتهم، وكيف يتربص بها الأمني ، ومن ذلك ( عناد الكردي هو الاستثمار الرابح بالنسبة إليه. ص 75)، وضمناً كيفية الدفع بالذين تضعف أنفسهم من الكرد بصور شتى أمام أولي الأمن، وخصوصاً المساعد الأول في ممارسات سلوكيات تخرج الناس عن إطار المعتاد، كما في عمليات تهريب وصلاته بالضابط التركي في التهريب” ص 58 “.
هذا الانحلال الجسدي، الذهني كان معبَراً إلى انهيار النظام الذي أسس له، على مستوى النساء بالذات، وهن عموماً معطوبات من الداخل، كما لو أن نتف الشعر من أجسامهن وفي المناطق الحساسة إشارة إلى أنهن منذورات قهراً لنزوات في مجتمع مجتمع بقانونها، كما تعلِمنا الساردة بداية عن أمها ” ص 8 “. ثمة : الوردة، جيمي، جميلة، الأم وبنتاها…الخ، وبالمقابل، وبصورة رئيسة، ثمة الاسم المخالف لمعناه : بريندار، فَيْزي، خصوصاً.واقع مفتوح على أهوال وتصدعات، والبلد يمشي نحو الكارثة، والروائي يستحضر وقائع مؤرَّخ لها: حديث عن الانتفاضة والتي تخص ” آذار 2004 “، وإسقاط صنم الأب ” ص 99 “، ودلالة ذلك تالياً، من خلال التذكير بإسقاط صنم صدام حسين ” ص 153 “.هيثم حسين لا يبدي تعاطفاً، أو بالكاد مع أي شخصية، شعوراً منه، وهو مندمج بالحدث إلى حد التماهي، ليس بمعنى فقدان بوصلة ” قيادة ” السرد، وإنما بمعنى معايشة هذه الشخصيات وهي مشوهة أو شوّهت من الداخل، كيف يحدث هذا وهو نفسه، استناداً إلى السارد الأنثوي عماماً، إلى منجونة” الاسم البادي الغرابة “، مشروخ طولاً وعرضاً وعمقاً، وربما الروائي نفسه مأهول بهذه التصدعات، على وقع الصدام مع الجاري، وقع ما لا يتوقَّع، سوى أنه على مستوى إقامة علاقاته مع هذه الشخصيات، وضمناً ذاته المؤلفة، محكّم السيطرة بشكل لافت، وهذا الجانب بالذات، وهو رئيس أو مفصلي من وجهة نظري في روايته، جدير بالمكاشفة الدلالية.
مكاشفة مؤثرات الرواية
هل هذا يعني أن جميع نقاط روايته ومن خلال شخصياته مجتمعة متساوية البعد عن نقطة تكون مركز حضوره موزعاً فيها؟ لا أظن أن العملية حسابية، كما ينبغي، إنما ما تكون كل شخصية مخوَّلة للقيام به، أو لتمثيله رمزياً، وهي في كثرتها، إلى درجة أن مفهوم البطولة، بالمعنى الحرفي، يكاد ينعدم، والسرد نفسه، وإن كان موصولاً بالسارد الأول،، يظهر منفلقاً في أكثر من جهة.ثمة ما يعين قارئه أحياناً في استشراف حراك روايته، والمتمثل في القول السارد ( الذاكرة ميدان حرّيتي، أعيد ترتيب العالم حسب رغبتي. ص 23 “، هل ذلك إيذان بإعدام الآتي، بإشهار عزاء الحاضر؟حين يكون الماضي موفّراً أماناً وإن كان فيه خيبات، فإنه مطلوب ومنشود أكثر مقارنة بحاضر لا يطمَأن إليه، ومستقبل ذي مثلث برمودي، في المتخوَّف منه كثيراً.العناوين الفرعية تمثّل عتبات منخفضة لمنحدرات شديدة الانزلاق لشخصياته. عناوين مخيفة، مستقاة من أفلام رعب، أو ما يشبه ذلك، وهي بأداءاتها الصادمة، والمجموع” 34 ” عنواناً، هو فهرس النص الروائي، بدءاً من ” ترويض الشياطين “، مروراً بـ” الخنجر-عيون وبنادق-نظرية النسب-الرجل البصّاق-بزّق ولزّق- كلاب الصيد- تحطيم الصنم- ارفعني ولو على خازوق..”، وانتهاء بـ” عبث “، وكل عنوان داخل في رباط الآخر، يلونه ويتلون به، وما في هذا التنويع، وضمن مسافات شديد التقارب من إيحاء وإغراء بالمتابعة وعنف المحفّز على مساءلة النهاية روائياً.
من إضاءة ما تقدم، حيث الذاكرة فاعلة في رسم خطوط الرواية البيانية، وإنما في مواجهة واقع لا يحتَمل، يمكن التذكير بالتنوع الموسوم في السرد (ستمضي ذواتي المتعددة في متاهات الواقع وأنفاق الخيال. ص 33 )، وما هو توضيحي في سيرورة السرد وإعلام أثره ( لا أبحث عن بدايات محدودة ونهايات معلومة. ص 41).
الرواية متخمة بأثقال التاريخ، كوابيسه، أدرانه، لصوصه، عصاته، تقاته، أطهاره بصورة ما، قواه النفاثة، حطامه ومقامه، وخصوصاً في الجانب السياسي الممرر في السياق الفني: الروائي، بدءاً من التذكير بالمساعد الأول، وفظائعه أو ” طبخاته ” المسمومة في الناس، في أهل البلدة: الكرد، وسموم أوراقه، وتداعيات النظام السياسي وعقيدته العروبية العلامة، وردود الأفعال منها:تلويث العلم الوطني بالروث والطين. ص87- كانت سياسة دمج العروبة بالإسلام قد نشطت وتفعلت في المناطق الكردية.ص 101- إسقاط صنم حافظ الأسد..ص 153…الخ.
ولكي نكون أكثر قرباً من مداميك الرواية، وإمكان ضبطها، بغية تيسير عملية القراءة بأقل قدر ممكن من الجهد والوقت، فذلك يتبدى في حاملة السرد الأولى، حيث العنوان الرئيس يشير إليها، ومتتاليات الإحالات الموزعة بين الواقع والخيال وما هو مهجَّن منهما، وما يقبل التأويل في سياقات شتى.
إطلالات
لنتوقف عند مسمى ” العشبة “، وهي نكرة ودلالتها:العشبة رغم ضآلة حجمها، إمكان وطئها، جزها، اجتثاثها…الخ، تبقى قوية، عنيدة، كما لو أن حركتها في الاتجاهات كافة نابعة من استراتيجية نباتية طبيعية قارّة فيها. فالعشب أكثر من أي نبات آخر يصمد في وجه الرياح، وسريع الاستنبات والعودة السريعة إلى الاستقامة ” لنتذكر أوراق العشب، لوالت ويتمان العظيم!”. والعشب من إحدى علامات النص الكبرى الأكثر تهيئة لإبقائه وتزكيته للاستمرارية. سوى أن العشب تنوع وتعدد. وثمة عشبة تبحث عن موقعها. تموقِع الساردة مكانتها في النص، وهي تميط اللثام عن واقع متقيح. نصادف ما هو مألوف جهة القيمة الممنوحة للمرأة ( اعتاد الجميع حضوري كقطعة أثاث تكمّل ديكور المكان لا غير. ص 10).
لكن ثمة توزنات، واستقصاءات وربما محاكمات نصية وتعريات بلسان الساردة بوصفها عشبة، وهي محط سؤال عن حقيقة كونها ضارة، وما يفتح محضر اسمها على أكثر من وجهة اعتبارية: -لا أبحث لنفسي عن إجابة لسؤال ما إذا كنت عشبة ضارة في فردوس مخادع. ص 10.- أنا عشبة ضارة، ولكن أين فردوسهم المتخيل؟. ص 12 .لعبتها المفضلة ببناء الحكايات، لمواجهة العالم بها، وسيلة للاستمرار، وسط الجحيم الذي يظنه كل نزيل من نزلائه فردوساً أسطورياً، ليس الآخر فيه سوى عشبة ضارة ينبغي اجتثاثها وتطهير فردوسه منها.14.” وتلك أكبر تعرية لواقع، ومكاشفة أواقع المقيمين فيه، حيث إنها ليست استثناء بكونها عشبة ضارة “.-لم أكن وحدي تلك العشبة الضارة، كل منهم كان بدوره عشبة ضارة في فردوس الآخر المتوهم. ص 14 .-أنا عشبة ضارة، أن شيطان يستحيل ترويضي. ص 59. بالطريقة هذه تكون قد أفصحت عن بنيتها، وإدانتها لمن حولها، كما لو أن غرقها، متاهاتها حصيلة معاناتها مع الآخرين وأنها بعينيها ” المفتَّحتين ” أكثر من كونها رائية ودارية بحراك الأعمق وظلماتها.
أحسب أن عشبة هيثم حسين حتى الآن عشبة سارة بتقنيتها في فردوس الكتابة. إنما ثمة ما يمكن التوقف عنده، ليس من منطلق الإخلال بفكرة الرواية، وإنما مكاشفتها في نقاط أخرى، قد تكون خافية على قرّاء بعيدين عن الجغرافيا البيئية التي كانت ملهمة لنصها: تظهر البلدة التي يمحور فيها هيثم حسين جل أحداثها، يانوراميتها الفنية، وينطلق منها، بلدته بالذات، عامودا، خميرة عجينة روايته، كما كانت خميرة أعمال أخرى لها” روايته الأولى: آرام…،2006، والتالية: رهائن الخطيئة، 2009 “، ولكم كنت أتمنى أن يرِد اسمها في عِداد الأسماء المهداة إليها روايته: بداية أو نهاية على الأقل، فهي ” سوما ” ذاكرته. إنْ من جهة جل الأحداث وما يزيد عليها تعبيراً عن صنعة الرواية وجانب التوليف فيها، وإن من جهة جل الأسماء التي يعلَم بأمرها “أهل” عامودا، والمحيطون بها، وهي كثيرة، فلا اسم يسلم من التحوير أو ” العمودة” إن جاز التعبير، جهة إضفاء صفة عاموداوية عليه:توفيقو-كفجال- بهو- كلوكي- ناديكا- نمرودو- دبوزك-فيَزي- حسكو- موروي- شفرشكو-رسيلو- عبدكي- شمالو…الخ.
ربما تذكرنا إلى جانب مغامرات جنسية، ولو من نوع آخر في سيرة الصبا لسليم بركات “هات النفير على آخره”، وما جاء به عبدالحليم يوسف في روايته “سوبارتو”، أي من جهة التناص المحلي. في إشارة الروائي إلى ” بريندار ” وتعلقه بالمطرب ابراهيم تاتليس، ربما كان الأجدر به ألا يشير إلى الأصل ” التركي “، فهو ليس تركي الأصل، أو أصله هذا غير مؤكد.
بالنسبة لإسناد السرد إلى صوت امرأة غالباً، أو صوت أنثوي، وصوته يتخفى في ثنايا هذا الصوت وعن بعد، ربما يطرَح هنا أكثر من سؤال عن مدى نجاعة هذا المسلك الفني، وتحديداً في نطاق الكم الوافر من الدراسات ذات الصلة بجنسانية السرد، والبعد النسوي وما بعده أو أصول ” الجندر” في الرواية التي يكتبها ذكر بالذات، ومصداقية التوجه والمبتغى، ليس لأن ذلك مرفوض بالتأكيد، وإنما كون إجراء كهذا يفتح في الحال أكثر من باب لأكثر من سؤال حول مسوّغ هذا المسلك، وهل يستطيع الروائي تأكيد تمثيل الصوت الأنثوي، واعتباره أهلاً لأن يناط به أمر إدارة سرد بمثل هذه الخطورة في رواية “جهنمية” إن جاز الوصف ؟ماذا لو كان السرد محالاً إلى صوت يعنيه يصل بكل شخصيات الرواية؟
أي متعة فنية استشعرها الروائي في اختياره هذا التوجه؟ هل من إحالة مضمرة إلى وازع نفسي، يخص الروائي نفسه، ربما يتمثل في أنه أراد من هذا الإجراء تجسيد قيمة إنسانية نسوية الطابع، وفاء لدَين رمزي؟ وليس لأن هناك تباهياً بقدرة الذكر داخله على فَلَاحه في تمثيل أخطر الخطابات السردية، ومنها الأنثوية في الواجهة؟
ذلك يبقي باب الحوار مفتوحاً، كما بقي باب الرواية مفتوحاً لأكثر من تفسير وتأويل، ويبقى الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله بنوع من الجزم، وهو: بين عامودا هيثم حسين وادنبرة البريطانية التي يقيم فيها آلاف الأميال، سوى أن ” عشبة ” روايته ” تقول بأنه لما يزل يتنقل في أحياء عامودا، أكثر من غيرها، مسامراً عقلاءها ومجانينها، نساءها ورجالها، أخيارها وأشرارها، على مدار الساعة!
دهوك، في 21-8/2017