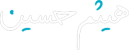عشبةٌ ضارّةٌ في الفردوس – العنوان، الميْتَاسَرد، وخِطاب السُّلطة
في سياقِ مَنْفاهَا اللسانيِّ تنزعُ أو تحاولُ “الرِّوايةُ الكرديّةُ” المكتوبةُ بالعربيةِ [في ظلّ إبادةٍ ممنهجةٍ للغةِ الكرديةِ بمنع أيّ حضور لها في المؤسساتِ التعليميةِ ناهيكَ عن أي اعترافٍ بها في الدّسْتور السُّوري] تنزع هذه الرواية إلى إحْدَاثِ اختلافها أسلوباً، ثيماتٍ، زمكاناً، استراتيجياتٍ وقوىً نصيّةً. وفي هذا الإطار تتنزّلُ روايةُ “عشبةٌ ضارّةٌ في الفردوس، 2018″ للرِّوائيّ هيثم حسين من خلال اتخاذ مكانٍ ما في شمال شرقي سوريا بؤرةً مكانيةً لأحداثٍ روائيةٍ ضاريةٍ إذ يمكن التمثيلُ لها تصريحاً ببلدة (عامودا) ذاتها كما تشيرُ الإيماءات النَّصيَّة وذلك قبل أن ينتقل الرِّوائيُّ إلى اختلاق بؤرةٍ مكانيةٍ أُخرى تناظرُهَا في ضواحي العَاصمة دمشق(قرية المنارة) يشغلها كردٌ حاصرتْهم موجاتُ الجفاف في “الجزيرة” فألقتهم هناك دون دليلٍ رفقةَ نازحين سوريين من الجولان، لتنتهي الرِّوايةُ بزجّ بؤرةٍ مكانيةٍ ثالثةٍ متخيّلة (البحر ــ أوروبا) تلميحاً بوصفها إمكانيةً مكانيةً فحسبُ مع حركة الثّقبِ الأسودِ “للثّورة” واتساعها ومن ثمّ ابتلاعها لسوريا وذلك بعد أن أممتها الجماعاتُ الإسلاميّةُ لتحقيق أحلامها السَّرمدية. في هذا المتصلِ الزمكانيّ الثلاثيّ تحيطُ الرّوايةُ بعوالم الكرد وسرديتهم عبر فواعلَ سردية تَنْهضُ من قاع المجتمع (بريندار، عائلة موروي، خربو، وردة، بهو، جميلة (جيمي)،…إلخ) وسردية السُّلطة البعثية وأساليبها المرعبة في التّحكّم بالمنطقةِ الكُرديةِ من خلالِ عاملٍ سرديّ (المساعد الأول) وبرامجه السّردية المتعددة لمحاصرة البلدة الكردية الشهيرة بعد أحداث 2004. تنتقلُ الرّوايةُ إلى ضواحي دمشق في القسم الثاني من السَّردِ حيثُ البؤرةُ المكانيةُ الثانية(المنارة/المغارة)، لتديرَ الحَدَثَ من خلال برامج عائلتي موروي ومأمون الكردي فترتفعُ أسهمهُمَا لكنْ سُرعانَ ما ينهارُ كلُّ شيء. هنا، هناك وهناك الأبعد تتولّى “منجونة”، الشائهة، المسْخ لعبةَ السّردِ إذ تبدؤها بعتمةٍ وتنتهي بعتمةِ أشدّ وبين العَتَمَتَينِ عَتَمَةٌ…لكنَّ هذه العتمةَ التي ترسمُهَا منجونةٌ السَّاردة لا تعدم وميضَ”علاماتٍ” في ممراتِ القراءةِ إلى النّصِّ.
I ــ العنوان والفهرس:
ليس من الألفة بمكان أن يواجهَ القارىءُ روايةً مفهرسةً، فالرّوايةُ كجنسٍ أدبيّ يقوّضُ مفهومَ الفهرسةِ بذاتهِ من حيثُ إنَّ الرّوايةَ انفساحُ السَّردِ وانتشارُ الكلام وانتثارُه ومغامرةٌ لاتُحدُّ من الاستيلاءِ على البَيَاضِ.ومن هنا إذ تتموضعُ الفهرسةُ أو تتجذّرُ إنما تواجهُ إرادةَ السّرد وامبرياليتَهُ في فيضانِهِ الفيزيائيّ ليس بوصفها انتظاماً تنتظمُ فيه عناوينُ فصولُ الكتابِ (فالرّوايةُ أيضاً يجري عَنْوَنةُ فصولِهَا في كثير من الأحيان) ولكنها إذ تَقْدُمُ إلى صُنفٍ سرديّ فإنها للجم السَّردِ عن الاتساع وتقييدهِ في الوقت ذاته، إنها مفاجأةٌ غير سارّة للسّرد الرّوائي. ومن هنا فالفهرسةُ تسويرٌ للكلام وتنظيمٌ له، ترويضٌ لرغبتهِ الجارفةِ في الاستحواذ والدفع بالنّص من حُوْشِيتهِ إلى ألفنةٍ عبر نقاطِ عَلّامٍ ــ عناوين تشيرُ إليهِ كَمَا لو أنّ الفهرسَ ــ وَهو كَذلكَ بالطّبعِ ــ دليلٌ يقودُ القارىءَ في تضاريسَ النَّصِّ ليتموضعَ في مناطقَ استراتيجيةٍ تمهيداً للتّصَادُم مَعَهُ[حول الفهرس ينظر إبراهيم محمود: كتابة الفهرس، ضفة ثالثة].
وهكذا بين رغبةٍ توسعيةٍ في الامتداد وأُخرى كابحة (عبر الفهرس) تقدّمُ الرّواية ــ قيدَ القراءة ذاتها للتلقي. وبذلك يخيّلُ للمرءِ أَنّهُ إزاء مجموعةٍ قصصيةٍ لكنّ الوحدةَ السّرديةَ بأحداثها وفواعلها وأمكنتِها وأزمنتِها التي تشدُّ الفصولَ إليها شدّاً مُحكماً تحبطُ هذا التخيّلّ الأوليّ، ليجد القارىءُ ذاته إزاءَ استراتيجيةٍ طريفة في البَنْيَنَةِ الرّوائية: فهرس بسردٍ وليس سردٌ بفهرس، سردٌ لايتواني عن الامتدادِ وإغواءِ البياض وكأن الفهرسةَ لم تكن سوى خديعةٍ لاستدارج القارىءِ إلى الكونِ السّردي.
من جهةٍ أُخرى يلجأ الرِّوائيُّ إلى مفاجأةٍ أُخرى على صعيد التّسمية حين يدمغُ غلاف الرّواية بتسميةٍ صادمةٍ”عشبةٌ ضارة في الفردوس”، وهذه التَّسمية التي تتكىءُ إليها الرّواية في إنجاز هويتها تقطعُ أيَّ صلةٍ مع الفهرس انتماءً على الصَّعيدِ اللفظيِّ، أي أنها تشردُ عن الفهرسةِ وتأبى الخضوع لها، فلا أثر لها في قائمةِ الفَهْرس في محاولة لتأكيد القاعدة: السّردُ سردٌ من غير فهرسةٍ لكنها كفجوةٍ، وهنا وجه الغرابةُ، تبتلع الفهرسَ ذاته دون رحمةٍ فكيف ينفسحُ العنوانُ تأويلياً في ذاتهِ أولاً وفي علاقتهِ مع النّصِ ثانياً ثمَّ مع الفهرس ثالثاً؟
إنّ الحكمة التقويضية تنظر إلى اللغة على أنها تسكنُ على صدع من “عدم اليقين”، غيرُ مستقرةٍ وغامضةٌ ومعانيها متضاربةٌ، وبناء على ذلك فكلمةُ “الفردوس” الواردة في التّسميةِ [عشبةٌ ضارّةٌ في الفردوس] تستدعي في العربيةِ إلى فضاء القراءة أصنافاً متنوعةً من المكان: ” البستان، الوادي الخصيب، المكان الذي تكثر فيه الكروم، جنة من جنات الآخرة” بل إنَّ “الفِردوس المفقود” هي ملحمةٌ شعريةٌ للشَّاعر الإنكليزي جون ملتون. كما أنَّ الكلمة ذاتها تستدعي تناصاً لغوياً فهي معرّبة وتنحدرُ من اليونانية التي أخذتها بدورها من اللغاتِ الإيرانيةِ بمعنى “الحديقة”. كذلك تُتخذ الكلمةُ اسماً علماً للأنثى (فردوس) تعبيراً عن مضاهاة بين المكان والكائن في وجه الشبه(الجمال)، فتأتي العشبةُ الضارّةُ لِتُخَلْخِلَ هذه المضاهاة أصلاً: فردوس(امرأة) عشبة ضارة…! وإذا كانت الكلمة تستدعي أطيافاً من الدلالات غير الثابتة؛ فإنّ الدلالة المكانية تفرضُ حضورها بقوةٍ ليس فقط بحضور الكلمة اسماً معرّفاً وإنما من خلال حرف الجرّ “في” المفيد للظرفية المكانية ومن هنا يمكن أن يتخذ التحليل استناداً إلى سياق التسمية انعطافاً آخر:
يتأسس العنوان [عشبةٌ ضارّةٌ في الفردوس] على فضاءٍ مكانيّ متخيَّل (الفردوس) مفخّخ بالتضاد والتناقض من حيث اشتماله على كائنٍ (عشبة ضارة)، الكائن الذي يفرّغ المكان الأزلىّ ذاتَهُ من سرمديتهِ وصفائهِ وهناءتِهِ وقدسيتِهِ؛ ليدفعه دفعاً إلى سِيَاق التَّاريخ بكلّ ما فيه من متناهٍ وفانٍ وضارٍّ وتلوّث، فالعشبةُ الضّارةُ تطيحُ بفكرة القُدسية، قدسية “الفردوس” إلى “فردوس” من غير “قدسيةٍ”، ليغدو الفردوس “مكاناً تاريخياً”، مكاناً مُعاشاً، العالمَ، الواقعَ بأمراضهِ الفتاكة، لتنكشف التسميةُ عن خدعةٍ في المجاز تَجِبُ ترجمتها من داخل اللغة نفسها: فالعشبة الضارّة ليست إلا الكائنات البشرية في جحيمها الأرضيّ، أي في جحيم(عامودا، المنارة، البحر) الذي رسمته الروايةُ لكائناتها الضارّة (المساعد أول، بريندار، منجونة…إلخ)، بل العنوان يتجاوزُ هذا الحدَّ من الدّلالة إلى الوطن نفسه، أي سوريا البلد، ذاك الفردوس الذي تحوّل إلى جحيم بكائنات ضارّة في ظل سلطةٍ لا تعتاش إلا على الضارّ والشاذّ والعتمة والعنف ومنطق القوة. وبهذه الصُّورة الأولية من التأويل يمكن لنا التحرُّك مع العنوان في النصّ للإمساكِ بانتشاره لفظياً ودلالياً.
تَرِدُ صيغةُ العنوان بصورةٍ مباشرةٍ على لسان السّاردة منجونة بالقول: “لا أبحث عن إجابةٍ لسؤالٍ ما إذا كنتُ عشبةً ضارّةً في فردوس مخادعٍ أم لا، فمعظم من أتذكّرهم كان يَعُدُّ الآخر عشبةً ضارّةً في فردوسه. يلقي عليه باللوم لأنه عكّر المزاج صفو أيّامه، ولولا حضوره الباهت لكانت حياته فردوساً دائماً متجدداً. ص10″. يتكشّف سرُّ “العشبة الضارة” هنا، وارتباطه بمنجونة، ابنة موروي الأعمى، الأنثى المسخ لكنَّ التوصيفَ يتجاوزُهَا إلى ما هو أبعد، إلى “الآخر” مطلقاً، “الآخر” الذي يهدّدُ حقيقةَ الذَّاتِ ويعبثُ بصفائها، بهويتها، يشقّقُ هذه الهوية الثابتة المزعومة ويُحيلُهَا إلى الصّدع الذي يكمنُ في بنيتها، ذلك أن حضورَ “الآخر” إنما يفضحُ الوهم الذي تتغذّى عليه الهويةُ الثابتةُ المزعومةُ، المستقرةُ، والواضحةُ وهو ما سيتجلّى ليس على صعيد علاقة منجونة بمجتمعها فحسب، وإنما في علاقةِ السّلطة بالآخر الكردي الذي يعكر وجودُهُ صفوَ حقيقةِ رؤيةِ السّلطة القائمة على الهوية “العربية” الواحدة، المزعومة للمجتمع السُّوري، المتعدد أصلاً؛ ولذلك سَتَسْعَى السُّلطةُ من خلال تقرير ضابط مخابرات إلى محاولة محق “الاختلاف” و”التعدّد” بممارسة الإبادة الجسدية والثقافية للكرد ولكلِّ مختلفٍ آخر.
إلى ذلك تستمرُّ الرّواية بتعميق مستوى الدِّلالة للعنوان على لسان منجونة: “لا أنسى يوم الجمعة المشؤوم ذاك، حين أشار إليّ الشيخ بعصاه وهو يستقيم على المنبر آمراً بإخراجي من الجامع وهو يقول مستنكراً: “ماذا تعمل هذه العشبة الضارّة في هذا المكان الطاهر..؟، ص11”، هنا يعملُ السِّيَاقُ عَلَى ضَبْطِ المُشَار إِليهِ؛ لِيَأخذَ “الفردوسُ” شكلَ الجامع، المكان ــ الدّيني وتتقمّصُ العشبةُ الضّارةُ “منجونة”، الابنة التي تقود أباها الضّرير إلى الجامع وأنحاء أخرى من المدينة. وطالما أن المكان “طاهر”، فتجب المحافظة على طهارتهِ، بالأحرى على فردوسيته من الدَّنَسِ المتمثّل بمنجونة، العشبة الضارة التي تعكرُ صفو الطهارة المكانية للجامع، المقتصر على العنصر الذكوري، كما لو أَنَّ حديث الشيخ يعكس صدى بعض الأحاديث المتداولة [يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. رواه مسلم]، فكلامُ الشيخ هنا يلمّحُ إلى سياساتِ الأفضلية التي تمنح المكانة الأسمى للذكورة التي من حقّها وحدها دون الأنوثة أن تَؤُّمَ المكانَ الطَاهرَ، فطهارتُهُ من طهارةِ المكان بل هذه الطهارة تخصّه وحدَهُ دون الكائنات الأخرى! بيد أنّ المكان الطاهر أي الفردوس أو الجنة لا يكون كذلك إلا بوجود عنصر أنثوي [(وَحُورٌ عِينٌ. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، سورة الواقعة، الآية 22-23) /(مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍۢ مَّصْفُوفَةٍۢ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ، سورة الطورالآية – 20)] أي أنّ الفردوسَ حتى في حالتهِ الميتافيزيقية لاتكتمل طهارتُهُ إلا بالعنصر الأنثوي المتمثل بـ”الحُور العِين”، أي بـ”العشبة الضارة” التي تُضْفِي الطهارةَ على المكان كما لو أنَّ الطهارةَ مرهونة بحضور الأنثوي حصراً، بل إنّ الأنثوي هو الذي يحقّقُ طهارةَ المكانِ ذاتِهِ، أي أنَّ طهارةَ الرّجل من طهارة المرأة أو بكلمات أُخَر لا طهارةَ للرجل من غير حضور المرأة ومن ثمّ يمكن قلبُ العنوان استناداً إلى هذا التحليل؛ ليغدو الرّجلُ ذاتُهُ: “العشبَ الضارَّ في الفردوس” ما لم تحضر الأنثى! وهكذا فالخطاب الديني يفكّكُ نفسَهُ بنفسِهِ.
لذلك ستحاولُ “منجونة” أن تقوّضَ سياساتِ الخطاب الديني القائم على استبعاد المرأة من “الفردوس” أو التعامل معها على أنها “عشبةٌ ضارةٌ” ينبغي اجتثاثُهَا حتى يحافظُ المكانُ ــ الفردوسُ/ الجامعُ على طهارتهِ، لذلك تواجهُ هذهِ الخطابيةَ الذُّكوريةَ بالشكّ: “إذن، أنا عشبةٌ ضارّة، ولكن أين فردوسهم المتخيّل؟! ص12“. تساؤل يؤسّس للتعجُّب، منبجساً من مواجهة الحقيقي (الأنثى بوصفها عشبةً ضارةً) بالخياليّ (الفردوس بوصفه مكاناً متخيَّلاً)، ليؤكد قوةَ الحياة، قوة الحي في الأنثى في مواجهةِ سَرابيةِ المكان المتخيّل، الواقع في مواجهة الخيال. ومن جهة أخرى ينتقل “الفردوس” من الفضاء الديني إلى فضاءٍ السّلطة حين تُمنع “منجونة” من الدّخول مع أبيها المُستدعى إلى “مفرزة الأمن” فـ“هناك [تقول منجونة] اعتبروني عشبة ضارّة يجبُ ألا تدنّسُ فردوسهم الموهوم. ص13″؛ فشأنُ “الذات” الدينية أو السلطوية أو المجتمعية أن تناكفَ “العشبة الضارة” أو”الآخر” للحفاظ على نقاوتهاالمزعومةِ، هويتها الصافية المستقرة، للاستمرار في صنع الأوهام حول نفسها ككينونةٍ ثابتةٍ. ومن هنا الرُّعبُ الذي يجلبه قدومُ “الآخر:” إنها وسيلتي [بناء الحكايات] للاستمرار وسط ذلك الجحيم الذي يظنّه كلُّ نزيلٍ من نزلائه فردوساً أسطورياً، ليس الآخر فيه سوى عشبة ضارة ينبغي اجتثاثها وتطهير فردوسه منها، ص13″. ففي الوقت الذي تتخذ فيه “منجونة” الحكايات فردوساً لها يكشفُ الفردوسُ الدينيُّ والسلطويُّ عن جحيميته، هذا الجحيمُ/ الفردوسُ الموهومُ الذي لا يتحقّق إلا باجتثاث الآخر منه، على هذا المنوال يعكسُ الكونُ السرديُّ في الرواية عن تصادم الفراديس الموهومة من خلال الإقصاء: إقصاء خطابِ الذكورةِ للأنوثةِ، خطاب السُّلطة للآخر المختلف(الكردي)، خطاب الكردي للكردي.
يشكلّ العنوانُ في علاقته بفهرس الرواية ميزةً مخفيةً تقوّي من التماسك البنيوي للنصِّ وتشدُّ بعضُهُ إلى بعضٍ برمّتهِ. والوشائج التي تنهضُ وتتأسّسُ بينهما تكشفُ عن قصديةٍ بنائيةٍ واضحةٍ. وبموجب التَّحليل الدِّلالي السَّابق للعنوان فهو يتكوّنُ من عنصرين أساسيين: [كائن حي(عشبة ضارّة) ومكان(الفردوس)]، ويمكن بهذا الشكل ردُّ عناوين الفهرس عامّةً إلى هذه العنصرين، فالكائن الحي عبر الكائنية أو صفة من صفاته يشتملُ على: (ترويض الشياطين، سمسرة، العناد مراد، الرجل البصّاق، سجناء، أبو فطيسة، كلاب الصيد، عين المستشار، عبث) أما الفردوس فيمكن إدراجُ ما تبقّى من العناوين تحت صفتهِ المكانيةِ: (وشوم، بيت الشعب، بيت الكرم، بيوت، جسر، التحفة الأخيرة، كوخ الخواجة، البؤر المعتمة، جبل الأشواق)، كما أنَّ بعضَ العناوين تنتمي معاً إلى عنصري العنوان: (جيمي في جرمانا، نَغَمْ في الطريق، ارفعني ولو على خازوق). وبهذا التوزيع يمكن بسهولةٍ القبضُ على الوشائج الرابطة بين كائنات الفهرس وكائنيْ العنوان، التي تكشف للمتأمل جملةً من التحولات الدّلالية التي أصابت العنصرين مع تطور الحدث الروائي وتعقُّدِهِ وامتداهِ عبر الفصول كما لو أنَّ عنوانَ الرّواية يعيدُ للسَّرد طاقته على الامتداد مرةً أُخرى بعد استعادة الفهرس من تمرّده، فالأصل في السَّرد أن يخاتل في تشعّبه أي فهرس وحدود! لكن في الوقت ذاتِهِ يفخّخُ الفهرسُ العنوانَ الرئيسيَّ بالتحول والانتقال والتكرار المختلف وهي انعطافات تفتح النَّصَّ على التشتُّتِ واللاستقرار واللاحسم وبناء مراكز متعددة للفعل الروائيِّ ومن ثمّ استدعاء قراءةٍ إثر قراءة.
II ــ البداية ــ النهاية:
إنها سرديةُ العشبة الضارّة، سرديةُ “منجونة”، عاشقةُ الكتبِ الفَلسفيّةِ، وهي ترمي بـ”النَّهاية” على شاطىىء “البداية” ثم تأخذنا إلى “البداية” في “نهايةٍ” مريعةٍ. فالأمر ليس أكثر من حادثٍ غَرَقٍ إذ تفتتحُ به منجونةُ الرّوايةَ وتنهيها به، وما بين تكرار الحدث بدايةً ونهايةً تستعيد منجونة أحداث الرواية وتحولاتها الزمكانية وشخوصها: “لا أريدُ أن ينتشلي أحدٌ من غرقي. ص7“. هكذا تبدأ الرّوايةُ بهذه البدايةِ الفتّاكةِ، بدايةٌ تتمحور حول “الغرق“، والبداية هنا ستارة تُزاحُ ليتقدّم المشهدُ الرّوائيُّ بصلابةٍ، وهذا ما يحدث تماماً بعد مساحةٍ قصيرةٍ من مونولوج داخليٍّ، مخصصة للبدايةِ من الفصل الأول (ترويض الشياطين). لكنّ “الغرق” الحاصل في البداية ليس إلا حافّة مجاز، فـ”الغرق” ممرٌ، إيماءةٌ جسورةٌ إلى حَدَثٍ آخر، كنايةٌ عن الكلام، عن السَّرد ذاته. ومن هنا تزدوجُ البِدايةُ في عَمَلِهَا (حيثُ استهلالُ الكلام وافتتاحُ السَّرد وابتداؤه وفي الوقتِ ذاته الإحالة إلى حَدَثِ الغَرق في النِّهاية من حيث كونه التّعلّةَ في استدعاء أحداث الحكاية والتأسيس للبدايةِ نفسها). وإذا كان هذا “الغرق” ليس إلا مجازاً فيمكن إجراءُ ترجمةٍ لشذرة البداية: “لا أريدُ أن ينتشلي أحدٌ من غرقي” أي”لا أريد أن يقاطعني أحد عن سردي”، فأي انتشالٍ/مقاطعةٍ ستُوقع بفعل السّرد وتقطع إيقاعه وتمنعه من أداء وظيفته للاستحواذ على العالم. لذلك تمضي السَّاردة إلى امتداح حدث الغرق والعتمة التي تحيط بها: “هذه لحظة الانعتاق المطلقة التي ظللتُ أرنو إليها، أستمتع بهذا الغرق، بهذه العتمة الجديدة، أحظى بحُريةٍ ما فتئت أحلم بها. ص7″. إنها لحظةُ انفجارِ السَّردِ وفيضانِهِ،لحظةُ ولادةِ العَملِ الرّوائيِّ ذاتِهِ، اللحظةُ التي تسمحُ للحَدَثِ بالانبثاق، لكنها لحظةُ خاتمةِ الرّوايةِ أيضاً: “على أيّ شاطئ أستلقي الآن؟ من هؤلاء الذين يحيطون بي؟ هل انتشلني أحدهم من عتمتي المنشودة تلك (…) أنا منجونة التي لم يُعرف لها عمر محدّد، الغارقة في عتماتها، الهاربة من حكاية إلى أخرى، أقف على عتبةٍ متاهةٍ جديدةٍ. يبدو أنني عدتُ إلى دائرة النار ومسرح العبث. إنها العتمة من جديد. ص2017”. وفي “غَرَقِ” البدايةتتأسس الحكاية، تمتدُّ، تُؤرِّخُ للبلدة المتمردة بكلّ تفاصيلها من لحظة تقرير ضابط الأمن الصغير حول الكرد وحتّى تحطيم الصنم في 2004 ثم الانتقال إلى ضواحي دمشق وصولاً إلىى أحداث 2011، حيث البحار والطُّرق الوعرة والمنافي. ولكنّ النّهاية “لن تنتهي” وإذ بمنجونة تستلقي على الشَّاطئ الآخر من الحكاية، ثمّة مَنْ ينقذها، ثمّة نهاية لم تنتهِ، فكلّ نهايةٍ بداية جديدة” أقف على عتبة متاهة جديدة”، تعلن منجونة، فما هي هذه المتاهةُ؟ ربما السّياق النّصيُّ يساعدنا في مطاردةِ الدّلالةِ من حيث إنّ المتاهة تحيلُنا إلى “الكينونة الكردية” وما يعتورُهَا من إشكاليات مستعصية أو أَنْ الأمْرَ يتعلّقُ بسرديةٍ جديدةٍ برسم الانبثاق. ثمّة علامةٌ يثبّتها الرّوائيُّ في نهاية النّص، جاءت هكذا: “لن تنتهي“. وهذه العَلامة تَتَنَادَى مَعَ السَّطر الأخير من الخاتمةِ، السَّطر الذي يدفعُ بأفق تراجيدي إلى القدوم، أفقٌ يتّكِىء إلى عتمةٍ جديدةٍ! وهكذا لسنا هنا إزاء “نهاية” بقدر ما نحن على أعتابِ بدايةٍ جديدةٍ (نهاية مفتوحة)، كما لو أَنّ النّهاياتِ ضربٌ من الوَهم أو السّراب كما تقولُ الحكمة التفكيكية.
III ـــ الميتا ـ سرد:
تحتفي رواية “عشبةٌ ضارّة في الفردوس” بظاهرة الميتاسرد أو الميتافكشن Metafiction بل إنها في الواقع تحتازُ على استراتيجياتِ الميتاسردي بصورةٍ واضحة (التناقض، المفارقة، الإفراط التناصي، العشوائية، الغموض ـ يُنظر كتاب الميتافكشن: باتريشيا ووه، ترجمة: السيد إمام)، والأمر هنا لا يشتمل على ممارسةٍ نصيةِ (للميتاـ سرد) فحسب بقدر ما يلمسُ القارىءُ ذاك “المتخيّل السَّرديَّ الواعي بذاته”، أي حضور وعي نقديٍّ بالعمليةِ السَّرديةِ ذاتها. هذا الوعي يمكن مركزتُهُ حسب باتريشيا ووه على “الكتابة التخيلية التي تلفت الانتباه بطريقة واعية بذاتها وانتظامية(…) بهدف طرح الأسئلة حول العلاقة بين المتخيَّل والواقع ومن خلال تقديم نقد لطرائقها في البناء. تفحصُ هذه الكتابات ليس فقط البنى الأساسية للمتخيّل، ولكنها تستكشفُ أيضاً التخييل fictionalityالمحتمل للعالم خارج النص التخييلي الأدب. ص8، م. ن”. ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ الممارسات النقدية التي مارسَهَا ويمارسُهُا الرّوائيُّ نفسه في كتبٍ وصحف ودورياتٍ أهّلته لممارسةٍ نصيةٍ ميتا سردية واضحة إلى ذلك فإنَّ فهذا الوعي السَّردي بذاته يتجلّى لدى الرَّاوية/ السَّاردة منجونة على المسار الرّوائي كتمثيلٍ للروائيّ من خلال الملاحظات التي تبديها حول بَنْيَنَةِ الحكايات في النّصِّ: ” أعاودُ تركيب الحكايات المتداولة عن “المساعد أول”. أحاول بناء حكايتي عنه. ص13″. هنا من خلال اللغةِ، الحكايةِ نرى العالمَ وكائناتِهِ، لكنّ هذه الحكاية ذاتها هي حكاياتٌ برسم التَّناسل والتَّناسج والتّنَاكُحِ تخضعُ للتّخييل والتركيب فيغدو مفهومُ التمثيلِ ضَرْباً من الوَهم، فنحن لا نرى العَالمَ بقدر ما نرى الحكايةَ، بقدر ما نقبضُ على العالم من خلال حكايتنا التي تتناصُّ مع حكايات الآخرين. ومن هنا فالحقيقةُ التي في حوزتي هي حقيقةُ “حكايتي”، التي تعكسُ أو تحملُ أهوائي ورغباتي لإنجاز مشاريعي السّردية، فهي لا تمثّلُ “الحقيقةَ” في عريها وإنما إمكانية من إمكانيات الاستيلاءِ عليها والترويج لها من خلال حكاية ما. لكنَّ هذه “الحكاية“ هي ممرٌ من الممرات للإحاطة بالعالم “تتحول الحكايةُ إلى أداةٍ لتشريح الذّات والمجتمع، تتخلّص من أعباء تقييدها بالمتعة والفائدة. تدخل عتمة الدواخل، تزيح النّقاب عن المخبوء الكامن في التفاصيل. تروّض الشياطين وتطلقها في فضاء الخيال. هل يكون المرء أمام امتحان المواجهة وهو يشهر سكّينه ويشرّح داخله…؟! ص26”. إنّ الزّجَّ بالآراء النّقدية في ثنايا السَّرد الروائيّ يأتي من قبيل التحوّل في المنعطفِ السّرديّ في علاقتهِ بالعَالم وبالجنس الأدبيِّ نفسِهِ الذي تنتمي إليه الرِّوايةُ وبالكاتبِ والقوى الفاعلة في النّصِّ ذاته وأدوارها وبرامجها السَّردية، وهو تدخّلٌ يفرضُ على القارىء أنه إزاء عملٍ تخييليٍّ، وأنه تمثيلٌ، وأنَّ وظيفته لم تعدْ تقتصرُ على إحداث المتعة بل إنه يمارس تقويضاً للذوات والمجتمع. وهو بذلك يطرحُ الأسئلة ويتسرّبُ إلى المناطق العمياء ويفضحها، إنه يضع المجتمع بألغازه وأسراره وغوامضه وعلاقته بالسّلطةِ أمام منطق التقويض عبر الكلمة الجمالية. وهكذا لم تَعُدِ الرِّواية فضاءً للتسلية بقدر ماهي كتابة التاريخ غير المكتوب للمجتمع والذات في علاقتهما بالسُّلطة والمعرفة، بل هي الردُّ كتابةً في حالة المجتمع الكردي على السُّلطة التي لم يكن لها من شاغلٍ سوى إحباط الرُّوح الكردية وهذا ما سوف نراه في الفقرة القادمة. إنّ وظيفة “الميتا سرد” تتنوّع وتتعدّد في سياق الرّواية لتغدو الرواية نقداً للرواية ذاتها والكشف عن عمليات التركيب التي تطال الشخصيات ووظيفة الكاتب في اللعب بها وهنا يظهر الوعي السَّردي بذاته، حين يضعُ عمليةَ البناء الروائي أمام سَعِيرِ الأسئلةِ والشُّكوكِ: “ستمضي ذواتي المتعدّدة بحكاياتي في متاهات الواقع وأنفاق الخيال. سأسند لأبطالي وشياطيني أدواراً معيّنة وأسلبها منهم في الوقت الذي أريد. هنا فقط أمارس ترويضي لجنوني وأهدّىء من براكيني. هنا أمنح نفسي سلطة القرار وأكون حرّة في اللعب بالحيوات والمصائر. ص33“. وكما يبدو للقارىء فإنَّ الوعيَ السَّرديَّ بذاتِهِ يضعُ العملَّ الرّوائيَّ في مشرحةِ التَّقويضِ وتحديداً علاقة الرّوائيّ بقوى النّصِّ من حيث هي صناعةٌ، تأليفٌ، لعبةُ خيالٍ تعكسُ رغباتِ الكاتبِ وأهوائهِ، وهي رهنُ بمشيئةِ الكاتبِ في منحها الحياة وإزاحتها عنها وهذا ما يجري تماماً في فضاء الرّوايةِ بظهور قوى تؤدّي أدواراً لتختفي من ثمّ. ولايرنُّ في النهاية سوى صوتُ منجونة، قناع الرّوائي في مشهدياتِ الفردوس وأعشابه الضارّة. في الواقع لايتسع المجال هنا لمطاردة تمظهرات “الوعي السّردي الواعي بذاته” كافةً. إذ تحتاج إلى قراءةٍ مستقلة ومفصّلة. أما الآن فيمكن الانتقال إلى الثيمة المركزية في الرّواية وهي من الثيماتُ الرئيسةُ في الرّوايةِ الكرديةِ.
IV ـــ خطابُ السُّلطة وتقويضه:
تَتَمَحْورُ سِيَاسَاتُ السَّردِ في “عشبة ضارّة في الفردوس” على إضاءةِ المنطقةِ المعتمةِ من البؤرتين المكانيتين، أو كتابةِ التّاريخِ مِنَ الأسفلِ لحيواتِ البَشَرِ وممارسةِ الوعي السَّردي بذاته كما رأينا فيما سَبَق. لكن ذلك لم يَطْغَ عَلَى مَنْحِ الكاتبِ أَهميةٍ كبيرةِ في الوَقْتِ ذَاتِهِ لثيمةٍ هامّةٍ، تتمثّلُ بالسُّلطةِ وممارساتها ضدّ الكُرْدِ والكَشْفِ عَنِ الطَّبيعةِ العُنصريةِ لخطابِهَا ضدَهم. ويجري التمثيلُ السَّرديُّ لهذه الثيمة بشخصيةِ “المساعد أول” ويومياته التي يُدوّنها. وفي واقع الحال فهذِهِ الشَّخصيةُ مع يومياتِهَا/ خِطَابَاتِهَا هي ابتكارٌ تناصيٌّ مِنْ لَدُنْ المؤلِّفِ، تَسْتَدْعِي إلى الّذاكرةِ شخصيةَ “الضّابِطِ سيّءِ السُّمعةِ، محمد طلب هلال [يجري ذكره في الرواية باسمه الصريح، ص49ن 51، 52]، رئيس الشّعبة السِيَاسيّة في الحسكة في 1963” إذ أصدر المذكورُ دراسةً عن الكرد تَقْطُرُ عُصَارةَ الفِكْرِ الفّاشيّ ـ النّازي السُّلطوي عِصْرَئذٍ ولمّا…! وقد شكّلَ هذا “التقرير” بنيةً نصيةً أتاحتْ للرّوائيّ بناءَ حَدثٍ تناصيّ من القوة بمكانٍ لتمثيل السُّلطةِ بخطابها الجهنميّ تجاه الكرد. و”التناصُّ ــ الجاري مع “التّقرير” ــ ليسَ الهدفُ منه “إحالة إلى نصوصٍ سابقةٍ، بقدر ما هو تلاعبٌ أيضاً بتلك النُّصوص” كما تقول الناقدة برندا مارشال في سياق مماثل، ليشكّلَ فضاءُ التناصّ في الرّواية إشارةً مزدوجةً إلى تلكَ البنيةِ النّصيّةِ وإلى خِطَابِ السّلطةِ اللاحق لها، السلطة التي نفذّتْ تعاليم التقرير بِحَذَافِيرهِ في الوقتِ ذَاتِهِ. وَمَنْ هنا تَظْهَرُ الوظيفةُ الإبداعيةُ للتناصِّ بِوصْفِهِ اختلافاً وتبايناً.
بعد أن يتمكّنُ “المساعد أوّل” من ترتيب أوراقهِ يَلجَأُ إلى بعض عملياتِ القتلِ التي تفوح غدراً في البلدة (نازة، المرزباني، الشيخ الهارب إلى تركيا) وتجنيد بعض أهاليها (كفجال، محجوب، بريندار، خربو)، لضرب البلدة بعضها ببعضٍ (صَلْحو وشَفْرشْكو، رسيلو وعبدكي) تمهيداً للفتك بها وابتلاعها. يَظْهَرُ خِطابُ السُّلطةِ وممارساتها الاجتثاثية ضد الآخر من خلال “أوراق المساعد أول” التي تتولّى “منجونة” الرّاوية إدراجها في سياقِ أَحْدَاثِ السَّردِ عَبَرَ رَبْطِهَا بالميتاسَردْ أو بتسويغاتٍ سرديةٍ أُخرى تمهيداً لعرضهَا. تكشفُ هَذِهِ الأوراقُ السياساتِ المستجدة للسُّلطة في صيغتها البعثية النَّازيّة بل إنّ هذه “السِيَاسَاتِ” تتجسّدنُ في خطابِ المعارضةِ ذاتِهَا راهنئذٍ وعلى نحو شَنيعٍ. يكتب المساعد أول في أوراقه: “لابدّ من السعي للفتك بالبلدة والحرص على تعزيز مشاعر الدونية في نفوس أهلها والاستماتة في تكريس أحاسيس الاضطهاد في أرواحهم، ليجدوا أنفسهم دوماً أسرى هويّة تائهة. (…) نعمل على التشكيك في الأصول والعروق، ونجهد لتعميم نظريات الهوية الضبابية الهاربة إلى حضن السيد المتجسد في الدولة. ص45“. هنا؛ تُطِلُّ، في شذرة المساعد أول، بنودُ تقرير “محمد طلب هلال” بل إنّ بحثَهُ من بدايتِهِ إلى نَهايتِهِ هو في محاولتهِ اليائسةِ تثبيتِ هويةٍ تائهةٍ بل شائهةٍ للكردِ من خلال الطعنِ في أصولهِم وأعراقهم. والأمرُ هنا لا يخرجُ عن تمركزٍ بدائيِّ عن “الذات” للإيحاء بأصالةٍ، هي في منبتها زائفةٌ، تمركز قومويّ حول مفهوم “الأصل” للتشكيك بكينونةِ “الآخر”، وهي الكينونةُ التي رغم كل الصُّدوع والمنغصاتِ والتكميم التي تعرّضت لها، بقيت “وحيدة” تُواجِهُ المشاريعَ الفاشيةَ للسُّلطةِ في سوريا والعراق من إقصاءٍ وإبادةٍ ثقافيةٍ وجسديةٍ ومحاولات تغييبٍ يائسةٍ بحقّها. تأتي شذرةُ المساعد أول هنا لتعكسَ سياساتِ سُلطةِ “البعث” التي تستنوقُ مرجعيتَهَا من مستنقع الممارساتِ الفاشية والنازية تجاه حقوق “الآخر” بل حقوق “أكثرية الشعب” فراراً من أيّ حضور لفضاءٍ ديمقراطيّ بل منعه بأيّ وسيلة كانت وتكون!
تستمرُّ منجونة بنشر”أوراق المساعد أول” في سياقِ السَّرد الرِّوائيِّ وأحداثِهِ؛ لتتكشّف المحاولاتُ الحثيثةُ لسياساتِ السُّلطةِ في تجسيدٍ تأمليٍّ وفعليّ للفتكِ بكينونةِ الآخر الكرديِّ الثَّقافيّةِ: “لابدّ من الإشادةِ بمسألةِ اتخّاذ الإسلام وسيلة لتعريب الناس، والتأكيد على أولوية العروبة في الحياة. وبالتوازي مع ذلك التأكيد على أنّ لغة أهل الجنة هي العربية، ويحتاج الأمر إلى تكرار كي يزرع في وجدان الناس، ويكرهوا لغتهم بالفطرة. ص53”. يمتازُ حضورُ “الآخر” في سياساتِ السُّلطةِ بكونه حضورَ عدوٍّ وجوديٍّ، هكذا قدّمتْ “سلطةُ البعث” للأكثرية السُّورية “صورةً” قاتمةً للكينونةِ الكرديةِ من ثمّ لابدّ من اجتثاثِهاِ، لابدَّ من إزالةِ أيّ اختلافٍ وتغايرٍ من شأنه أَنْ يلوّثَ صفاءَ العِرق الواحد (وهو ما انطلى على الأكثريةِ بكلّ بساطةٍ وهو ما نجدُ آثاره الكارثية اليوم!)، ولذلك استغلتِ السُّلطةُ البَعثيةُ كلّ الأوراق التي من شأنها اغتيال الاختلاف وأولها “الرَّأسمال الديني” الذي يجمعُ بين العرب والكرد؛ فمادام “الإسلام” هو الانتماء الديني للكرد[ قسم من الكرد ينتمي لإحدى الديات الكردية الأولى والعريقة وأقصد اليزدانية التي جرى تغييبها على نحو مريع ] من ثمّ فالعربية لغة القرآن والجنة فما حاجةُ الكردِ للغةِ الكرديةِ في “الحياة الدنيا والآخرة”! وقد ترتّبَ على ذلك حضورٌ فاشيٌّ “للعربيةِ” بين الكرد كلغةٍ سائدةٍ على حسابِ “الكردية” التي جرى إبادتها باقتصادٍ مفرطٍ ضمنَ سياقِ اقتصاديات الإبادةِ الثقافيةِ التي مارسَهَا البعثُ حتى اللحظةِ الرّاهنةِ ليس بشأنِ اللسان الكرديّ فحسب وإنما بشأن اللغات الأخرى وإن لم تكن بالقدر ذاته من العنف والتجهيل. اقتصرَ تداولُ الكردية على الاستعمال الشّفاهي فحسب مما أدّى إلى إلحاقِ أذىً عميقٍ بتطوراتها الدّلالية والمعجمية والبحثية والاشتقاقية وبالتالي جرى القضاءُ عَلَى نَهْضَتِهِا في ثلاثيناتِ القِرن العِشرين وحتى استلام “البعث” للسُّلطةِ. هذه الإبادة الثقافية باعتماد سياساتِ التّهجير والتجَّهيل وفرض العربية بالقوة، السياسات التي تظهر بجلاءٍ في بنود 1963، اتخذتْ شكلَ بُنيةٍ صلدةٍ لدى مثقفي “البعث” أو ممن يرى “العَالم” من خلال خطاباته أو نسقه الفكري الذي تمكّن من البنى الذهنية فحاصرَهَا لنصفٍ قرنٍ من خلال أجهزة الدولة الأيديولوجية والعنفية، فأضحت عتبةً للتفكير كما لو أنّه لا مناصّ منها…!
يسلك السَّردُ الرِّوائيُّ طريقةً ذكيةً في تقويضِ “أوراق المساعد أول”ــ التي سَمَّاها “التحفة الأثيرة” بغلافها الأسود في إشارة إلى مجلداتٍ أربعةٍ معروفةٍ للسوريين تتضمّنُ “مبادئ البعث ومنطلقاته”ـ الأوراق التي تمتح دلالالتها النَّصيّةِ من التقرير المذكور، بإدراجِهَا في سياقاته للتدليل على الممارسات السُّلطوية، متتبّعاً انعطافاتها الزمنيةِ والمكانيةِ تبعاً للأحداث في سوريا والتغيير الذي طرأ على مكانة “المساعد أول” إلى “مستشار” ثم إلى “مستشار بعين واحدة” بعد “العهد الجديد”. ثيمات كثيرة تعكسُ سياساتِ السّلطةِ الفعليةِ ولو أنها جاءت في سياق نصّ متخيّل: “الكردي خنجر في خاصرة الأمة العربية”، “عناد الكردي هو الاستثمار الرابح بالنسبة لدينا”، “إذلال العزيز وإعزاز الذليل”، “خلق فجوة بين الكرديّ وتاريخه”، “تقديم صلاح الدين على أنّه الرَّمز التاريخي الأعظم في التسامي على انتمائه القومي لصالح الانتماء الديني”… إلخ. على أَنّ ذروةَ هذه السياسات الكولونيالية أخذت تنفيذَهَا الفعليّ إثر أحداث 12 آذار 2004 الشَّهيرة وبعد “تحطيم الصّنم” على مداخل البلدة لأول مرّة في تاريخ سلطة البعث، لنقرأ وصية المستشار: “أوصي بضرورة إرجاع التمثال القديم إلى مكانه في مدخل البلدة.. يجسّد ذاك التمثال هيبة الدولة وسطوتها وقوّتها. ص 151″. لم يكن التمثال إلا السُّلطة في حضورها الرمزي أو المجازي؛ ولهذا كان لابدّ من إعادة الرمز المجازي إلى وضعيته الأولى، موقعه الأول، ليشغل الفضاء بالدلالة المبتغاة منه وهو تمثيل السُّلطة، حضورها، استحواذها على الفضاء ذاته بل “عروبة” السُّلطةِ في بلدةٍ كرديةٍ. من جهةٍ أخرى مَثّلَ “تحطيم الصنم” في بلدة عامودا منعطفاً، علامةً، مَثّلَ تحدٍّ لـِهَيْبَةِ “سلطة “البعث” التي لم تتركْ أيِّ موردٍ، بما فيها الموارد الفنية، إلا ووظّفتُهُ لتأكيدِ البعدِ السّيميائيّ للهيمنةِ والسّيطرةِ والقوّةِ في المدن السُّوريةِ عامةً وبخاصّةٍ في فضاءات “الآخر” المتمرد، الانفصاليٍّ، الرافضٍ للانصهار والإلحاق وذلك لتعزيز “الحضور الكولونيالي” للسُّلطة المعروفة بشبقها الغريب في الاستحواذ هنا. كما نجحَ “النَّظامُ” برغبة كولونيالية في إذابة إرادة “الشعب” فيه قسراً أو رغبةً، وهذا ما انجلى تماماً في أحداثِ 2004 ففي الوقت الذي اجتاحَ “الحدثُ” فيه المناطقَ الكرديةَ في الشَّمال والشَّمال الشَّرقي كنوعٍ من رفضٍ عميقٍ للممارساتِ السُّلطوية البشعة (وفرصة لعموم السُّوريين للخروج من مضيق الأبد الأسدي) استحكم صمتٌ مريبٌ على مساحة سوريا كلّها حينئذٍ…! لكنَّ الأخْطَرَ أنّ “سياساتِ البعث”، حيث التماثل والتطابق في أقصاهما، ستنجحُ في ترسيخ بنيةٍ ذهنيةٍ أو نسقٍ عامّ، كما يسميه إدوار سعيد، في العمل تفكيراً وممارسةً ولاسيما حين يتعلّقُ الأمر بـ”الآخر” فحتّى هذه اللحظة لايزال هذا النَّسقُ يمارسُ عَبَثَهُ وَصُورَهُ الشَّاذّة ليس لدى مؤيدي هذه السُّلطة بل حتى لدى الكثير من معارضيها الذين لم يخرجوا من مستنقعِ النَّسق بعدُ.
أخيراً تنجز رواية “عشبةٌ ضارّةٌ في الفردوس” سرديتها ضمن ما أسميه “الرِّواية الكردية في منفاها اللساني” كشكلٍ من أشكالِ “الردِّ بالكتابة” على الممارسات الكولونيالية تجاه الكرد وفضحها بوعي سرديّ ناضج.
عن موقع مدارات كرد