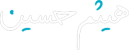سيرة المنفى روائياً.. “قد لا يبقى أحد” لهيثم حسين
د. نوال الحلح

كبرياء متضخمة (لوحة عدنان معيتيق)
إن “السجن المقلوب” (وهو تعبير للكاتب السوري ياسين الحاج صالح؛ ويقصد منه القول بأن المنفي هو مُبعد عن بلاده ومسجون خارجها وبالتالي لا يمكنه الدخول إليها مجددا) الذي يعيش فيه الأدباء في المنفى يدفعهم إلى تأثيث المكان الغريب بالسرد كي يمنحه قليلا من الألفة المُفْتَقَدَة. تُسبّب تجربة النفي الاضطراب في علاقة الإنسان بالزمان والمكان والهوية، والسيرة الذاتية هي أحد أشكال السرد التي يختارها أدباء المنافي للكتابة عن حياتهم؛ ربما لأن السيرة الذاتية تتضمن حُكماً محاولةَ استعادة الفردوس المفقود والزمن الضائع. إنّ أدب السيرة الذاتية في المنفى يظهر بوصفه صورة لاغتراب الإنسان المعاصر عن العالم، ووجها من وجوه الاغتراب الوجودي للمنفيين.
كيف يستطيع نص سردي، أن يسرد إحداثيات الارتباك الوجودي للذات في مواجهة حالة النفي؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال سوف نتناول نموذجا من أدب السيرة الذاتية في المنفى هو سيرة روائية بعنوان” قد لا يبقى أحد” للكاتب هيثم حسين، الصادر عن دار ممدوح عدوان للنشر عام 2018. وهو يحمل عنوانا فرعيا هو: “أغاثا كرسيتي تعالي أقل لك كيف أعيش” يخاطب فيه الكاتبة أغاثا كريستي ردا على كتابها المعنون بـ”تعال قل لي كيف تعيش”. المنشور عام 1946، الذي كتبته عندما عاشت مع زوجها الأركيولوجي ماكس مالاوان في مدينة عامودا السورية وهي مدينة الكاتب هيثم حسين. ولذلك هو يعلن منذ البداية رغبتَه بوصف انطباعاته عن بلدها. في كتابه هذا يقوم الكاتب بوصف رحلته بعد خروجه من سوريا بسبب الحرب فيصف تنقلاته بين المدن ثم ينتقل إلى التأمل في ما حدث معه، وفي تأمل تصرفات الأشخاص الذين حوله، وكذلك تأمل الأحداث في البلد الذي اختار الاستقرار فيه وهو بريطانيا.
السيرة الذاتية والمنفى
يعرف فيليب لوجون السيرة الذاتية بأنها “حكي استعادي نثري، يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته”. (فيليب لوجون، كتاب السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة عمر حلي، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 1994. تجدر الإشارة إلى أن لوجون نفسه قد نقض هذا التعريف فيما بعد).
ولكي يتحقق ما يسميه لوجون “ميثاق السيرة الذاتية” الذي على أساسه نجنِّس السيرة الذاتية يجب أن يصرّح الكاتب بأن هذه الحكاية هي قصة حياته، وهذا ما فعله كاتب النص الذي نتناوله بالتحليل في مقدمته. هذا الميثاق مهم لأنه بمثابة النص المصاحب، وهو بالتالي مفتاح تأويل النص.
منذ البداية، يقوم الكاتب بتعريف هذا النص بوصفه سيرة روائية على الغلاف، وبإضافة كلمة روائي إلى كلمة سيرة يكتب ميثاق القراءة (ميثاق القراءة الذي حدده فيليب لوجون بقوله بأنه كي تكون هناك سيرة ذاتية يجب أن يكون التطابق موجودا بين المؤلف والسارد والشخصية) عبر الإشارة إلى أن نصّه يحتوي الواقع والخيال معا.
في حين أن الاختلاف بين السيرة والرواية هو نسبة التخيل في كل منهما، فإنه في مصطلح السيرة الروائية تتداخل الرواية في السيرة الذاتية، لأنهما يتناولان، معاً، الأنا في علاقتها مع الواقع، ويصبح التحدي الأهم هنا هو محاولة صنع توازن بين ثقل الواقع الموضوعي وخفة الخيال الروائي.
العلاقة بين الكتابة والمنفى

إن العلاقة بين المنفى والأدب هي علاقة جدلية، فحالة النفي القسري من البلد الأم هي دافع أساسي للكتابة عند الأديب، كما أن الكتابة هي حالة دفاع عن النفس في مواجهة الاغتراب في المنفى. ومن المسلّم به بأن الحروب والكوارث تشكل تكثيفا للتجربة الإنسانية وتستدعي، بالتالي، الكتابة عنها.
عند الاطلاع على عدة سير ذاتية كتبها المنفيون نجد أنه من الممكن الحديث عن خصائص مميزة للسيرة الذاتية التي يكتبها المنفي، فهي ليست اعترافات دينية ولا دنيوية، بل هي سيرة المنفى بحد ذاته، حيث يقوم الكاتب بالحديث عن أثر النزوح والغربة على نفسه أي هو يراقب التغيرات التي يحدثها المكان في روحه. في هذا السياق نستطيع فهم الفرق بين السؤال الوجودي الذي طرحه فرناندو بيسوا في كتابه “اللاطمأنينة” وهو: يا إلهي من أنا؟ وبين السؤال الذي طرحه الكاتب المنفي هيثم حسين وهو: هنا، أنا مَن أكون؟
أما فيما يخص أسباب اختيار هذا الجنس السردي، أي السيرة الروائية، فربما يكون أحد دوافع اختيار هذا الجنس “السيري” هو شعور المنفيّ بتهديد فقد الذاكرة، وكأنها محاولة لإعادة استحضار البلد الضائع، وإعادة توطين الذات التي توشك على التلاشي في المكان الجديد الغريب. لذلك يحاول الكاتب المنفي أن يحتفظ بالذاكرة التي بدأت تتبخر في إعصار المنفى، وربما يكون الداعي لاستخدام هذا النوع من الكتابة هو المساحة التي يتيحها للتأمل والتعليق وإعطاء الرأي الشخصي وقول الحقائق دون الاضطرار إلى الاهتمام بالتقنيات السردية أو التشويق أو إثبات المهارات الفنية؛ حيث أن الكاتب هنا يريد قول الحقائق، كما يراها، دون أن تكون توثيقا تاريخيا محضا ودون أن تتناولها الصياغات الفنية بالتهشيم أو بالتحسين. أعتقد أن لسان حال الكاتب الذي يختار هذا النوع من القوالب يقول لماذا لا أكتب الحقيقة كما أراها والواقع كما أشعر به، فإذا كنت قادرا على نقل شعوري به إلى القارئ بحقيقته ودون تصنع أو مواربة سيجد القارئ في هذا النص مرآته، ومشاعره التي لم يستطع صياغتها في كلمات، معروضة أمامه في هذا النص، لأن الحقائق الأصيلة فقط هي التي إذا كُتبت ببراعة يشعر القرّاء جميعا بأنها تخصهم وبأنها تتضمن شظايا من مراياهم الشخصية. وبالإضافة إلى هذا كله ربما يكون هنالك سبب إضافي هو خشية المنفيّ من عدم قدرته على بناء ذاكرة جديدة في المكان الجديد، لأنه لم يشعر بعد بانتمائه إلى هذا المكان، وهذا ما يؤكده حسين بقوله “كلُّ البلاد منافٍ بعد أن تهجر بلدك”. (قد لا يبقى أحد – ص20).
هل توجد ثيمات مشتركة بين سير المنفيين؟
إن فن السيرة الذاتية هو أخذ مسافة بعيدا عن الذات من أجل وضعها ضمن مختبر لغوي، إذا جاز التعبير، لأن الذات في هذا النوع من السرد يُعاد اكتشافها من جديد، بإعادة خلقها وتجسيدها عبر الكلمات. لكن في السير الذاتية التي كتبها المنفيون لا يتم التوقف طويلا عند القضايا التي تتعلق بالذات بقدر ما نجد توصيف أثر الأحداث على الأفراد؛ خاصة خلال الأحداث الكبرى مثل الحروب، لذلك نجد التركيز في هذا النوع من السير متركزا على التأملات في الاغتراب وفي ثيمة الزمن. يمكننا القول بأن هذين الموضوعين مشتركان بين سير المنفيين الذاتية؛ حيث يبدو الزمن في هذه السير منطلقا من الحاضر باتجاه الماضي ولكن الكاتب لا يجعل هذا الماضي محورا للسرد، بل يتناول بتركيز أكثر الزمن الحاضر، ممّا يفسر تكرار فكرة الزمن المتوقف الذي لا يتحرك. وربما تكون فكرة الزمن المتمدد الذي يتحرك ببطء مرتبطة بالزمن النفسي الذي يشعر به المنفي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكاتب أدرج في الصفحة الأولى من كتابه الاقتباس الذي يمثل وصفا دقيقا للزمن كما يشعر به اللاجئون وهو لزيغمونت باومان من كتاب الأزمنة السائلة حين يقول “اللاجئون في المكان وليسوا منه.. فهم معلقون في فراغ مكاني توقف فيه الزمن” (قد لا يبقى أحد – ص 1).
فيما يتعلق بموضوع الاغتراب، وفيما يتعلق بالبعد الزمني والمكاني للنفي المعاصر، فإن الاغتراب له بعدان: اغتراب مكاني من جهة، و من جهة أخرى اغتراب لغوي. إن قضية الأمان اللغوي هي قضية إشكالية تحرم فاقدها من إمكانية خلق محيط أليف في المكان الغريب. لأن اللغة أهم أسباب العزلة والاضطراب فانعدام وسيلة تواصل يؤدي إلى خلل في الشعور بوجود الفرد ذاته، ومن هنا يشعر المنفي بأنه غير مرئي، وبأن وجوده عديم الوزن. ولهذا تصبح كتابة السيرة الذاتية تكثيف لوجود الكاتب، وإعادة تجذير له في المكان الجديد.
سيرة فردية أم سيرة جماعية

كان فيليب لوجون قد أشار في كتابه “السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبي”، (فيليب لوجون، الميثاق والتاريخ الأدبي، مرجع مذكور) بأنه في كتب السيرة الذاتية يوجد ما يسمّى بكبرياء متضخمة، فالتركيز يكون منصبا على الذات ويتم إقصاء الآخرين. ولكننا نجد في السيرة الذاتية للمنفيين نوعا من ضمير الجماعة وهو ضمير الشخص الأول بصيغة الجماعة، بدلا من ضمير المتكلم الأول” أنا”، وهو المستخدم في السيرة لأن السيرة الذاتية عادة تكون تجسيدا للفرد بوصفه نموذجا مصغرا للعالم بحسب تعبير الكاتبة البريطانية دوريس ليسينج في مقدمة كتابها “الدفتر الذهبي”.
ضمير الـ”نحن” الذي يجمع الأنا مع الأشخاص المحيطين بها في نوع من التوحد – الذي قد يكون محاولة للدفاع عن الجماعة ضد الظلم الواقع عليها – فمثلا قليلا ما يتحدث السارد عن ذكريات طفولته ولكن عندما يتذكر بعضها نجده يتناول قضية الأكراد، فيذكر القمع الذي تعرضوا له بين دكتاتوريتين الأولى سوريّة والثانية تركيّة، من خلال سرد حادثة قتل أحد الأطفال الرعاة برصاص جندي تركي على الحدود السورية التركية.
إن السيرة المكتوبة بأقلام المنفيين هي سيرة الحرب وسيرة النفي وسيرة الظلم الجماعي في معظم كتب سير المنفيين باختلاف جنسياتهم، فمثلا نجد إيزابيل الليندي في سيرتها الذاتية بعنوان “بلدي المخترع من جديد” تذكر الدافع وراء كتابتها لسيرتها الذاتية فتقول “هي محاولة لاستعادة وطني الضائع، لجمع المشتتين، لبعث الموتى” وكأن محاولة استعادة هؤلاء جميعا هي جزء من استعادة الذات المفقود المرتبطة بالمكان.
إن السيرة الذاتية الروائية هي حقل تجريب فني، وقد يكون من أكثر الأجناس انفتاحا على التجريب في استخدام تقنيات جديدة، وكل كاتب يستطيع بطريقته قول الحقيقة الأصيلة كما يراها بطريقته الفنية الخاصة التي تختلف عن الطرائق الفنية التي يتبعها الآخرون.
نستعرض بشكل موجز بعض الطرائق الفنية في هذا النص؛ رغم أن السيرة الذاتية تتصف عادة بامتلاكها للتسلسل الزمني الخطي (chronologie linéaire) بحسب فيليب لوجون، فإننا نجد في هذا النص أن التسلسل الزمني الخطي قد تم استبداله بترتيب يعتمد على فصول تتناول موضوعات مختلفة لا تتجه من الماضي إلى الحاضر بل يتناول كل فصل منها موضوعا معينا فنجد مثلا فصولا تتناول محطات الطريق إلى بريطانيا وفصولا عن يوميات المنفى وفصولا تتناول في مجملها مفاهيم مثل الانتماء واللجوء والوطن وخطاب الكراهية في العالم وفي بريطانيا بشكل خاص، بالإضافة إلى توثيق يوميات اللاجئين. وهذا يجعل الإيقاع السردي بطيئا بسبب التحليلات والأسئلة التي تتكرر في مواضع كثيرة من النص
يحفل النص بالأسئلة التي تتكرّر في الكثير من صفحات السيرة حتى أن هنالك فصلا كاملا هو بعنوان “هوية عالمية”، يتكون في ثلثيه من الأسئلة وكأن حالة الاضطراب واللايقين واللاطمأنينة واللاجدوى لا يمكن التعبير عنها إلا بطرح الأسئلة التي تبقى معلقة دون أجوبة. لغة السرد هي لغة هادئة واضحة مبنية بتروٍّ، ولا يظهر القلق في بنية الجملة ولا الإحباط ولا التشكي.
ولكن بعودة سريعة إلى العقد الذي عقده الكاتب مع القارئ حول سيرته الروائية يمكننا التوصل إلى نتيجة مفادها أن هذا النص هو سيرة ذاتية تمّت صياغتها بأسلوب روائي، بالاستفادة من بعض التقنيات الروائية كالانتقالات بين الأزمنة واستخدام اللغة المجازية والتناص مع النصوص الأخرى، ولكن مساحة قليلة هي التي بقيت للتعبير عن الذات كما أنها تختبئ وراء الأسئلة، وكما لو أنها مُقصاة عن الفعل، وبالتالي، عن الوجود.
وفي الختام يمكننا القول بأن حالة النفي والاقتلاع القسري من الجذور من المكان الأليف لا بد أن يؤدي إلى اضطراب العالم من حول الذات، مما يستلزم بالضرورة إعادة التفكير بالذات وبالعالم. ولتحقيق هذا كان لا بد من استكشاف إمكانات هذا الجنس الفني “السيرة الروائية” التي تعطي الكاتب القدرة على التحليق في سماء الخيال، حين يرغب، وعلى المشي في أرض الواقع، إن أراد، مهما كان جناحاه كبيرين.

ناقدة وأكاديمية من سوريا مقيمة في باريس