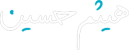رحلة في قلب الظلام
“أكتب لكم من طهران” لدلفين مينوي
تذكر مينوي أنها حجزت سنة تذكرة سفر إلى طهران، وكان يفترض بها أن تظل هناك لأسبوع، لكن بقيت لعشر سنوات، وأنها استشعرت كغيرها من الإيرانيين خيراً بوصول محمد خاتمي الذي كان يقدم نفسه كإصلاحي إلى السلطة، والذي تزامن وصولها إلى البلد مع استلامه للرئاسة فيه، وكانت تحاول، وهي التي ترعرعت في حضن الديمقراطية الفرنسية، أن تقيس الحجم الحقيقي لأحلام الانفتاح التي تهز كيان بنات جيلها في طهران، وتتساءل كيف لها أن تضع نفسها في مكان إحداهن، وتشير إلى أنها لهذا السبب ذهبت إلى هناك لكي تفهم، أو على الأقل لكي تحاول.
تكتب مينوي -والدها إيراني وأمها فرنسية- أنها كانت تنتابها فكرة تعدّ خطراً عليها إذا ما تجسّدت في مقالة وهي ما تزال في طهران، حيث تتخيل مشهد سيارة أجرة تمضي على خطوط رمادية على امتداد النظر ترسم معالم طريق المطار، وخلف الزجاج يبتلع الليل آخر الكلمات المسموعة، وتتساءل كم بقي من أولئك الذين يملكون الجرأة على الهتاف “الله أكبر” و”الموت للدكتاتور” فوق أسطح طهران.
ليلٌ بلا قمر
تحكي مينوي في كتابها (ممدوح عدوان، ترجمة ريتا باريش) أنها تفكر في المفقودين، في الأصدقاء الذين ما عادوا يجيبون على الاتصالات بهم، ببقع الدم على أسفلت الطريق، بالأحلام التي اغتيلت، برسائل التهديد، بالأخبار التي لم يعد في استطاعتهم تناقلها، وذلك الخوف الذي لن يكون في وسعهم الفكاك منه، وتصفه بأنه كان محتوماً، عصياً على الترويض، كتعلّم السباحة، أسرع من تيار يجرفهم.
تتساءل عمّا يفكر به المرء حين يصبح حراً، وهل يفكر بالسطور الرمادية التي سيتاح له ملؤها مرة أخرى بما يشاء، هل يفكر بالكابوس الذي انتهى، وأن في استطاعته التنفس من جديد، لتستدرك بالإشارة إلى أن الأصعب كان لا يزال في بداية الطريق، وأنه لا شيء أصعب من تسليم إيران إلى الضياع في أدراج النسيان.
تكتب رسالة مفترضة إلى جدها الراحل، وهي في باريس، تخبره أنها تركت أرضه بلا عودة، وتتساءل كيف من الممكن أن يترك المرء نصفه الآخر بعد أن وجده، وتذكر له أن العاصمة الإيرانية بداية صيف 2009، تبكي شهداءها، وتفيض السجون بالمعتقلين. وأنه تخضبت خضرة الأمل خلال الفترة التي دامت خلالها تلك الانتخابات الصورية بحمرة الدماء، وتحطمت آمال التغيير على جدار القمع.
تصف إحساسها بالقهر والعجز عن وصف ما اقترفته السلطات بحق الشعب، وأنها ذيلت على مضض توقيعها على تقرير صحفي طويل، وعند عودتها إلى باريس، لم تعد تقوى على الكتابة، وجافت الكلمات صفحتها، بين المحسوس والمعيش، تحولت من صحفية إلى مواطنة، فاقدة بذلك المسافة التي تسمح لها بأن تسرد، ولهذا وضعت قلمها جانباً لفترة لم تكن قصيرة، قبل أن تتذكر أبياتاً لحافظ الشيرازي أهداها إليها جدها يوماً، ومنها “أمن ترمي به الأمواج في ليل بلا قمر/كمن يمسي على الشطآن قد ألهاه ما ألهى”.
تخبر الكاتبة جدها الذي كان مبعوثاً لليونسكو، أن إيران أصبحت نسياً منسياً في باريس، ولم يعد أحد إلى ذكر اسم بلده الذي كان له مذاق الرمان، وأن وصف إيران في الصحافة الفرنسية أصبح مقتصراً على كلمات ثلاث “إسلام، برقع، إرهاب”. وهو ما أسقم والدها الذي أبلغهم ذات مساء عند عودته من العمل وهو يتهاوى على الكنبة بأن الشرطة أوقفته وعاملته كحثالة.
تتحدث عن حضورها حفلة عيد ميلاد صديقتها نيلوفر، وحين ذهبت لم تكن تدري أنها ستجد نفسها في مرقص. أحست لدى وصولها بالأرض تتداعى تحت أقدامها، كان الكحول يطفر من الأحداق، في بهو الاستقبال تناثرت الحجابات التي خلعتها جميلات السهرة على الأرضية كحطام بجانب زجاجات الكحول المهربة الفارغة.
وتذكر أن جيران صديقتها حاولوا عبثاً ثنيها عن أسلوب حياتها، فقد كانت تسخر مما يقولون، وكانت تعتبر تصرفاتها شكلاً من أشكال التكفير عن الذنب، فقد كانت معارضة سابقة للشاه، تنتمي إلى جيل علّق آمالاً كبيرة على شخص الخميني، ليحمل بعدها وزر ثورة فاشلة، ولهذا فقد انبرت لمهمة مساعدة الشباب ومشاركتهم هروبهم الليلي كنوع من التعويض عن الأخطاء التي ارتكبها أبناء جيلها بحق الإيرانيين.
كما تستعيد نكتة إيرانية شهيرة تخبرها بها صديقتها نيلوفر التي تشتهر بأنها عرابة الشبيبة، وتخبرها باستهجان، أنه في عهد الشاه كان الإيرانيون يشربون علناً ويصلّون سرّاً، وفي عهد الجمهورية الإسلامية، أصبحوا يشربون سرّاً ويصلّون علناً. وتستذكر استياء صديقتها مما آلت إليه الأوضاع، وأنها كانت تخبرها بأنّ الكذب أصبح مفتاح البقاء على قيد الحياة في إيران.
وتذكر أن نيلوفر كانت من سجناء الرأي، وأنها اعتقلت وألقي بها في سجن إيفين سيّئ الصيت، ولأنّ العمل السياسي في إيران جرم كأيّ جرم آخر، فإنها كانت محتجزة في القسم نفسه مع السجينات الأخريات كالمجرمات والداعرات ومهربات المخدّرات، مع عدد قليل من السجينات السياسيات الأخريات من أعضاء حركة مجاهدي خلق؛ وهي جماعة مسلحة معارضة للنظام الإيراني.
تحكي أنها حين أعلنت عن قرارها بالانتقال إلى طهران للاستقرار فيها بشكل نهائي، صدم والدها الذي أخبرها أن إيران ليست سوى مصنع للمشاكل وأنها لن تستطيع التأقلم معها بتاتاً، وأن من المستحيل التفاوض مع النظام، وأنها لو علمت ما عاناه جدها على أيدي زبانية النظام كل تلك السنوات لما اتخذت هذا القرار.
فوضى الذكريات
تتحدث مينوي عن العادات الشعبية في إيران، وكيف أنه غالباً ما تتجاوز الأهواء حدود المنطق، خصوصاً بين النساء، وأن كل ما يقال خلف الأبواب المغلقة يقال دون تحفّظ. وتقول إنّها سمعت كثيراً من الشهادات المؤثرة خلال إقامتها الأولى في طهران، وسمعت حكايات عن الإعدامات التي نفذت بمحاكمات صورية، واليافعين المجندين في الجيش، وأسر الجنود المنشقين التي اضطرت إلى الفرار من البلاد عبر جبال كردستان لرفضها القادة الأصوليين الجدد.. وتقول بأنها لم يكن لديها أدنى شك بأن إيران الملالي كانت بلداً قامت فيه عصابة رجال الدين بإخصاء الشعب ومبايعة الشريعة، لكنها كانت أيضاً على قناعة بأن الزمن يتغير.
تفكك آليات النظام السياسي وتعقيداته، وأنه بمعاينته تحت المجهر، يتبين أن تناقضاته عديدة بالفعل، فمن جهة كانت هناك المؤسسات الديمقراطية مثل المجالس البلدية والبرلمان ورئيس منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ولو أن مرشحي الرئاسة يتم اختيارهم من قبل مجلس صيانة الدستور؛ وهو هيئة النظام الرقابية، ومن جهة أخرى، فالمرشد الأعلى ذو السلطة المطلقة وسيطرته المباشرة على القضاء والشرطة وجيش من الحرس الثوري المتنفذ، تجعل منه طاغية.
تحكي محاولة تجنيدها كجاسوسة من قبل الاستخبارات الإيرانية، وتحكي عن اعتقالها في سجن التوحيد الذي كان أشبه بكابوس، حيث ألقي بها هناك في زنزانة انفرادية ضيقة لا تتجاوز مساحتها مترين ونصف، وكانت العزلة تدفعها إلى الجنون، وكان يتدلى من السقف مباشرة فوق رأسها مصباح نيون يضيء ليل نهار، كان الضوء ساطعاً يؤذي العيون، وتنوّه إلى أنّ ذلك كان أسلوباً شائعاً لانتزاع الاعترافات قسراً من المعتقلين، ويدعى التعذيب الأبيض. كما تفصح عن أنها سرعان ما فقدت الإحساس بتعاقب الزمن، وأن ذاك السجن كان مكاناً خانقاً قاهراً مدمّراً.
تكتب لجدها عن شغفها ببلادها وعن معاناتها هناك، تقول إنها تغلق عينيها فيبرز من فوضى الذكريات وجهه وابتسامته للمطلق، يتقاطع وجهه مع وجوه أخرى لموتى ظلوا أحياء إلى الأبد في ذاكرتها، أولئك الذين طمحوا إلى الديمقراطية ورحلوا باكراً في موجة قمع مظاهرات 2009. وتسأل نفسها قائلة: كم عدد الذين دفعوا حياتهم ثمناً لأحلام الحرّيّة؟ وكم عدد الذين حرموا من جنازة وحتى أحياناً من الدفن لأن السلطة عدّتهم في موتهم خطيرين كما في حياتهم؟
وتؤكد لجدها الراحل أن كل هذا الظلم كان ليغضبه بقدر ما يغضبها. وتسرد أنها فكرت في مغادرة إيران على عجل بعد رحلة طويلة كان هو مطلقها، وأغلقت مكرهة باب بلاد محكوم عليها بالنسيان، وتلفت إلى أنّ التخوّف على كل تلك الذكريات من أن تتلف هو ما دفعها إلى الإمساك بقلمها لتهديه حكايتها التي هي حكاية بلدها وتاريخه المعاصر بعد وقوعه بين أيدي سلطة قمعية ظالمة.
تتحدث عن استقرارها في بيروت وإنجابها ابنتها سامرا، ثم انتقالها إلى القاهرة، وتقرّ أنّها تعبت في إيران من الضغط الهائل الذي تعرّضت له، وتابعت الترحال، ومع بداية الربيع العربي، مضت نحو ثورات أخرى؛ تونس، مصر، ليبيا، سوريا، تتحرى التقارير، وانتابها الخوف من إعادة فتح الحقيبة الإيرانية ومواجهة الذكرى السوداء للأصدقاء المختفين. كتبت عن شهداء آخرين كان موتهم ربّما أكثر عنفاً. وتعترف أن تراكم الأكفان أنساها المعنى الحقيقي للحياة.
تتبدّى سيرة مينوي الروائيّة كأنّها رحلة في قلب الظلام الإيرانيّ، ولاسيّما بعد استيلاء الملالي على السلطة، وتحويلهم البلاد إلى سجن كبير يضيق بالحريات، ويقتل الأحلام لدى الشباب الطامحين بغد أجمل، ولدى أولئك الساعين للتحرّر من سلطة رجال الدين الذين سمّموا حياتهم ومستقبلهم.
يشار إلى أن دلفين مينوي صحافية فرنسية من أصول إيرانية، مواليد العام 1974، عملت مراسلة لعدد من الصحف الفرنسية في إيران لعشر سنوات. حازت على جائزة ألبرت لوندر للصحافة في العام 2006 -وهي أعلى جائزة صحفية في فرنسا- مع صحيفة اللوفيغارو عن سلسلة من المقالات التي كتبتها عن إيران والعراق.