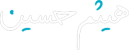حساسيات الهوية وإرث الإرهاب
هيثم حسين
تظلّ الهوية من المواضيع والقضايا الأثيرة التي يتناولها الأدباء والمفكّرون في أعمالهم، ويدلون بدلوهم في تفكيك ملامحها، وتأثيراتها على الفرد والمجتمع، بما تنتجه أو تفرضه من حساسيات تساهم بإنتاج تراكم من المواقف والآراء والأفكار، حتّى لو كان بعضها نمطياً أو منطلقاً من موقف مسبق، وتبني إرثاً قد يكون هبة لصاحبه، أو عبئاً عليه وعلى محيطه.
ويكون الخطر في تقييد الهوية بجانب مقيّد، بحيث أنّ الشكل مثلاً يغدو سجناً لصاحبه، وقد يكون عاملاً رئيساً في تقييد هويته، ووضعه في خانة الاتّهام، أو ربّما تكون الخلفية الاجتماعية، أو الإثنية، نقطة اتّهام مسبقة، وعلامة تنذر بتشكيل إرث من الإرهاب الذي ينزع عن الهوية صفتها المنفتحة، ويقوم بالتحجير عليها وكأنّها موبوءة بوباء خطير ينبغي الاحتراس منه.
كيف تتجلى حساسيات الهوية عبر الصور النمطية؟ هل يلعب الإعلام دوراً في تقييد الهويات وفرض شروط معينة عليها بناء على ما يتمّ ترويجه من عوامل تلعب دوراً في توجيهها أو صياغتها؟ هل تكون الهوية نقطة إثراء وتقارب أم عامل اختلاف وتنافر؟

نداء الهوية، بحسب تعبير الفيلسوف مارتن هايدغر في كتابه “الفلسفة، الهوية والذات”، يقود المرء في عالمه لإثبات ذاته، وهويته؛ كينونته، وهذا النداء، والذي يشير فيه إلى أنّ وجودنا مستلب ومستعجل، منهمك ومجبر في مختلف المجالات، وهو مجبر من خلال كل هذه الآليات على توجيه جهده تجاه التخطيط والحساب الكوني.
الهوية الإنسانية كينونة وفضاء مفتوح، ومن المتعذّر أن تجدي محاولات تقزيمها أو تسطيحها أو تشويهها.
وفي سياق حديثه عن الكينونة والانتماء يلفت هايدغر إلى أن الانتماء المتبادل بين الإنسان والكينونة يقود في صيغته كإرغام متبادل، نحو ملاحظة مقلقة، تتمثل في أننا نرى بسهولة كيف أن الإنسان في ما يخصه يتبع الكينونة، في حين أن الكينونة وبصدد ما يعنيها تعرج على ماهية الإنسان، ما يمهّد، أو يساهم في إيصاله إلى هويته المتبلورة، أو تلك التي يسعى لبلورتها.
وتحضر الهوية في اشتغالات الروائيين كثيمة متجدّدة لا تستكين لتقييد أو تحجيم، مثلاً، البريطانية دوريس ليسينغ (1919 – 2013) الحائزة جائزة نوبل للآداب سنة 2007؛ تعالج الهوية وإرثها وأثرها، وتجعلها نتاج إدماج صفتين متباعدتين تدمجهما بحساسية في روايتها “الإرهابية الطيبة”، حيث إنّ بطلتها آليس التي كانت تجتمع مع أعضاء في الجيش الجمهوري الأيرلندي في لندن، في الثمانينات، وتمضي برفقتهم أوقاتها، تجمع بين صفتين تبدوان متناقضتين، بين الإرهاب والطيبة.
ترمز ليسينغ إلى أنّ الصفة الأولى تكون كارثية، باعتبار أن مَن يوصف بها يلجأ للقتل والعنف والإرهاب، وبناء على ذلك، لا يفسح أيّ مجال للطيبة لديه، في حين أن الطيبة تبدو أقرب للسذاجة في هذه الحالة، ولعل الربط من قبلها بين الصفتين وجمعهما في شخصية واحدة محاولة منها لصياغة هوية بعيدة عن حساسيات مجتمعية، وبعيداً عن الإرث الذي يثقل كاهلها.
وفي إطار تصوير الإرث الذي يقيد المرء بصورة سابقه، أو اسمه، تصور الروائية البريطانية الباكستانية كاملة شامسي في روايتها “نار الدار” واقع أسرة بريطانية من أصل باكستاني، تعيش في لندن، يحاول كل فرد من أفرادها أن يختط لنفسه مسار حياة خاصاً به، بحيث يبحث عن سعادته وأمانه وراحته وحب حياته، لكن ظروف الحياة تختلف، وتقودهم في اتجاهات ومسارات مختلفة.
تبرز شامسي في روايتها كيف أنّ الإخوة الثلاثة عصمة، أنيقة، برويز، يحاولون إكمال حياتهم بعيداً عن الحمل الثقيل الذي ألقاه والدهم على عاتقهم، وهو الذي تورط بالانضمام إلى جماعات جهادية، وقاتل في عدد من الأماكن، وترك أسرته تعاني في غيابه، وفي موته، وتحاول إخفاء هويتها كأنّها تخفي عار السنين وجروح الزمن.
تثير شامسي مسألة حساسة متعلقة بتجنيس الإرهاب وإلصاق الصفة ببعضهم من دون آخرين، وكيف أن الخطاب يتغير حين يكون متعلقاً ببريطانيين من أصول أخرى، وخاصة باكستانية أو إسلامية. تتحدث على لسان بطلتها عن التاريخ الاستعماري، وأنها إذا ألقت نظرة على القوانين الاستعمارية فسوف تجد سوابق كثيرة لا حدود لها لتجريد الناس من حقوقهم.

تشير إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا سلسلة تفجيرات إرهابية وقعت في لندن يوم 7 يوليو 2005، واستهدفت المدنيين في عدد من وسائل النقل العامة، لم يوصفوا في وسائل الإعلام بأنهم “إرهابيون بريطانيون”، وحتى عندما كانوا يستخدمون كلمة “بريطانيون” فقد كانوا يستخدمونها ضمن عبارة “بريطانيون من أصل باكستاني”، أو “بريطانيون مسلمون” أو “حاملو جوازات سفر بريطانية”.. وتنوه إلى أنه كان هنالك دائماً شيء ما يوضع للفصل بين كونهم بريطانيين وكونهم إرهابيين.
تتحدث الراوية عن عدم الشعور بالأمان، وأن استخدام الخوف كأداة سياسية جهد أخذ تجربة عصمة في تجربة الاستجواب الأمني الذي مرت به في المطار فجعل منها بحثاً.
وتنهار عصمة وهي تبكي في مكتب الدكتورة المشرفة عليها في الجامعة هيرا شاه، كانت تبكي أمها وجدتها التي توفيت قبلها بأقل من سنة، وتبكي أباها، والتوأمين اليتيمين اللذين لم يعرفا أمهما قبل أن يأكل التوتر والمرارة ضحكتها، لم يعرفا تلك المرأة الحنون التي كانتها ذات يوم.. وكانت تبكي نفسها أيضاً، تبكي نفسها أكثر من أي شيء آخر.
تنبش شامسي في صور الهوية، والتراكم الذي يصوغها ويدخل عليها تحوّلات مرحلية تخرجها من إطار لآخر، وتتساءل كيف أن بطلتها نجت من طفولتها المحاصرة بصورة الإرهابي الغائب وإرثه الثقيل، وأنه لم يكن إحساسها بأنها شيء يجب أن ينجو المرء منه، إلى أن ماتت أمها، بحيث صاغ الموت صورة جديدة للهوية، وأوحى لها أنه يمكن الالتفاف حول كل شيء ومواصلة الحياة إلا الموت، لأن الموت شيء يتعين على المرء أن يعيش حياته من خلاله.
ولعلّ النقطة الأبرز في تفكيك شفرات الهوية، أو ملامحها باعتبارها خارطة شبيهة بالخارطة الجينية، إلّا أنّها في عالم الفكر والأدب، خارطة مهندسة اعتماداً على عوامل داخلية وخارجية متقاطعة معاً، تمضي بها إلى وجهتها التي تبدو بدورها مرحلية، على اعتبار أن التحوّلات التي تطرأ عليها في كل محطّة حياتية، زمانية أو مكانية، لا تتوقّف عند نقطة بعينها، وتظلّ دائرة في فلك التغيير مخلّفة إرثها وثقافتها وحساسيتها المتوافقة مع المحطة التي تصل إليها في سيرورتها.
عن صحيفة العرب اللندنية