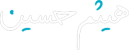“الأم” قصة حب تتحوّل إلى خطيئة
هيثم حسين
تعتبر غراتسيا ديليدا من أهم الأدباء الإيطاليين على مر التاريخ، حيث كانت ثاني امرأة في العالم تنال جائزة نوبل للآداب، وقدمت على مدى تجربتها الأدبية قرابة خمسين رواية ومجموعة قصصية، لكن القارئ العربي يجهل الكثير من أعمال الكاتبة على غرار روايتها الشهيرة “الأم” التي كشفت فيها وجها خفيا من المجتمع المتدين.
تعد رواية “الأم” للإيطالية غراتسيا ديليدا (1871 – 1936) الحائزة على جائزة نوبل للآداب سنة 1926، بمثابة فاتحة لتيار روائي مختلف وجديد في الرواية الإيطالية، حيث أن ديليدا التي كانت ثاني امرأة تحصل على جائزة نوبل، وصفت أعمالها بأنها تمثل حجر الأساس في بناء تاريخ الأدب، وإعادة نشر أعمالها يشهد بالاهتمام المتزايد بإنتاجها.
ترتبط رواية “الأم”، الصادرة في دمشق عن منشورات التكوين بترجمة نبيل رضا المهايني، كغيرها من أعمال ديليدا ارتباطاً وثيقاً بموطنها الأصلي؛ جزيرة سردينيا، وأوجدت تشابها كبيرا بين أماكن الجزيرة وطبيعتها، ونفسية الكثير من الشخصيات في الرواية.
المشتهى والممنوع
تختار ديليدا شخصية ماريا مادالينا لتكون بطلة روايتها، وهي أم باولو خوري كنيسة بلدة متخيّلة على جبال جزيرة سردينيا تسميها آأر. وتحكي قصة حب جامحة بين الخوري وفتاة اسمها آنييزِه التي تعيش وحيدة في البلدة، وتتسبب علاقة الحب بمعاناة شديدة للأم حين اكتشافها لها، ويعيش الخوري كذلك صراعاً محتدماً وقلقاً لا يهدأ جراء الخطيئة التي يقترفها، ويحاول ترك حبيبته التي تتشبث به بعنف، وترفض تركه لها، وتهدد بفضحه أمام المصلين في الكنيسة التي يقيم فيها القداس، لكنها لا تنفذ تهديدها، في حين أن هموم ذاك الحب وتأثيراته المتخيلة تصيب الأم في مقتل.

تصور ديليدا واقع التدين في البلدة المتخيلة، والصراع في النفس البشرية، بين المشتهى والممنوع، المرغوب فيه بشدة والمحرم بأوامر دينية، بين الإخلاص للنفس وعيش المشاعر الحقيقية الصادقة الإنسانية، أو الإخلاص للقسم الذي تمت تأديته تحت ضغوط سابقة، سواء اجتماعية أو أسرية أو مؤسساتية، للكنيسة التي تحرم ذاك النوع من الحب بالنسبة لخوري يفترض أنه رهن حياته لخدمتها.
تلفت إلى تأثير الإشاعة المدمر حين تتسرب إلى أرواح أبناء البلدة بعد أن تستقر في آذانهم، وتستوطن كيانهم وتقوم بتحريكهم كأنهم دمى خاضعة لقوتها وتأثيرها، كالإشاعة التي ادعت أن اللعنة قد حلت على كنيسة البلدة، وأن القس القديم تاه عن الصراط المستقيم بعد أن أغرته ملذات الدنيا، ويكون القس الجديد باولو مثالاً مفترضاً للخلاص والتجديد، لكن الأم مادالينا تعرف المخبوء وتعاني جراء خطاياه التي تتسبب بقتلها قهراً.
تشير ديليدا إلى أن الهروب لا يجدي في الكثير من الأحيان، وأن على المرء مواجهة واقعه بكل ما فيه من مآس ومعاناة، وألا يتعامى عنه بالهروب إلى الأمام، على أمل أن تتبدد غيوم المآسي التي تغرقه وتحاصره من تلقاء نفسها، وأن المواجهة فعل بطولي رغم ما قد يترتب عليه من نتائج مؤلمة، لكنها تكون أقلّ إيلاماً وإيذاء من الهروب والتعامي.
وتحتل فكرة الهروب خيال الشخصيات الهاربة من نفسها، ومن محنتها التي تضغط عليها، مثلاً الأم تهرب من البلدة، باولو يفكر بالهرب من الكنيسة، وآنييزه تفكر بالهرب بدورها من عالمها القاهر، ناهيك عن الفكرة التي تتناهب أبناء البلدة، والتفكير بأن الهرب قد يحمل علامات أو بوادر خلاص مأمول.
تصور الروائية القلق الذي يجتاح شخصياتها، فالأم التي تعمل خادمة للكنيسة، وتجاهد لتؤمّن لابنها مستقبلاً يليق به، ومكانة معتبرة أسمى من مكانتها، تحرص على تربيته وتقديمه للكنيسة كي يصبح قساً محترماً مخلصاً لها، ويحظى بالمكانة التي تريدها له في السلم الاجتماعي، وتخطط لسعادته في تلك المكانة، من دون أن يخطر لها أنه قد يحتاج لعوامل أخرى، أو يختار لنفسه درباً مختلفاً نحو السعادة المتخيلة التي يرنو إليها.
شقاء وسعادة

تعيش الأم شقاءها المطلق بعد اكتشافها حقيقة الخطيئة التي يغوص فيها ابنها، وكيف ينعكس الإثم على كل تفصيل من تفاصيل حياتها وحياته، تتخيل أن الحب الذي يلهب قلب ابنها وروحه يستبب بخراب الكنيسة، ويسبب لها فاجعة شخصية، يزيد من قلقها، ويخيّب أملها بالمكانة السامية المنشودة لابنها باولو، في الوقت الذي لا تستطيع التفكير فيه بأي شيء خارج قيود الكنيسة الضاغطة، أو الإيمان المتخيل بالنسبة لها.
والقلق الذي تعيشه الأم وتعانيه صورة مختلفة عن القلق الذي يدمر حياة باولو ويكاد يفقده رشده، ويجد نفسه منقسماً بين ذاتين وعالمين، فهو الإنسان الساعي لعيش إنسانيته بكل المشاعر والأحاسيس، ويدله الحب على طريق السعادة، لكنه يكون مقيداً بواقع كونه قساً ينتظر منه أن يؤدي واجباته الدينية ويقمع نوازعه الشخصية، ويكون ملاذاً للآخرين الخطائين يسمع اعترافاتهم ويمنحهم بعض السكينة والطمأنينة.
تثير ديليدا أسئلة عن إمكانية منح شخصية قلقة الطمأنينة ومشاعر الأمان للآخرين، وكيف أن المشاعر قد تكون متغيرة من شخص لآخر، بحيث يكون الإيمان عامياً من جهة، ومخلصاً من جهة أخرى، ناهيك عن تلك الرغبة الجارفة بالبحث عن الخلاص والأمان ولو من باب الإيحاء به، أو اختلاقه في مرحلة ما لتضمن مقومات استمرارية العيش وسط ركام مآسي الواقع.
تمثل آنييزه رمزاً للإغواء، وهي تدل على تلك القوة التي تثيرها الشهوة الحارقة لإطفائها بالوصال، وتخطي قيود الأوامر الكنسية، وكيف أن الصراع في النفس البشرية يكون أكثر شراسة من الصراع الظاهري، حيث الصراع الخفي يقود المرء في حياته، ويرسمه بالصيغة التي يظهر عليها، أو تلك التي يشعر بها في داخله، وتتمرأى على أرض الواقع بصور مختلفة، قد تصل لدرجة تدمر معها أبطالها أو أولئك الذي تسكنهم وتحركهم بخيوطها اللامرئية.
بالإضافة إلى القلق المثير تنقل الروائية قلقاً من نوع مختلف، قلق الابن والأم، والبنوة والأمومة في مرحلة مختلفة من التعاطي، حيث الأم خادمة الكنيسة والابن كاهنها وسيدها، ويسعى كل منهما إلى تخليص الآخر مما يثقل عليه ويُكئبه بطريقة ما، لكن تلك المحاولات تبقى في سياق المساعي لتبرئة الأرواح مما يغرّبها عن ذاتها وعالمها الخاص بها، من دون أن يحقق كل منهما مراده بالمطلق.
تؤكد ديليدا على صمود الأم في وجه المحنة التي تكاد تدمر ابنها، وتسعى عبر قوة الأمومة للدفاع عنه، وكأنها تخوض حرباً ضد أعداء متخيلين يخططون للفتك بحياة ابنها، تصلي بطريقتها لإنقاذه من خطاياه، وانتشاله من حبه الذي قد يجعله منبوذاً ومطروداً من الكنيسة التي تظل وفية لها.
وتؤكد كذلك على أن الأم تحافظ على قوتها من أجل ابنها، وتكون أمومتها حصناً لها ولابنها الذي يستدل إلى طريق العودة إلى رشده المفترض بدوره، من دون أن يتخلى عن مشاعره التي ساعدته على تفهم الآخرين أكثر، وتقبل اعترافاتهم بمزيد من القدرة على الغوص في خبايا نفوسهم المضطربة الباحثة عن درب لنشدان الأمان والطمأنينة.
وجدير بالذكر أن رواية “الأم” لديليدا تختلف عن “الأم” الشهيرة للروسي مكسيم غورغي (1868 – 1936)، – تصادف رحيل ديليدا وغورغي في العام نفسه – وتأتي في سياق تصور مختلف، وتقديم صورة أخرى مختلفة للأم، وتتقاطع معها في تلك القوة الجبارة التي تسكن روح الأم وتقودها لتبني قضية ابنها والصمود من أجله وأجلها.
ويشار إلى أنه جاء في سياق تقديم جائزة نوبل لديليدا “نجد في روايات ديليدا أكثر مما نجد في غيرها وحدة فريدة بين الإنسان والطبيعة، حتى أنه قد يمكن للمرء أن يقول إن البشر في رواياتها هم نوع نباتي ينمو في تراب جزيرة سردينيا. أكثر أبطالها هم فلاحون بسطاء بدائيو المشاعر والأفكار، لكنهم يتحلون بشيء كثير من عظمة بناء الطبيعة في سردينيا. بل إن بعضهم يضاهي في الضخامة عمالقة بعض شخصيات العهد القديم”.