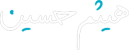آذر نفيسي: لي جنسية ثانية كمواطنة من جمهورية الخيال
آذر نفيسي – ترجمةهشام فهمي
نَص المحاضرة التي كان مزمعًا أن تلقيها الكاتبة الإيرانية آذر نفيسي في مركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت في 10 فبراير/شباط 2020.
جمهورية الخيال
مِن أفضل ما في الكُتب الروابط التي تصنعها. عند الكُتاب، الكُتب بمثابة أطفالنا، نُعاني كثيرًا جدًّا في مخاضها، ونمر بالكثير جدًّا من الترقب والألم والاضطراب والأمل والحُب، وما إن تَخرُج إلى العالم تُذهِلنا بالأماكن السحرية التي تأخذنا إليها والأناس الرائعين الذين تُقدمهم إلينا. عن طريق الكُتب ارتبطتُ بكم، وبالكويت، وبمكتبة تكوين الرائعة، وبهذه المؤسسة الثقافية العظيمة التي يُعد مبناها نفسه عملًا فنيًّا واحتفاءً بالخيال، بما يطيب لي أن أسميه «جمهورية الخيال».
هذا هو سحر الكُتب، التي تُقرأ أولًا وأخيرًا بدافع البهجة الحسية الخالصة المتمثلة في القراءة والاكتشاف، وفي المغامرات غير المتوقعة في بقاعٍ مجهولة، وفي إشباع فضولنا ومنحنا هدية التقمص العاطفي الفعلي. تبث فينا القراءة نوعًا فريدًا من السرور، ألا وهو أن نحتفظ بالخصوصية وفي الآن نفسه نكون جزءًا من تجربةٍ جماعية. من خلال الكُتب، يُمكنك دون أن تُغادِر غُرفتك أن تلتقي العديد من مختلِف الناس وترتبط بملايين من القراء الآخَرين لم تُقابِلهم قَط وقد لا تُقابِلهم أبدًا. لهذا السبب أدعو القراء بالغُرباء الحميمين. قد يكون بعضهم غريبًا عن بعض، لكنهم يشتركون جميعًا في الشغف نفسه بالقراءة واكتشاف الأماكن الجديدة والناس الجُدد. ما يربط الكُتاب بقرائهم هو حقيقة أنهم -وراء ما ندعوه بالواقع- يشتركون في ما يُعرفه ڤلاديمير نابوكوڤ بأنه «إحساس بأن يكون المرء مرتبطًا بشكلٍ ما في مكانٍ ما بأطوارٍ أخرى من الوجود يكون فيها الفن (الفضول، العطف، الرأفة، النشوة) هو الوضع الطبيعي». على غرار بلاد عجائب آليس، يُمكننا أن ندعو ما وصفَه نابوكوڤ «بشكلٍ ما في مكانٍ ما» بجمهورية الخيال، ذلك العالم الآخر الذي يمضي بالتوازي مع عالم الواقع. مفتاح هذا العالم هو الفضول، الرغبة الغامرة في المعرفة، الحافز المتعذر تعريفه على ترك العالم العادي، العالم الثابت الملموس الذي تُشعِرنا فيه بالأمان والطمأنينة أحكام العادة والتوقعات الجاهزة. لسنا نَكتُب ونقرأ لأننا نعرف بالفعل، وليس في سبيل أن نُرسخ عاداتنا وتوقعاتنا، وإنما لأننا نبحث عما لا نعرفه، عما هو -لدرجةٍ خطرة- جديد لا يُمكن التنبؤ به.
الفضول هو المفتاح لفهمٍ حقيقي للمجهول في أنفسنا وفي الآخرين، وكثيرًا ما يقودنا إلى الاستيعاب والتعاطف، إلى ما نسميه التقمص العاطفي الذي يستهوي القلوب صانعًا شعورًا فريدًا بالعطف والرأفة نحو الغير. كما يقول الثعلب الحكيم للأمير الصغير: «المرء لا يرى بوضوحٍ إلا بقلبه. أي شيءٍ جوهري يخفى عن العينين». كان الثعلب من بنات أفكار الكاتب الفرنسي أنطوان دو سان الذي عاش في القرن العشرين، لكن الأدب أبدي، وما يقوله دو سان مشابه للغاية لأبياتٍ من قصيدةٍ كتبها الشاعر الفارسي العظيم جلال الدين الرومي، الذي عاشَ قبله بعدة قرون. كتبَ الرومي: «كل شخصٍ يرى المجهول على قدر نقاء قلبه». لا قدر من الوعظ الأخلاقي أو الصوابية السياسية من شأنه أن يحل محل إحساس التقمص العاطفي الذي يمدنا به الخيال من خلال وضعنا في تجارب الآخرين وفتح أعيننا على مجالاتٍ ومناظر لم نكن نعلم بوجودها على الإطلاق. تَحضُرني شخصية آتيكوس في «أن تَقتُل عصفورًا محاكيًا» لهارپر لي، والتي تقول: «ليس بإمكانك أن تفهم شخصًا حقًّا حتى ترى الأمور من وجهة نظره… حتى تتلبس جِلده وتمشي به». عملية إزالة التعود هذه، واكتشاف السحر في الأشياء العادية، هي ما وصفَه تولستوي بنفض غبار المعتاد والنظر إلى العالم «بعينين صافيتين مغسولتين»، وتُقدم لنا العالم بصورةٍ جديدة وتثير فينا إحساسًا بالنشوة تستطيع الأعمال الخيالية العظيمة وحدها أن تمدنا به. بهذا الشكل يصبح البحث الأصيل عن المعرفة جُزافيًّا خطرًا، يستفز إحساسنا بالتمرد والرغبة المحمومة في هدم جميع الثوابت وتحويل جميع المؤكدات إلى علامات استفهام، تذكرةً بتأكيد نابوكوڤ أن «الفضول هو العصيان في أنقى صوره».
المكتبات ومحال الكُتب من بين أكثر الأماكن ديمقراطيةً على الإطلاق. تَدخُل محل كُتبٍ أو مكتبةً وعلى الأرفُف جنبًا إلى جنبٍ ترى كُتبًا مصفوفةً من جميع أنحاء العالم، بما فيها كُتب من بلادٍ بعضها في حالة حربٍ مع بعض. لكن على تلك الأرفُف ليس هناك أعداء، الجميع أصدقاء، والجميع يعيشون في وحدة. على تلك الأرفُف ليس هناك تمييز. بناء الرواية ذاته ديمقراطي، فالروائي العظيم لا يفرض تحيزاته على قصته، بل يُعطي أصواتًا لجميع الشخصيات، بمن فيها الأشرار، فالرواية ليست قائمةً على الأحكام والانحياز وإنما على الاستيعاب والتقمص العاطفي. كقائد الجيش العظيم، يُدرِك الروائي العظيم أن عليه أن يعرف ويفهم عدوه نفسه في سبيل أن يهزمه.
وهكذا أحتفلُ الليلة بوجودي في بلدكم وفي هذا المكان الرائع الذي حاولتُ أن أزوره في خيالي قبل أن أزوره في الواقع، وسط شعبٍ لا أتحدثُ لغته إلا أنني أشتركُ معه في لغةٍ عالمية تتحدى جميع الحدود الجغرافية، هي الاحتفاء بالكُتب. قبل أن أصبح كاتبةً كنتُ قارئةً، ولذا أتحدثُ إليكم باعتباري كاتبةً وقارئةً في آنٍ واحد، وأحب أن أحتفل معكم، ليس فقط بفعل الكتابة والكُتاب، بل أيضًا بفعل القراءة والقراء.

أود أن أروي قصةً قائمةً على تجربتي الشخصية في العالمين اللذين نُعرفهما بالواقعي والخيالي، وآملُ بقصتي هذه أن أتطرق إلى الطرائق التي يتفاعل بها الواقع مع الخيال فيما يُقوض كلاهما الآخر ويُحوله ويُشكله. آملُ أن أُظهر كيف يُكون الخيال الصلات بين الثقافات والحقائق المختلفة، بسُبلٍ تصنع رابطًا بين مدينتَي طهران وواشنطن بمدينتكم الكويت.
تبدأ القصة التي أريدُ أن أحكيها لكم في غُرفةٍ صغيرة في طهران حين كنتُ طفلةً. أذكرُ في كُتبي أن الشيئين الوحيدين اللذين أصرت عليهما عائلتي هما التعليم والمعرفة. منذ نعومة أظفاري أنا وأخي تعود أبي أن يقول لنا ألا نعتمد على الممتلكات، مضيفًا أن المملتاكات الدنيوية لا يمكن الاعتماد عليها، وأن فقدان المرء إياها أسهل من حصوله عليها. كان يقول إن هناك شيئًا واحدًا لا يفقده المرء أبدًا، ألا وهو المعرفة، ومتى أراد أن يُشجعنا أو يُكافِئنا كان يبتاع لنا كُتبًا، وتعلمنا نحن منذ طفولتنا المبكرة أن نعد الكُتب هدايا ومكافآت علينا أن نعتز بها ونعتني.
مؤكد أنني كنتُ صغيرةً للغاية عندما كان أبي يقرأ أو يحكي لي قصةً كل ليلة. كان ديمقراطيًّا في حكايته القصص، ففي ليلةٍ أزورُ أراضي السحر التي اختلقَتها شهرزاد في «ألف ليلة وليلة» أو القصص الأسطورية للفردوسي شاعرنا الملحمي العظيم في «الشاهنامه/كتاب الملوك»، وفي الليلة التالية أسافرُ إلى فرنسا مع «الأمير الصغير»، أو إلى بريطانيا مع «آليس في بلاد العجائب»، أو إلى أمريكا مع «ساحر أوز»، أو إلى الدنمارك مع «فرخ البط القبيح»، وما إلى ذلك. هكذا أدركتُ في تلك السن الحديثة أنني أستطيعُ البقاء في غُرفتي الصغيرة في طهران وسيأتيني العالم كله. قبل أن أرى تلك البلاد في الواقع كنتُ قد زرتها بالفعل في خيالي.

مؤكد أنني كنتُ في السادسة أو السابعة تقريبًا عندما أخذَني أبي ذات صباحٍ في تمشيةٍ طويلة انتهَت عند محل الآيس كريم المفضل عندي. خلال تمشيتنا أخبرَني بأنني كبيرة بما فيه الكفاية الآن لأن أعرف القليل عن عائلتنا وأصولها، وقال إننا نستطيع أن نتتبع نسبنا إلى طبيبٍ ومفكرٍ حاذق هو برهان الدين نفيس، الذي عاش في القرن الخامس عشر وألف كُتبًا مهمةً لا تزال موجودةً حتى اليوم. قال إن منذ ذلك الحين ولأجيال عُرف رجال عائلة نفيس -ولاحقًا نساؤها- بعملهم في الطب أو في الأدب، وأحيانًا في الاثنين. بالنسبة إليهم، وكذا بالنسبة إلى أبي، كان العلم والأدب فرعين لشجرةٍ واحدة. بعدها حكى لي قصصًا عن عمر الخيام الذي برعَ في علم الفلك والفلسفة والرياضيات وكان شاعرًا عظيمًا، وعن الفارابي الذي كان فيلسوفًا عظيمًا وعالمًا كونيًّا ورياضيًّا وباحثًا في الموسيقى ألف كتابًا عظيمًا عنها.
بعد ذلك بفترةٍ طويلة عدتُ إلى هذه الفكرة مدركةً أن العلوم والآداب والفنون تُنمى وتُطور عن طريق الخيال، وكم هي ضرورية لبقائنا كجنسٍ بشري. العلم والأدب كلاهما يعتمد على الفضول والتقمص العاطفي. يستجلي العلماء المجهول في الطبيعة، ومن خلال هذا يتمكنون من جعل العالم مكانًا صالحًا للمعيشة، ومن يشتغلون في الأدب والموسيقى والفنون يستجلون الروح، الطبيعة الروحانية للبشر، فيربطون بعضنا ببعض، وكيف لنا كبشرٍ أن نبقى دون روابط بيننا ودون أن نبني مجتمعاتٍ بينها اهتمامات مشتركة؟ يُذكرني بهذا بأحد أعظم العلماء في التاريخ، آينشتاين الذي أحب الموسيقى وكان موسيقيًّا أيضًا. آينشتاين هو من قال عن المعرفة العلمية والخيال: «الخيال أهم من المعرفة، فالمعرفة محدودة، أما الخيال فيُطوق العالم، يحث على التقدم ويتمخض عن التطور».
ظلت معي القصص التي حكاها لي أبي عن مفكري وعلماء وشُعراء تلك الأزمنة البعيدة، والآن أفكرُ أنهم لم يروا العلاقة الوطيدة بين العلم وأعمال الخيال فحسب، بل كانوا أيضًا يعون أكثر منا اليوم أهمية تبادل الأفكار وثمار الخيال والتعلم من الغير. إننا نحيا في عصرٍ جعلت فيه التكنولوجيا تكوين الروابط العالمية أسهل كثيرًا، لكن التكنولوجيا لا تكفي للربط بين الشعوب والثقافات ربطًا حقًّا. في بعض الأحيان نخلط بين المعلومات والمعرفة، وننسى أن المعرفة -أكثر من التكنولوجيا- تحتاج إلى الشغف والإخلاص والحُب. دعونا فقط نلقي نظرةً على ما يُسمى عصر الإسلام الذهبي وتبادل المعارف المذهل بين الباحثين الشرقيين والغربيين. من نواحٍ شتى كان تبادل المعارف أعمق بكثيرٍ من اليوم. من ناحية التبادل الثقافي فإن هناك أشياء كثيرة علينا أن نتعلمها من أسلافنا المفكرين والروحانيين في جميع أنحاء العالم. لنفكر في ابن سينا الذي لُقبَ بـ«أبي الطب الحديث» ووُصِفَ بكونه «الفيلسوف الأكثر تأثيرًا في عصور ما قبل الحداثة». تأثر ابن سينا بفلسفة أرسطو وبدوره أثر في فلاسفة التنوير في الغرب. الفارابي، الفيلسوف والعالم والباحث الموسيقي العظيم، تأثر بأفلاطون وأرسطو وبطليموس، ولُقبَ بـ«المعلم الثاني» تيمنًا بأرسطو الذي كان «المعلم الأول»، وإحدى أهم خدماته للفلسفة حفاظه على النصوص اليونانية الأصلية بسبب تعليقاته وأطروحاته. الكندي، «أبو الفلسفة العربية»، والذي كان طبيبًا وموسيقيًّا أيضًا، تأثر بسقراط والفلسفة الهلينستية. في الغرب لم يكن الفلاسفة المسلمون مشهورين فحسب، بل كان لهم أيضًا عظيم التأثير على مفكري وكُتاب وشُعراء الغرب. ترك أدب الشرق علامته على الثقافة الغربية. فكروا في انتشار ترجمات إدوارد فيتزجيرالد لعمر الخيام، وفي «الديوان الغربي الشرقي» لجوته الذي استلهمَ فيه حافظ الشيرازي، وبالطبع كيف ننسى عشق العالم كله لشهرزاد؟

أود أن آخذكم من غُرفتي الصغيرة إلى مطار طهران، حين أُرسلتُ في سن الثالثة عشرة إلى إنجلترا لأتابع تعليمي. معظم الأصدقاء والأهل الذين كانوا حاضرين يومها يَذكُرون أنني كنتُ الطفلة المدللة، أني رحتُ أجري في أنحاء مطار طهران وأصيحُ أنني لا أريدُ أن أرحل. كانت تلك أول مرةٍ أعرفُ مذاق المنفى. في تلك السن اكتشفتُ كم هو سهل أن تفقد كل ما تعده وطنك، كم هو سهل أن تُعزَل فجأةً عن كل ما تحب، عن كل شيءٍ جعلك أنت ومنحك اسمًا وهُويةً ولغةً. كان هذا أول درسٍ ملموس لُقنتُ إياه في تقلب الحياة ومراوغتها. من اللحظة التي أمسكوا بي فيها أخيرًا ووضعوني على متن الطائرة وأُغلقت علي الأبواب صارَت فكرة العودة، فكرة الوطن، فكرة إيران، هوسًا صبغَ جميع ساعات يقظتي تقريبًا، علاوةً على أحلامي. ولكم كانت لانكستر الإنجليزية مختلفةً عن طهران الإيرانية. كانت طهران مشمسةً حتى في الشتاء، عندما يَسقُط الثلج ونستمتع بالمشي في الثلج وأكل الكعكات المحشوة بالكِريمة. أما لانكستر فكانت غائمةً طوال الوقت تقريبًا والمطر يَسقُط أكثر الوقت. كانت طهران محاطةً بالجبال، أما لانكستر فمسطحة. افتقدتُ أبوَي وأقاربي وأصدقائي، وافتقدتُ اللغة، وافتقدتُ الشمس، ورائحة ومذاق الخوخ والطماطم المغموريْن بضوء الشمس. الوسيلة الوحيدة التي استطعتُ بها استعادة طهراني المفقودة المراوغة كانت من خلال ذكرياتي وبعض كُتب الشعر التي جلبتها معي من الوطن. طيلة ليالي الوحشة في بلدةٍ صغيرة رطبة غائمة بإنجلترا اسمها لانكستر اعتدتُ الدخول تحت أغطية الفِراش ومعي قربة من الماء الساخن تُدفئني، وعشوائيًّا أفتحُ ثلاثة كُتبٍ تركتها إلى جوار فِراشي؛ اثنين منهما لشاعريْنا الكلاسيكييْن العظيميْن حافظ والرومي، وواحد لشاعرةٍ فارسية هي فروغ فرخزاد. تعودتُ قراءة تلك الكُتب حتى ساعةٍ متأخرة من الليل (وهي العادة التي لم أتخل عنها حتى الآن)، والغياب في النوم فيما تلف الكلمات نفسها حولي كعطورٍ من محل توابل قديم، باعثةً طهراني المفقودة المنسية.
لم أكن أدري وقتها أنني أصنعُ وطنًا جديدًا، وطنًا متنقلًا لا يملك أحد قوة أن يأخذه مني. تعلمتُ أنني أستطيعُ أن آخذ معي أفضل ما يُقدمه بلد ميلادي إلى أي مكانٍ في العالم أذهبُ إليه. اكتشفتُ أيضًا أن من خلال الكُتب، من خلال الفنون والموسيقى والثقافة، يمكنني أن أجد وطنًا في أي بقعةٍ من العالم تقريبًا. قبل ذهابي إلى إنجلترا وأمريكا كنتُ قد زرتهما في خيالي بالفعل، غالبًا عن طريق الكُتب التي قرأتها، من قصص الطفولة إلى قصص البالغين. ومرةً أخرى تعودتُ وقبلتُ وطني الجديد في إنجلترا وبعده في أمريكا من خلال الجانب الخيالي لإنجلترا وأمريكا وقراءة وزيارة تشارلز ديكنز وجاين أوستن والأخوات برونتي ومارك توين وإرنست همنجواي وإميلي ديكنسن وجيمس بولدوين، وبالطبع شيكسپير الذي التقيته في أول أيام الدراسة. أول كتابٍ قرأته لشيكسپير كان «جعجعة بلا طحن»، وما زلتُ أشعرُ بالرعشة تسري على عمودي الفقري من كلماته. بعد عقودٍ زارتني الرعشة نفسها حين كانت في السن نفسها تقريبًا التي كنتُ فيها وقت أن أُرسِلتُ إلى إنجلترا. كانت في عامها الثاني من المنفى في أمريكا، وعادت إلى المنزل شاعرةً بحماسةٍ جعلَتها تتكلم كأنها تصيح. قالت: «أمي، اسمعي هذه الكلمات»، وقرأت سطرًا مبهمًا من «روميو وجولييت» عن روزاليند: «من الظلم أن تستحق النعيم، لفرط العفاف وفرط الجمال، ويأسي يُدحرجني في الجحيم». وفي آنٍ واحد تقريبًا جالَ ببالي خاطران: أن من فرط العفاف وفرط الجمال كان منطقيًّا أن تُنسى روزاليند وتبقى جولييت التي خاطرت بجنون الحُب خالدةً. الخاطر الثاني كان حمدًا لله أن ابنتي ستكون بخير، فقد وجدت وطنها الجديد في هذه الأرض الجديدة.

عدتُ إلى إيران في عام الثورة، وهو العام نفسه الذي تخرجتُ فيه في الجامعة وحصلتُ على درجتي. في تلك الفترة، لأني وتلميذاتي كنا محرومات من الارتباط ببقاعٍ عديدة في العالم الخارجي، فقد ارتبطنا بها من خلال سُفرائها الذهبيين، كُتابها وشُعرائها وموسيقييها وفنانيها وسينمائييها.
في إيران اكتشفتُ أيضًا أن ما لا أستطيعُ أن أقوله بوضوحٍ عن الواقع يمكنني أن أقوله بالرمز من خلال الأدب. ناشقتُ حرية الاختيار عن طريق روايات جاين أوستن، وأهمية التقمص العاطفي ودوره في القضاء على الانحياز عن طريق تكليف تلميذاتي بقراءة «مغامرات هكلبري فين» لمارك توين، ومعنى الظلم والقهر عن طريق «خريف البطريرك» لجابرييل جارثيا ماركيز، وأهمية الكُتب في بناء مجتمعٍ حُر في «451 فهرنهايت» لراي برادبري. لم أنسَ قَط تذكِرة برادبري بأنه «ليس ضروريًا أن تُحرِق الكُتب لتُدمر ثقافةً ما، فما عليك إلا أن تجعل الناس يُحجِمون عن قراءتها». في فصولي ناقشنا أن القصص العظيمة، من «الحرب والسلام» لتولستوي إلى «التحول» لكافكا إلى «الكبرياء والتحامل» لأوستن إلى «لمن يدق الجرس» لهمنجواي، أن تلك القصص العظيمة في قلبها جميعًا عن الحرية.
حين هاجرتُ إلى أمريكا أدركتُ أن بخلاف جنسيتي الرسمية لي جنسيةً ثانيةً كمواطنةٍ من جمهورية الخيال، ذلك المجتمع العظيم من القراء الذين لا يحتاجون إلى جوازات سفرٍ ليُحلقوا ويَعبُرون الحدود ويتحدثون لغةً مشتركةً. على مر السنين استوعبتُ أنه لا يهم أين نعيش وتحت أي نظام، فثمة غرائز واحتياجات إنسانية معينة لها طابع عالمي. لأننا بشر فنحن نحتاج إلى أن نحكي القصص ونقرأها، قصصنا وقصص الآخرين، ونحتاج باستمرارٍ إلى أن نقلب الطريقة التي نُبصِر بها العالم وأن نكون مستعدين لتغيير أنفسنا وبيئتنا.
نحتاج إلى حكاية قصصنا وقراءة قصص الآخرين كي نسرد ما حدثَ لنا ولغيرنا، في سبيل إنقاذ أنفسنا من تقلبات الحياة وحقيقة الموت المطلقة، فالأدب والفن حارسا الذاكرة، وهما دليل -دليل دامغ- على أننا عشنا، أننا وُجِدنا على هذه الأرض، وهما أقرب شيءٍ إلى الخلود بإمكاننا بلوغه. كما كتب الكاتب تزڤيتان تودوروڤ: «وحده النسيان التام يستدعي اليأس التام». النسيان هو الموت، والخيال يتعامل دومًا مع الحياة، مقاومًا يأس الموت ويحتفي باكتمال الحياة.
وهو ما يعيدني إلى تلك الغُرفة الصغيرة في طهران والمرة الأولى التي سمعتُ فيها اسم شهرزاد. على الرغم من أن شهرزاد وقصتها معي منذ زمنٍ طويل لدرجة أنني لم أعد أستطيع استعادة متى سمعتها أول مرة، فيبدو لي أنني عرفتها بالفعل قبل أن أسمعهان ويبدو أنها كانت جزءًا من ذاكرتي طوال الوقت. لبعض القصص هذا الأثر على المرء.
ليس هناك راوٍ واحد يمكننا أن نقول إنه راوي «الليالي»، فهناك رواة مجهولون كثيرون. رغم أن قصص «ألف ليلة وليلة» موائمة بشكلٍ عام لحياة المجتمعات العربية وتقاليدها، ولها أصول هندية وعربية وفارسية، فقد أضاف إليها الأوروپيون حكاياتهم لاحقًا. بالمعنى الحقيقي للكلمة «ألف ليلة وليلة» عمل عالمي ينتمي إلى العالم بأَسره.
من نواحٍ عدة تعد القصة الإطارية لـ«ألف ليلة وليلة» فريدةً وثوريةً في آنٍ واحد. خُذ الشخصيًّة الأنثوية شهرزاد. في أكثر الأساطير والحكايات تُعرف البطلة أساسًا بجمالها، وهو السبب الرئيس الذي يدفع البطل إلى الوقوع في حُبها، لكن من البداية تطيح شهرزاد بالصورة النمطية للبطلة النمطية، فجمالها ليس صفتها المميزة، وما يجعلها جذابةً أنها «قرأت كُتب الأدب والفلسفة والطب، وحفظَت الأشعار عن ظهر قلب، ودرست التقارير التاريخية، وكانت ملمةً بأقوال وأمثال الحُكماء والملوك. كانت ذكيةً ومطلعةً وحكيمةً ومهذبةً، قرأت وتعلمت». كما أنها شُجاعة، ومستعدة للتضحية بحياتها لإنقاذ نساء بلدها. على مدار حكاياتها تساوي بين الخيال وإنقاذ الأنفس، فتحفظ الحياة وتحتفي بها.
سيقول البعض إن هذه مجرد قصة، ففي عالم الواقع لم تُنقِذ القصص حياة أحد! لا قصة مجرد قصةٍ فحسب، فللقصص جذور في عالم الواقع. الحكايات العظيمة عظيمة لأنها تتجاوز المظاهر وتُفصِح عن حقيقة واقعنا، وفي هذا السياق تكون قصة شهرزاد حقيقية جدًّا ومخلصة جدًّا للحياة.

أنا نفسي اختبرتُ الدور الاستثنائي الذي تلعبه القصص في الحياة تحت ظروفٍ قاسية. شهدتُ كيف يفتح الخيال والأفكار وحُب الجمال مجالاتٍ يُغلِقها الواقع في وجوهنا. في عامي الأول من التدريس في جمهورية إيران الإسلامية درستُ في جامعةٍ للفتيات، وكانت عندي طالبة اسمها راضيه أحببتها كثيرًا. بدَت صغيرة الحجم هشةً لكنها تمتعت بذكاءٍ ثاقب وعقلٍ قوي. كان أبوها ميتًا وأمها عاملة نظافة، وكانت راضيه وأمها متدينتين للغاية. كانت راضيه تنتمي إلى جماعة معارضة إسلامية، لكنها لم تكن متعصبةً في أيديولوجيتها قَط، بل كانت مخلصةً لمبادئها وقيمها وتفسيرها لدينها، وكثيرًا ما انتقدَت جماعتها.
ما أذهلني دومًا في راضيه هو استيعابها الجمال. ذات مرةٍ قالت لي: «تعلمين أنني عشتُ طيلة حياتي في فقر. كنتُ مضطرةً إلى سرقة الكُتب والتسلل إلى دور العرض، لكن والله لكم أحببتُ تلك الكُتب! لا أظن أن طفلًا من الأثرياء استمتع قَط بـ«ريبيكا» أو «ذهب مع الريح» مثلي عندما استعرتُ الترجمات من المنازل التي كانت أمي تعمل فيها». لاحقًا وقعَت في غرام الكتابات الروائية العظمى، تولستوي وجاين أوستن وهمنجواي، لكن شغفها الحقيقي كان هنري جيمس وما وصفَته بنسائه ذوات العقول المستقلة لأقصى درجة. أخبرَتني: «جيمس مختلف جدًّا عن أي كاتبٍ آخر قرأتُ له»، وأضافَت ضاحكةً: «أظنني واقعةً في الحُب!».
في ختام العام الدراسي تركتُ الجامعة، وباستثناء لقاءٍ مصادف قصير في الشارع لم أرَ راضيه ثانيةً. بعد سنواتٍ قليلة جاءَت تلميذة لي لم أرها منذ وقتٍ طويل تزورني فجأةً. كانت قد تغيرت من الفتاة الطريفة المفعمة بالحياة التي أذكرها إلى امرأةٍ رزينة خانعة حُبلى في طفلها الثاني. أخبرَتني بأن خلال مظاهرات الطلبة ضد الثورة الثقافية قُبض عليها وحُكم عليها بخمس سنوات لكنهم أطلقوا سراحها بعد عامين ونصف لحسن السير والسلوك، ولم أسألها عن تعريف حسن السير والسلوك عند سجانيها.
قالت: «في السجن التقيتُ واحدةً أخرى من تلميذاتكِ. كنا خمس عشرة سجينةً في تلك الزنزانة. كان اسمها راضيه، وحكَت لي عن تدريسك همنجواي وهنري جيمس وحكيتُ لها عن «جاتسبي العظيم» وكيف حاكَمنا الكتاب في فصلكِ. ضحكنا كثيرًا من هذا»، ثم إنها صمتت لحظةً قبل أن تُردِف: «بعدها بفترةٍ قصيرة أعدموا راضيه».
استغرقتُ وقتًا طويلًا حتى استوعبتُ معنى كلامها. لم ألقِ عليها أسئلةً كثيرةً، فلم أستطِع أن أتخيل، وربما لم أُرد أن أتخيل أن تلك الفتاة السمراء النحيلة ذات العينين القويتين الزاخرتين بالتصميم، أن تلك الفتاة التي كانت عيناها تتألقان متى تكلمت عن هنري جيمس وكاثرين سلوپر بطلة روايته «ساحة واشنطن»، أن تلك الفتاة أُخذت ذات ليلةٍ وأُعدمَت. ظللتُ أتخيلُ راضيه تضحك وتقول «أظنني واقعةً في الحُب!». ليس بإمكاني إلا أن أبقيها حيةً بترديد حكايتها وقصة حُبها لهنري جيمس مرارًا وتكرارًا.
تُذكرني بكتاب تزڤيتان تودوروڤ العظيم «مواجهة المتطرف»، عن الحياة في معسكرات الاعتقال السوڤييتية والفاشية، الأماكن التي كان الموت والعنف يُمارسان فيها بمنتهى التطرف، ويحكي الناجون قصصًا عن أساليب نجاتهم والدور المحوري الذي لعبه الخيال والأفكار والجمال في بقائهم أحياء واحتفاظهم بالأمل، وكيف ربطوا بين جمال الطبيعة وجمال الفن. تقول يوجينا جينزبرج التي قضَت 18 عامًا في الجولاج السوڤييتي: «أحسستُ على نحوٍ غريزي أنه ما دامت مشاعري تتحرك تأثرًا بنسيم البحر وبروعة النجوم والشعر فسأظل حيةً مهما اترجفَت ساقاي أو انحنى ظهري تحت وطأة الحجارة المحترقة». ثم إن هناك كوستليڤ، الجندي الشيوعي الشاب الذي صادفَ في مكتبةٍ «التربية العاطفية» لفلوبير و«آدولف» لكونستانت، وقد شغلَته قراءتهما لدرجة أنه أهمل واجباته وقُبض عليه، لكنه لم يُعرِب عن أي ندمٍ إذ قال: «إذا عرفتُ يومًا، ولو فترةً قصيرةً، ماهية الحرية، فقد كان هذا وأنا أقرأ هذين الكتابين الفرنسيين». وقالت سجينة أخرى من المعسكرات هي إتي هيليسوم: «كل معسكرٍ يحتاج إلى شاعر، إلى شخصٍ يختبر الحياة هناك –حتى هناك- كشاعرٍ ويتمكن من الغناء عنها». كانت الحكاية عن حياتهم في معسكرات الموت تلك من خلال القصص أو الشعر وسيلةً للضحايا لأن يُمسِكوا زمام حياتهم السليبة، أن يحكوا قصصهم من منظورهم الخاص وليس من وجهة نظر من أدانوهم. عن طريق تلك الحكايات ارتبطوا بالعالم وضمنوا ألا يطويهم النسيان، فنعم، صحيح أن النسيان هو الموت.
نعلم أن القصص والأشعار لا تُنقِذ البشر إنقاذًا ماديًّا ولم تُنقِذ سجناء معسكرات الاعتقال من التعذيب والموت، ولم يُنقِذ هنري جيمس تلميذتي راضيه من الإعدام. إذن فما هو الشيء الذي يجعل أناسًا كثيرين يلجأون إلى الأفكار والخيال والجمال حين يُجردون من كل شيءٍ ندعوه بالحياة وحين تُسلَب منهم تمامًا سُلطتهم على حياتهم وموتهم؟ حين يكونون على عتبة الموت؟ لأنه حين يُواجَه المرء بتلك الأفعال المتطرفة من العنف والوحشية، وحين يفقد الأمل في أن يكون إنسانًا، فإنه يلتفت بشكلٍ غريزي إلى إنجازات البشرية التي تُقدر الكرامة والحرية والجمال، يلتفت إلى التقمص العاطفي والإيمان بأنه حتى في هذا المكان القريب جدًّا من الموت يكون قريبًا أيضًا من الحياة من خلال الكُتب والفن والموسيقى، من خلال ما صنعَه الحُب والشغف والرغبة في الارتباط، والتوق إلى مقاومة الموت والنسيان. ولا تقل عن هذا أهميةً حقيقة أن حتى على عتبة الموت، عندما لا يستطيع الإنسان اختيار طريقة حياته أو موته، فإنه لا يزال يملك خيار الطريقة التي يواجه بها الموت، كيف يواجه جلاده بكرامةٍ وحُبٍّ للحياة أو بعدمية الموت. لا يمكننا أن نفقد الأمل في عالمٍ أنجب الرومي أو شيكسپير. هذا هو ما تُقدمه إلينا شهرزاد في النهاية: الأمل في العالم على الرغم من شروره والأمل في البشرية على الرغم من عيوبها.
أريدُ أن أختم قصتي وأحتفي بشهرزاد من خلال حكاء آخَر، حكاء وقارئ عظيم عاش بعد قرونٍ من شهرزاد ونال نصيبه من المعاناة، لكنه سليل حقيقي لشهرزاد ويفهم العلاقة بين الحياة والفن. أتكلمُ عن الكاتب الأمريكي العظيم جيمس بولدوين، الذي قال: «إنك تقرأ شيئًا حسبت أنه حدث لك فقط، لكنك تكتشف أنه حدث قبل مئة عامٍ لدوستويوڤسكي، وهذا عتق عظيم للشخص الذي يُعاني ويُكافح ويحسب دومًا أنه وحيد. لهذا السبب الفن مهم. لو لم تكن الحياة مهمةً لما كان الفن مهمًّا، والحياة مهمة».آذر نفيسي مع أسرة مكتبة تكوين.
عن منصّة تكوين