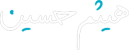إلى ضاحية دمشق ثم إلى قوارب الموت..
حسن داوود
بقي موروي، الضرير، مقيما مع عائلته في بلدته في الشمال السوري حتى منتصف الرواية*. «لم يبق خير في هذه البلدة المنكوبة»، قال مبرّرا رغبته بالانتقال، أو بالهجرة إلى دمشق. لم تكن تنطبق عليه صفات من يستحقّ الشفقة أو الإحسان فهو هناك في بلدته في الشمال السوري، لم يعوزه المكر الذي هو من وسائل التحايل على العيش. وهو ظلّ على حاله هناك في تلك الضاحية من ريف دمشق. وقد أصاب من ذلك ربحا غير قليل من إيواء اللاجئين إلى تلك الناحية. كان قد ساعده على ذلك أبو مأمون الكردي، من حين وصوله مع ابنتيه وزوجته العرجاء «بهو»، التي ربما كانت أكثر مكرا من زوجها موروي. وقد وجدت «بهو» في إعجاب مضيفها أبو مأمون بجميلة، ابنتها البكر، خصوصا بعدما رأت منزله الكبير الذي يشي بأنه ميسور الحال، ما يعزّز مستقبل العائلة كلها.
في دمشق، أو في «المنارة» الواقعة في ضاحيتها، حلّت البحبوبة محلّ الفقر، لكن ليس من دون السقوط في ما تودي إليه إغراءات المدينة. أولى الضحايا هي جميلة، التي صار اسمها جيمي، لكي تواكب ما يتطلّبه عالم الفن والسينما التي أُغريت، أو استُدرجت، للعمل فيه. لكنها، مع اصطباغ شخصيتها بما هي عليه شخصية الضحية، إلا أنها لا بد ورثت شيئا من مكر والديها. فهي رضيت بالزواج من أبو مأمون الكردي، المتزوج أصلا، لكي يمكنها من متابعة دروسها وتعلّم مصلحة «الكوافيرة»، ثم لكي تصل إلى حيث السينما والفن بمساعدة رجل آخر.
تتنقّل جميلة، وهي الشخصية الأولى في الرواية التي تبدأ سطورها الأولى بها، وتنتهي بها سطورها الأخيرة، بين تلك العوالم الثلاثة، من ضيعتها في الشمال السوري، إلى المنارة في ضاحية دمشق، وذلك، حسبما يشير الكاتب، إثر أحداث دامية جرت في 2004 وقع ضحيتها العشرات، وجرى سجن الألوف من أبناء تلك المنطقة ثم، ثالثا، إلى الهجرة خارج سوريا، وربما بواسطة ما اصطلح على تسميته قوارب الموت. هي ثلاثة عوالم كان على تلك العائلة، كما على أعداد لا حصر لها من أهل الشمال السوري، وعلى ساكني سوريا جميعهم من ثمّ، أن تتمكن من التكيف المستمر مع تلك الانتقالات.
هي سيرة عائلية ترسم مصائر أفرادها أحداث سياسية عريضة، مثل انتفاضة 12 آذار/مارس 2004 أو بداية الحرب السورية في 2011. ما بينهما هناك بُنى السلطة وهياكلها سريعة التشكّل في بيئة ما بعد الأحداث الكبرى. في الرواية جُعل «المساعد أول» شخصية أساسية في الرواية التي تابعت تحوّله إثر إزاحته عن منصبه، لتصل به إلى أن يكون حاضرا في التشكل الأخير الذي رسمت به مصائر الشخصيات. كان قد تحول من مخبر إلى حاكم، متقدّما هكذا عمّن يفوقونه رتبة في وظائف الدولة الأمنية. وقد مكّنته من ذلك حنكته التي راح يخطّ سطورها كوصايا في كتاب كان يعدّه لينشر لاحقا. تلك الوصايا، أو التعاليم، تكشف عن معرفة بطرق السيطرة وأساليبها بما يذكّر بتلك التي أسداها مكيافيللي لأميره. من أوراق المساعد أول ذاك، في الرواية: «إن تفكيك شيفرة العناد يكمن في إيهام الشخص بأنه محقّ، وبأنه عنيد بشكل لافت في تشبثه برأيه ومواقفه، وبأن قناعته تلك يستحيل تغييرها وتبديدها، حينذاك تنسف جدار حمايته الأول (…) العناد هو الخنجر الذي ينبغي إبقاؤه مستلا كي يطعن به صاحبه نفسه وأهله في كل مرّة…إلخ».
في الرواية تتواتر هذه التعاليم مخترقة الأحداث التي تتساقط منهالة على الشخصيات، ويستمر تواترها على مساحة واسعة من الصفحات والفصول، كأن من أجل أن تُسلّم الوصايا، ليس للأمير هذه المرّة، بل لرعيّته طالما أن حكمة المساعد أول ذاك مذمومة. ذاك أن تعاليمه هذه تظل مقيمة على سعيها بعد كل تحول كبير، مثل انتقال الحكم من أب إلى ابنه، أو زعم الابن بأنه يحدث ثورة على طاقم الفساد القديم.
هي حياة تُرسم تحولاتها من قدَر أعلى. ما يطرأ على عيش الشخصيات قليل التأثير على مصائرها. فمثلا، لن يهنأ العجوز الضرير بالبحبوحة التي تحقّقت له من عمله في العقارات، ولن تحصّل ابنته جميلة شيئا من طموحها الذي تحقّق لها. فانتقالهما الأول، إلى ضاحية دمشق، عائد إلى قمع 2004، لا إلى رغبة العائلة في العيش المديني، وكذلك هو حالها مع هجرتها الأخيرة، من سوريا كلها، حيث القمع الذي جعل يسابق مجريات الاحتجاج، فنقرأ في الرواية حادثة تظاهرة الأطفال الأولى، تلك التي أشعلت الحرب في إدلب، تحدث هنا، أو يحدث ما يماثلها، في منارة ضاحية دمشق.
لذلك يشعر قارئ الرواية، بأنه جرى تقليص فردية كل من شخصياتها بسبب ثقل تمثيلها لآخرين كثيرين، وهؤلاء هم من يقع عليهم القمع ذاته وتجري حياتهم تبعا لتحولات السياسة. هذا ما لا تتنصل منه الرواية على كل حال، وما يصعب عليها إخفاؤه في ظل سوْق البشر بالجملة ودفعهم جماعات إلى البحث عن ملاذات بديلة للعيش.
«عشبة ضارة في الفردوس»
رواية هيثم حسين صدرت عن «دار ميّارة للنشر والتوزيع» في 220 صفحة، 2017
٭ روائي لبناني
القدس العربي